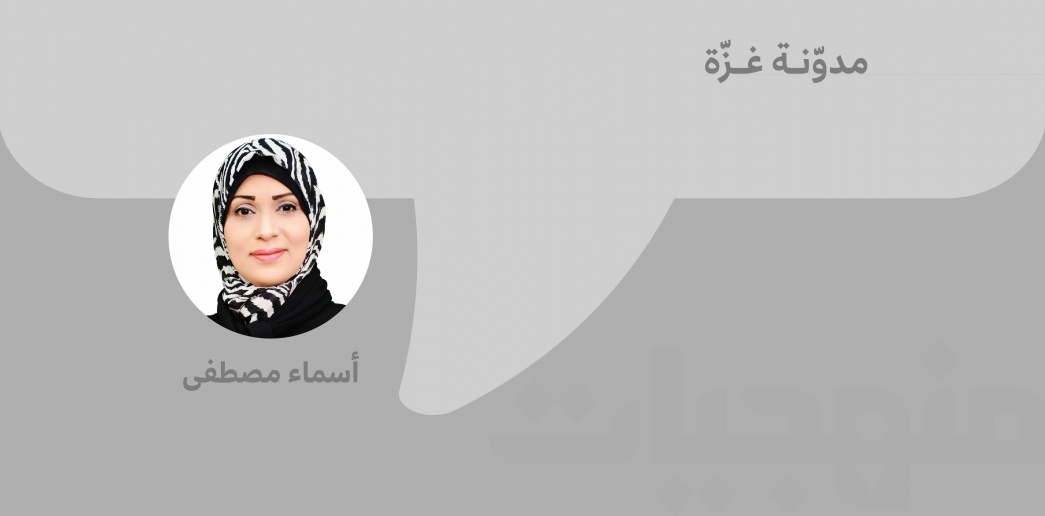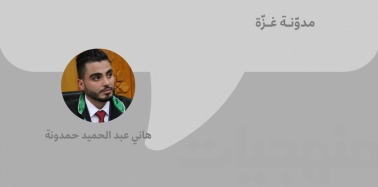أحيانًا نقرأ مقالًا تربويًّا فلا نمرّ عليه مرور الكرام، بل يتوقّف عنده وعينا، كأنّه يطرق بابًا كنّا نخشَى فتحه. هذا ما حدث معي وأنا أقرأ مقال الزميلة ميسون أبو موسى، المعلّمة المبادِرة من غزّة، التي لم تكتفِ بسرد تجربة تعليميّة مختلفة، بل قدّمت موقفًا تربويًّا شجاعًا يعيد تعريف معنى تدريس العلوم في زمنٍ استثنائيّ.
في مقالها خيمة المعرفة الناجية، لا تتعامل ميسون مع مادّة العلوم بوصفها منهجًا جامدًا، ولا مع الخليّة بوصفها وحدة بيولوجيّة معزولة عن الحياة، بل تنقلنا إلى مساحة تربويّة حيّة، حيث يصبح العلم تجربة محسوسة، ويغدو التعلّم فعلًا إبداعيًّا مقاومًا للرتابة والخوف معًا. تغيّر أساليبها لم يكن ترفًا تربويًّا، بل استجابة واعية لواقعٍ قاسٍ فرض على المعلّم أن يراجع أدواته ولغته، وطريقته في الوصول إلى عقل الطفل وقلبه في آن واحد.
نعود كثيرًا، في لحظات الهدوء النادرة، إلى سؤالٍ يبدو بسيطًا في صياغته، ثقيلًا في معناه: هل أخرجت الحرب أحسن ما لدينا؟ أم كشفت فقط ما كان كامنًا فينا ولم يجد فرصة للظهور؟ حيث كنّا قبل السابع من أكتوبر نتحرّك داخل أنظمة تعليميّة مألوفة، آمنة نسبيًّا، تُحدّد لنا الأطر، وتمنحنا شعورًا زائفًا بالاستقرار. لم نكن سيّئين، لكننا كنّا مقيّدين. نُجيد الأداء داخل القالب، ونُبدع أحيانًا على رغمه، لا بسببه. جاءت الحرب لا لتصنع إنسانًا جديدًا، بل لتُسقط الأقنعة، وتكسر الجدران، وتضعنا وجهًا لوجه أمام جوهرنا التربويّ والإنسانيّ.
ما حدث لم يكن تطوّرًا تدريجيًّا، بل قفزة قسريّة. في لحظة، سقط المنهج، وغابت الصفوف، وتلاشت الأدوات، وبقي الطفل. بقي السؤال الحقيقيّ: ماذا يعني التعليم حين لا يبقى شيء؟ هنا وُلد التعليم الشعبيّ، لا بدوره نظريّة، بل بدوره ضرورة وجوديّة. تعليم بلا جداول، بلا امتحانات، بلا سلطة عليا، تعليم قائم على العلاقة والإصغاء، والنجاة المشتركة.
هذه التجربة لم تغيّر أدواتنا فقط، بل أعادت تشكيل وعينا التربويّ. تعلّمنا أنّ الطفل ليس متلقّيًا، بل شريكًا في المعنى. تعلّمنا أنّ اللعب ليس ترفًا، بل آليّة شفاء، وأنّ المعرفة لا تُلقّن، بل تُبنى في السياق، وسط الخوف والحرمان، والأمل الهشّ. تعلّمنا أنّ التربية فعل أخلاقيّ قبل أن تكون وظيفة، وأنّ المعلّم ليس ناقل محتوى، بل حامل معنى.
لكنّ السؤال الأصعب لا يتعلّق بالماضي، بل بالمستقبل:
هل سنستطيع الاستثمار في هذه التجربة حقًا؟
الخطر الحقيقيّ ليس في ضياع ما تعلّمناه، بل في تطبيعه داخل القوالب القديمة. أن نأخذ روح التعليم التحرّريّ ونُفرّغها في استمارات، وأن نُحوّل التجربة إلى "مبادرة" تُقيَّم بالأرقام، وتُحاصر باللوائح. النظام الرسميّ لا يعادي الإبداع صراحة، لكنّه يروّضه، ويُعيده إلى حدود "المسموح".
الاستثمار الحقيقيّ في تجربة التعليم الشعبيّ يتطلّب شجاعة مؤسّسيّة، ووعيًا نقديًّا، وقرارًا بعدم العودة كما كنّا. يتطلّب الاعتراف بأنّ ما حدث ليس استثناءً مؤقّتًا، بل كشفًا لحقيقة أعمق: أنّ التعليم الأكثر إنسانيّة هو التعليم الأقرب إلى الناس، إلى حياتهم وأسئلتهم.
ربّما لا نستطيع تغيير النظام دفعة واحدة، لكننا نستطيع أن نغيّر موقعنا داخله. أن نُبقي جذوة التحرّر مشتعلة، وأن نرفض النسيان. فأسوأ ما قد تفعله الحرب، ليس الدمار، بل أن نخرج منها كما دخلنا.
ختاماً، نستطيع القول إنّه في خضمّ هذه التحوّلات العميقة التي فرضتها الحرب على الفعل التربويّ، تبرز تجارب فرديّة صادقة شكّلت ملامح ما يمكن تسميته بـ "التحرّر التربويّ القسريّ". من بين هذه التجارب، تقف تجربة الزميلة ميسون أبو موسى بوصفها شاهدًا حيًّا على لحظة الانفصال الأولى عن القالب التقليديّ، ولحظة الجرأة على إعادة تخيّل التعليم من الداخل. لم تكن ميسون تنظّر لبدائل تعليميّة، بل كانت تمارسها فعليًّا حين وجدت نفسها أمام طلّاب بلا صفوف، وبلا أدوات، لكن بقلوب متعبة وعقول متعطّشة للمعنى. في تلك اللحظة، لم يكن السؤال: كيف أُنجز المنهاج؟ بل: كيف أحافظ على علاقة الطفل بالعلم في زمن الانكسار؟ فكان اللعب، واللغة الشعبيّة والموسيقى، وأغنية "تك تك تك يامّ سليمان" أدواتها لبناء الفهم والطمأنينة معًا. أغنية بسيطة تحوّلت إلى قصيدة علميّة، ومفهوم معقّد صار إيقاعًا يُردَّد. هذه التجربة لا تمثّل استثناءً فرديًّا، بل تكشف عن تحوّل أعمق في وعينا التربويّ، وتفتح الباب للسؤال الأكبر الذي فرضته الحرب على جميع المعلّمين: ماذا بقي من التعليم حين سقطت كلّ الأطر التي اعتدناها؟