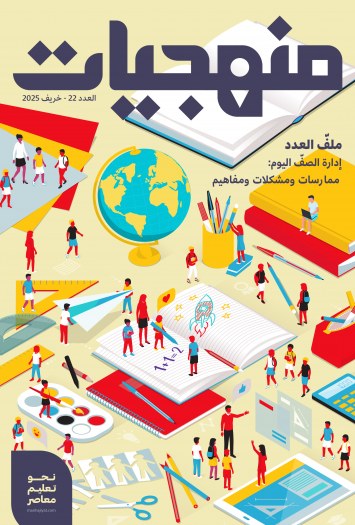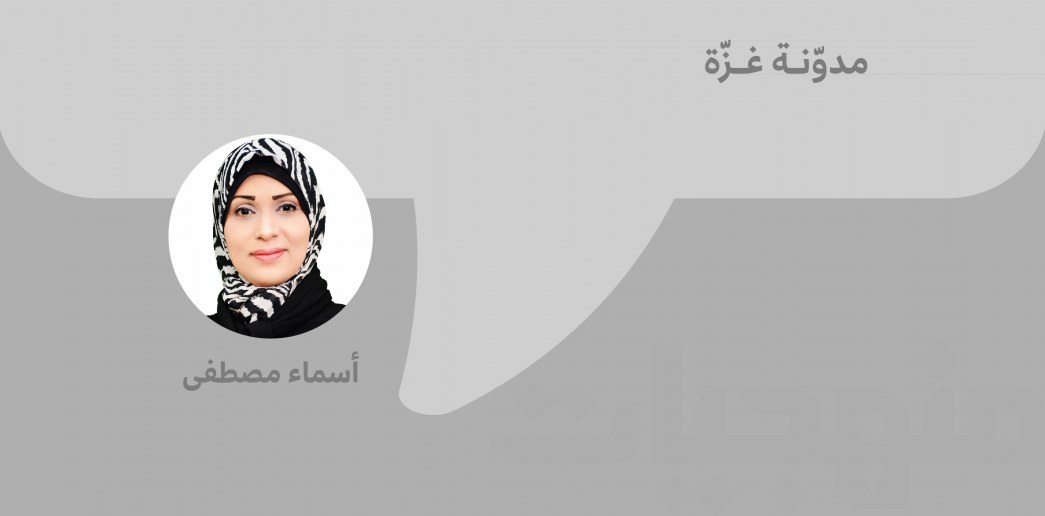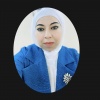أنسنة التعليم في غزة زمن الإبادة: مقاربة تربويّة في ضوء التجربة الفلسطينيّة
شهد قطاع غزّة منذ أكتوبر 2023، واحدة من أعنف الحروب في التاريخ المعاصر، أدّت إلى تدمير مئات المدارس والجامعات، واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين، وانقطاع العمليّة التعليميّة لفترات طويلة. وفي خضمّ هذا الدمار المادّيّ والمعنويّ، ظهرت مبادرات تربويّة فرديّة وجماعيّة أعادت تعريف التعليم بوصفه فعلًا إنسانيًًا في المقام الأوّل. من هنا، يبرز السؤال المركزيّ: كيف تحقّقت أنسنة التعليم بشكل تلقائيّ في ظلّ الإبادة في غزّة؟
من المعروف أنّ التعليم في السياق الفلسطينيّ يُعدّ عملًا إنسانيًًا ومقاومًا في آن واحد، إذ يواجه المعلّم والطالب تحدّيات مركّبة تتجاوز حدود الفقر والحرمان، لتصل إلى صميم البقاء ذاته. وفي غزّة، حيث تتقاطع الجغرافيا بالحصار والدمار، يتحوّل الفعل التربويّ إلى فعل صمود يوميّ، تُمارَس فيه أنسنة التعليم بوصفها فلسفة تربويّة، وموقفًا أخلاقيًًا قبل أن تكون ممارسة مهنيّة. أفرزت الإبادة الجماعيّة الأخيرة في قطاع غزّة مشهدًا تعليميًًا غير مسبوق، تهاوت فيه البنية التحتيّة، وتقطّعت فيه أوصال المؤسّسات، وتحوّلت الفصول إلى ملاجئ أو أنقاض، ومع ذلك ظلّ التعليم فعلاً للحياة، وإصرارًا على المعنى.
تُعَدّ أنسنة التعليم في زمن الإبادة مفهومًا تربويًًا يهدف إلى استعادة جوهر الإنسان في العمليّة التعليميّة، بتركيزها على الكرامة الإنسانيّة، والاحتياجات النفسيّة والاجتماعيّة للمتعلّمين، وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم على رغم الألم. ومن هنا تأتي أهمّيّة هذا المقال الذي يهدف إلى تحليل واقع التعليم في غزّة في ظلّ الإبادة، واستكشاف آليّات أنسنته فعلَ مقاومة تربويّة وثقافيّة. وتستند الدراسة إلى المنهج الوصفيّ التحليليّ الذي يوظّف الشهادات الميدانيّة والممارسات التربويّة الواقعيّة، لفهم كيف حافظ المعلّم الفلسطينيّ على رسالته التربويّة بوصفها فعلًا إنسانيًًا يواجه القسوة والخراب بالرحمة والأمل.
الإطار النظريّ والمفاهيميّ لـِ"أنسنة التعليم"
يقصَد بأنسنة التعليم تحويل العمليّة التعليميّة من مجرّد نقل للمعرفة إلى ممارسة قوامها الكرامة الإنسانيّة، والاحترام المتبادل، وتنمية الوعي الذاتيّ والاجتماعيّ. وفقًا لباولو فريري (Freire, 1970)، تُمثّل التربية أداة تحرّر من القهر، ووسيلة لتمكين الإنسان من قراءة واقعه وتغييره. ويُستند إلى هذا المفهوم في السياق الفلسطينيّ بوصفه تربية تحرّريّة مقاومة، تُعلي من شأن الإنسان في مواجهة العنف البنيويّ والاستعمار المعرفيّ.
أمّا الإبادة التعليميّة في غزّة، فتمثّل نمطًا مركّبًا من التدمير المتعمّد للبنية التحتيّة التعليميّة، وللحقّ في التعلّم ذاته، بما يشمل المدارس والمناهج والرموز الثقافيّة والذاكرة الجماعيّة. في هذا السياق، تصبح أنسنة التعليم فعلًا مضادًّا للإبادة، لأنّها تعيد إلى الإنسان وعيه وقدرته على الفعل والتعبير على رغم محاولات المحو.
السياق الغزّي: التعليم تحت الحصار والإبادة
على مدار عامين من الحرب المتواصلة، تعرّض النظام التعليمي في غزة إلى انهيار شامل: أكثر من 80% من المدارس تحوّلت إلى ملاجئ للنازحين، وتوقّفت العمليّة التعليميّة الرسميّة في معظم المناطق. ومع ذلك، لم يتوقّف المعلّمون والطلبة عن ممارسة فعل التعليم بوسائل بديلة: فصول مؤقّتة في الخيام، حصص عبر تطبيقات الهواتف البسيطة، ومبادرات مجتمعيّة يقودها معلّمون مبادرون، وتشاركهم الأسر ومجموعات شبابيّة ناشطة مجتمعيًّا.
هذا الواقع جعل من التعليم ممارسة جماعيّة ذات بعد إنسانيّ عميق، حيث أصبح الهدف الأساس حماية الأطفال من الانهيار النفسيّ، وإعادة بناء إحساسهم بالأمان والانتماء. التعليم هنا لم يكن عمليّة معرفيّة فقط، بل طوق نجاة إنسانيّ، يعيد إلى الطفل معنى الوجود في عالم يتهاوى.
الممارسات التربويّة الإنسانيّة في زمن الحرب
انطلاقًا من الإطار المفاهيميّ لأنسنة التعليم، ومع استحضار الواقع الغزّيّ الذي أفرزته الإبادة، يمكن القول إنّ التجربة التربويّة في غزّة قدّمت نموذجًا عمليًّا حيًّا لتجسيد هذا المفهوم في الميدان. فقد تحوّل التعليم، في ظلّ غياب المؤسّسات الرسميّة وتدمير البنية التحتيّة، إلى ممارسة إنسانيّة جماعيّة تستند إلى القيم الجوهريّة للرحمة والتضامن والكرامة. وفي ضوء ذلك، اتّخذت أنسنة التعليم في غزّة أشكالًا متعدّدة، من أبرزها:
- إعادة تعريف دور المعلّم:
لم يعد المعلّم في سياق الحرب ناقلًا للمعرفة أو منفّذًا للمناهج فحسب، بل تحوّل إلى ميسّر للدعم النفسيّ والاجتماعيّ، يعمل على احتواء الصدمات والتخفيف من آثارها في الطلبة. أصبح المعلم أيضًا راويًا للذاكرة الجماعيّة، يوثّق القصص والتجارب اليوميّة ويحوّلها إلى مادّة تعليميّة تزرع في الأطفال الإحساس بالهويّة والانتماء. كما تولّى دور يمكن وصفه بـ"الإسعاف التعليميّ الأوّليّ"، إذ يقدّم استجابات تربويّة عاجلة تضمن استمرار عمليّة التعليم في ظلّ الدمار والنزوح، مستخدمًا أبسط الوسائل الممكنة. في هذا الإطار، غدا الحضور الإنسانيّ للمعلّم في حياة الطلبة أكثر أهمّيّة من المحتوى المعرفيّ ذاته، لأنّه يمثّل رمز الأمان والاستمراريّة في عالم فقد ثوابته. - إدماج الخبرة الحياتيّة في التعليم:
أدرك المعلّمون في غزّة أنّ التجربة اليوميّة للطلبة تمثّل موردًا تعليميًّا غنيًّا، يمكن توظيفه في بناء المعنى وتنمية مهارات التفكير. فبدلًا من الاعتماد على أمثلة بعيدة عن واقع الطلبة، أصبحت الحياة في الخيام، وفقدان الأحبّة، وتجارب النزوح موادّ تعليميّة تُدمج في الدروس لتقوية التعبير اللغويّ، وتنمية المرونة النفسيّة والاجتماعيّة. ساعد هذا النهج على تحويل الألم إلى طاقة معرفيّة، والواقع القاسي إلى مساحة للتفكير النقديّ وإعادة بناء الذات. هذا الشكل من التعليم يربط المعرفة بالحياة، ويجعل من المدرسة، حتّى في خيم الطوارئ، فضاءً لفهم الذات والعالم بعمق أكبر. - التعليم القائم على المشاركة:
فرضت ظروف الطوارئ إعادة النظر إلى العلاقة التقليديّة بين المعلّم والطالب، حيث لم يعد هناك مجال للسلطة التربويّة العموديّة. وبدلًا من ذلك، تشكّل نظام أفقيّ من التعاون والتكافل، يقوم على الثقة والتعاطف المتبادل. شارك الطلبة في تخطيط الأنشطة وتنفيذها، واقترحوا حلولًا للمشكلات اليوميّة في بيئة التعلم. كما ظهرت مبادرات جماعيّة يتقاسم فيها الطلبة والمعلّمون المسؤوليّة عن التعلّم، بما يعزّز روح الانتماء ويقوّي مهارات القيادة والمبادرة. هذا النمط من التعليم يعكس تحوّل المدرسة إلى مجتمع تعلّم مصغّر، لا يقوم على الامتثال، بل على المشاركة الواعية والمسؤولة. - استخدام الموارد المحلّيّة والإبداعيّة:
في ظلّ فقدان البنية التحتيّة التعليميّة وندرة الوسائل، أظهر المعلمون في غزّة قدرات إبداعيّة استثنائيّة في توظيف ما هو متاح. فقد استخدموا الكرتون بديلاً عن السبّورات، وأوراق الإغاثة للكتابة، والقصص الشفويّة وسائلَ لتعليم اللغة والتاريخ. وتم تحويل البيئات المدمّرة إلى مختبرات تعليميّة، حيث يتعلّم الأطفال من حولهم مبادئ العلوم والبيئة والهندسة بطرق تجريبيّة بسيطة. هذه الممارسات لم تكن مجرّد حلول مؤقّتة، بل شكّلت نواة فكر تربويّ بديل، يؤمن بأنّ التعليم يمكن أن يولد من قلب الأزمة، وأنّ الإبداع استجابة إنسانيّة طبيعيّة عندما يصبح البقاء فعل مقاومة.
هذه الممارسات تشير إلى أنّ أنسنة التعليم ليست مفهومًا نظريًّا فحسب، بل هي استجابة واقعيّة تنبثق من رحم المعاناة لتعيد إلى التربية معناها الأصليّ بوصفها فعلًا إنسانيًّا جامعًا.
دور المعلمين والباحثين التحرّريّين في أنسنة التعليم
برز المعلّمون الباحثون التحرّريّون في غزّة قادةَ فكرٍ تربويّ وميدانيّ. فهم لم يكتفوا بممارسة التعليم، بل وثّقوا تجاربهم ودرسوها بعيون نقديّة تحليليّة. وببحوثهم التحريريّة، سعوا إلى تحويل التجربة الجماعيّة إلى معرفة منظّمة تسهم في تطوير فلسفة تعليميّة جديدة، تستند إلى الصمود والمقاومة والكرامة.
لقد مثّلوا نموذج "المعلّم المفكّر"، الذي يجمع بين الممارسة والبحث، وبين التجربة والتحليل، واضعين أسسًا لتعليمٍ فلسطينيّ مقاوم يواجه العنف بالوعي. لقد نجحوا في تجسيد جوهر أنسنة التعليم عبر تحويل الألم إلى معرفة، والمعاناة إلى وعي تحرّريّ.
التحدّيات والفرص المستقبليّة
تواجه أنسنة التعليم في غزّة تحدّيات مركّبة، منها استمرار العدوان واحتماليّة تكراره، وفقدان الموارد، وانهيار البنية التحتيّة التعليميّة، وضعف الدعم الدوليّ الحقيقيّ للحقّ في التعليم. ومع ذلك، فهذه التجربة أفرزت فرصًا مهمّة لبناء نموذج تربويّ جديد يقوم على:
- - التحوّل نحو التعليم المجتمعيّ المرن القائم على الشراكة بين المعلّمين والأسر والمجتمع المدنيّ.
- - تعزيز البحث التربويّ الميدانيّ لفهم احتياجات التعليم في أوقات الطوارئ.
- - إدماج التربية على الأمل والسلام والعدالة في المناهج المستقبليّة، لترسيخ القيم الإنسانيّة في مواجهة العنف.
- - إعادة بناء فلسفة تربويّة فلسطينيّة تنطلق من التجربة المحلّيّة، وتتبنّى مبادئ الكرامة، والمشاركة، والتحرّر من القهر.
ختــــــــــــــاماً، تشكّل تجربة التعليم في غزّة خلال زمن الإبادة، نموذجًا فريدًا لأنسنة التعليم في أقسى الظروف الإنسانيّة، حيث أثبت المعلّمون والطلّاب أنّ التعليم يتجاوز كونه مجرّد فعل مؤسّسيّ ليصبح تعبيرًا عن جوهر الوجود الإنسانيّ، وحقّ الإنسان في الوعي والحلم والبقاء، ووسيلة للحفاظ على الكرامة وسط الخراب. وفي مواجهة محاولات الإبادة المادّيّة والمعرفيّة، أصبح التعليم الإنسانيّ أداة مقاومة عمليّة، تسهم في حماية الذاكرة التربويّة الفلسطينيّة من النسيان، وتحافظ على استمراريّة العمليّة التعليميّة على رغم التحدّيات الشديدة.
وتؤكّد هذه التجربة أنّ أنسنة التعليم ليست مجرّد دعوة أخلاقيّة أو فلسفة نظريّة، بل مشروع تربويّ تحرّريّ عمليّ، يؤسّس لنهج عالميّ بديل في التربية أثناء الأزمات، يضع الإنسان في صميم العمليّة التعليميّة، ويجعل العدالة والكرامة هدفًا أساسيًّا لها. إنّ إدماج القيم الإنسانيّة، والدعم النفسيّ والاجتماعيّ، وتجربة المشاركة الفاعلة للطلبة والمعلمين في تصميم التعلّم وتنفيذه، تعزّز من قدرة النظام التعليميّ على الصمود في ظلّ الظروف الاستثنائيّة.
كما تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي نموذج «التعليم المقاوم بالإنسانيّة»، الذي يجمع بين الممارسة التربويّة والبحث العلميّ الميدانيّ، ويحوّل التجارب الفرديّة والجماعيّة إلى معرفة منظّمة تساعد على تطوير سياسات تعليميّة مرنة ومستدامة. وفي هذا الإطار، تصبح غزّة مختبرًا تربويًّا حيًّا، يقدّم نموذجًا متقدّمًا لإعادة تعريف التعليم فعلَ مقاومة وإنسانيّة، قادر على مواجهة العنف والحفاظ على الأمل والمعرفة، وإلهام المجتمعات المتأثّرة بالنزاعات حول العالم لتطوير أنظمة تعليميّة قائمة على الإنسان والكرامة والعدالة.