
- النظر في تجربتك وما تقدّمه، يشير إلى تلك العلاقة الأساسيّة بين الحياة الشخصيّة وتبدّلاتها من جهة، وفهم التعليم والتعلّم من جهة أخرى، وصولًا إلى تطوير رؤية تجاه التعليم والتعلّم قائمة على مفردات وتجارب فريدة، من الرياضيّات إلى رفض المأسسة، من التعلّم إلى "الحكمة" و"العافية" و"المجاورة". نبدأ بسؤال عامّ، كيف أفضت تجربتك إلى رؤيتك الخاصّة في التعلّم؟
نعم هذه القناعات والخلاصات جاءت من حياتي، من تجربتي في العيش والتعليم وكلّ الظروف المحيطة. ولدت في القدس سنة 1941م، في موضع يتوسّط الطريق بين مهد المسيح وقبره، كنت أستطيع الذهاب مشيًا إلى الموضعين، وفي النكبة سنة 1948 هُجّرنا من القدس.
أوّل تمرّد عشته ضدّ التعليم كان في الطفولة المبكّرة في القدس، تحديدًا حين انتزعني أهلي من حديقة بيتنا، من "بستاننا"، ووضعوني في صفّ "البستان"، المرحلة الأولى من الدراسة في الروضة. ببساطة أخذوني من بستان حقيقيّ، ووضعوني في بستان كلّ ما فيه مزيّف، أشياء مصنّعة مرتّبة حتّى تؤدّي إلى شيء محدّد مرسوم سلفًا، بدل احترام التعلّم كقدرة عضويّة، لا تحتاج إلّا إلى جوّ حقيقيّ. احتلال بستان مصنَّع محلّ بستان حقيقيّ، كان أوّل مثال على احتلال تعليم نظاميّ محلّ التعلّم.
حين انتزعني أبي من البستان الحقيقيّ ليأخذني إلى صفّ "البستان"، كنت أختلق كلّ يوم أعذارًا لعدم ذهابي، وتنقلها خالتي إلى أبي. حتّى انتبه أبي، وكان سائق سيّارة أجرة، ربطني يومها بحبل، ووضعني في السيّارة، وألزمني بالذهاب.
من صفّ "البستان"، حتّى الدكتوراه في هارفارد، كانت التجربة انتزاعًا لي ممّا هو حقيقيّ، لأوضع في ما هو مصنّع.
مرّت هذه الطفولة، وما بعدها من دراسة، وصولًا إلى حرب 67، اللحظة الفارقة في وعيي بما أفعل. بدأت الحرب وأنا أراقب في الاختبارات النهائيّة في كليّة "بيرزيت"، عملتُ مدرّسًا للرياضيّات من 1962 إلى 1967. عمليًّا، بدأت الحرب وانتهت دون أن أدرك أو أفهم ما حصل، عندها تساءلت عن فائدة هذه المعرفة التي حصلتُ عليها وكنتُ أنشرها إذ لا علاقة لها بكلّ ما حولنا، لا علاقة لها بما يجري، وبما يغيّر حياتنا كلّها؛ نكون ضمن وضع أستطيع فيه التنقّل والحركة إلى كلّ مدن بلاد الشام، والتواصل مع كلّ المنطقة، ثمّ في ساعات أصير غير قادر على الوصول إلى عمّان، وأصير تحت الاحتلال، وتحت حكم جديد. كان لحظة وعيٍ وإدراك، لكنّني لم أفعل شيئًا حيال ذلك إلّا في 1971.
في الحقيقة، ثمّة فترتان في حياة المجتمع الفلسطينيّ أحدثتا داخلي حركةً من الأعماق، الأولى من 71 إلى81، أي عقد السبعينيّات، والثانية من 87 إلى 91، أي الانتفاضة الأولى. هاتان الفترتان كانتا مصدر إلهامي، ورسوخ معانيّ، وفهمي للحياة.
- فلنبدأ بالأولى، عقد السبعينيّات، ما الذي تحرّك فيك بوصفك معلّمًا وتربويًّا بعد حرب 67؟
في 1971 التقيت بعض الأصدقاء، وشاركتهم فكرة أنّني في حياتي كلّها لم أستعمل يديّ، وأنّ لديّ فكرةً ورغبةً وقناعةً بشأن ربط الفكر بالواقع، وأنّني اكتشفت حينها كم أنّ هذا الربط صعب دون الأصابع.
فحين أتعرّف إلى الحياة من نافذة معرفة مكوّنة من "أبجديّة"، سأنظر إليها من خلال كلمات، وهذا خلل ينطوي على إيحاءات غير صحيحة، مثل كلمة "نجاح"، مفردة تحرّك إيحاءً غير صحيح ولا دقيق، وهو يبدو دون معنى.
تحدّثت مع بعض الأصدقاء، واتّفقنا على استعمال أيدينا. بدأنا حركة العمل التطوعيّ في منطقة رام الله والبيرة. كان رئيسا بلديّتي رام الله والبيرة، كريم خلف وعبد الجواد صالح متعاونين معنا، فبدأنا بأعمال داخل المدينتين، وبعدها أخذنا نتوجّه إلى القرى والمخيّمات المحيطة برام الله.
استمرّت ظاهرة العمل التطوعيّ هذه عشر سنوات، وقد قلبت أفكاري كلّها. أذهب إلى الناس وأراقبهم وأعمل معهم في المخيّم والقرية. أعرفهم بالعيش والعمل بينهم، ويتبدّى لي الفرق بين هذه التجربة، وبين القراءة عن هذه المجتمعات ومحاولة فهمها عن بعد.
شاركت حتّى في رصف شوارع في الضفّة الغربيّة، كنا نمشي بدل استخدام وسائل نقل، خاصّةً حين تكون الأعداد كبيرةً، كان العدد أكثر من مئة في مرّات عديدة. كنّا نمشي مسافات طويلةً إلى قرًى ومخيّمات. مجموعة متباينة من الأعمار، رجال ونساء، جميعهم يعملون، لم يكن هناك قوانين ولا نظام داخليّ ولا تراتبيّة. حافظنا على هذا العمل أسبوعيًّا كلّ يومي جمعةٍ وأحدٍ مدّة عشر سنوات.
وفي 1973 اقترحت على رئيس جامعة بيرزيت، حنا ناصر أن يعتمد العمل التطوعيّ في الجامعة، فاعتمدته الجامعة فورًا متطلّب تخرّج، ولا زال كذلك حتّى اليوم. انتقلت الظاهرة من المجتمع إلى الجامعة والمدارس، دون أن تغادر المجتمع. يمكن وصفها بحركة للعمل التطوعيّ، بقيت حيّةً نشطةً في رام الله والبيرة على مدى عقد من الزمن.
وفي 1981 غادرت إلى هارفارد لدراسة الدكتوراه، ابتعدت عن البلد مدّة خمس سنوات. بالتزامن بدأت الفصائل السياسيّة تنظّم مجموعات عمل تطوعيّ، وبدأت المجموعات تتمايز بانتمائها ولونها، لم تعد مجموعةً واحدةً للجميع على اختلاف انتماءاتهم وأفكارهم، صار ثمّة تصنيف تابع لمجموعات سياسيّة، ونوادٍ تابعة لها، وهي باعتقادي فقدت الروح التي بدأنا بها.
- لو تناولنا تجربة النوادي والمجلات في الرياضيّات والعلوم؛ من أين أتت وكيف تطورت؟
المرجعيّة الرئيسة عندي هي مرحلة السبعينيّات، والعامل الرئيس فيها كان والدتي. كان عمري 35 عامًا، وكنت أعيش معها وهي أمّيّة تمامًا. كنت أتساءل: كيف تستطيع تصميم فساتين للنساء دون أيّ معرفة بالرياضيّات. هذا التفكير بأميّ، أحدث ما أسميه "زلزالًا بركانيًّا"، زلزالًا خلخل الأشياء التي أعرفها كلّها، وبركانًا أخرج من داخلي أشياءً مختلفة. والدتي فجّرت الأشياء المغيّبة في حياتي، وبدأت تطلع من داخلي.
ومع أنّني انتبهت لهذا التحوّل ومعانيه الجديدة في 1976، لم أتجرّأ أن أكتب عنه، أو حتّى أن أحكي عنه في إطار عامّ. بوصفي تربويًّا متخصّصًا بالرياضيّات لم أستطع القول: إنّ أمي تفهم أكثر منّي في الرياضيّات، أو القول: إنّني لا أفهم رياضيّاتها.
في 1979 صمّمت مساقًا في جامعة بيرزيت وسمّيته "الرياضيات في الاتّجاه الآخر"، أحبّه الطلّاب، وتشجّع له عدد قليل من المعلّمين وافقوا على العمل معي. كانت جامعة بيرزيت تمتلك الجرأة لقَبول مساق غير مستورد من مركز المعرفة الغربيّ. عملت مع الطلّاب تجريبيًّا مدّة سنة. بعدها أقرّته الجامعة في 1979، وظلّ عدّة سنوات ثمّ جرى إلغاؤه. في الدول العربيّة كان ثمّة ما يسمّى بالرياضيّات المعاصرة التي وضعتها اليونسكو، وطبّقت في كلّ الدول العربيّة عدا الضفّة وغزّة. وقتها التقيت مع بعض المتخصّصين في الرياضيّات، واتفقنا أن تتوفّر لدينا. تحدّثت مع جامعة بيرزيت ومديريّة تربية رام الله، اشتغلت مدّة خمس سنوات معهم على المناهج الجديدة، لكنّني وجدت أنّها في جوهرها لم تتغيّر. كان تجديدًا في الشكل، لا الجوهر. حينها قرّرت العمل على فكرتين:
مجلة رياضيّات يكتب الجميع فيها. ونوادي علوم ورياضيّات شجّعتُ الطلبة على تأسيسها والعمل من خلالها. فيما يخصّ المجلّات، أصدرنا سبعة أعداد دون ميزانيّة، أوّل مجلّة طبعنا منها 1500 نسخة، ونفدت بسرعة، فطبعت ألف نسخة أخرى ونفدت، والعدد الثاني كان ثلاثة آلاف نسخة، والعدد السابع، الأخير، كان سبعة آلاف نسخة. لم يكن لدينا رئيس تحرير، كلّ ما يرسله الطلّاب والأطفال، أو المعلّمون والمعلّمات يُنشَر كما هو؛ هذه خبرتهم وهي مهمّة. كان هدف المجلة القول: إنّ الرياضيّات ليست حكرًا على الأكاديميّين. كنت أسأل الأسئلة، وأطلب من الطلّاب والطالبات أن يعطوني المعنى. لا أنسى أبدًا إجابة طفلة عمرها سبع سنوات عن سؤالي: ما هي النقطة؟ قالت: "هي دائرة دون خزق".
أمّا نوادي العلوم والرياضيّات، فكان الطلّاب في المدارس يقولون: إنّه لا تتوفّر لديهم مختبرات ومكتبات لعمل نوادٍ. وكنت أقول لهم: إنّ كلّ المعارف تبدأ بسؤال عندك، لا بنظريّة ولا كتاب. السؤال عندك، وأنت تسعى للوصول إلى تفسير أو جواب أو حل له. ولذلك قلت لهم: ابدؤوا بسؤال، فليبدأ كلّ واحد منكم بسؤال، ثمّ يبحث عن جواب. لا حاجة لمعلّمين ومعلّمات، ابحثوا بأنفسكم.
لا يمكنكم تصوّر كم كانت تجربةً ناجحةً، تحديدًا في مدارس البنات. برأيي النساء أقرب للأمل، حتّى في الوقت الراهن في بلادنا، النساء أقرب بكثير للأمل، لأنّهنّ مرتبطات بالحياة والواقع أكثر من الرجال.
نجحت النوادي في مدارس البنات في رام الله والخليل ونابلس وجنين وطولكرم، وكنت حين أزور مدرسةً يستقبلني حشد كبير من الطالبات والطلّاب، كأنّها مظاهرة.
المختلف في هذه الرؤية أنّه لا يوجد حلّ جاهز ولا تعليمات، ولا شيء مفروض، كنت أقول: فليبدأ كلّ شيء منكم، ولكم فعل ما تريدون. صارت تتكوّن نشوة من الفعل النابع كليًّا من الطلّاب والطالبات، لا نموذجًا مطلوب التطبيق، ولا مرجعًا أو سلطةً تقول لهم ما يفعلون. وكانوا يتساءلون عن كلّ شيء: ما معنى رياضيّات؟ وما معنى معرفة؟ وما معنى تعلّم؟
مرّت سنتان ونصف لم ينتبه خلالها الاحتلال "الإسرائيليّ" لهذه النوادي، حتّى استدعاني الحاكم العسكريّ، وقال: إنّ هذه النوادي ممنوعة، ما لم تكن بإذن أو تصريح. قلت له: إنّها مجرّد رياضيّات. فقال: "هذه رياضيّات سياسيّة". حينها لم أفهم ما يقصد، ولكن بعدها أدركت معنى ما كنّا نفعله، إذ لا يمكنك السيطرة على الناس إن كانت مرجعيّتهم من داخلهم.
من وقتها بدأت التركيز على المعنى، وأنّ كلّ إنسان مصدرُ معنًى. اعرفوا ما الموجود بالكتب والقواميس وما على غرارها، لكن الضروريّ أن تفكّروا بأنفسكم بوصفكم مصدرًا للمعنى. أنت شريك في تكوين المعنى. من أوائل السبعينيّات، ظلّت هذه القناعة معي قناعةً أساسيّةً. نعم، كلّ إنسان مصدر معنًى ومعرفةٍ وفهم، إنّه شريك، وليس هو المصدر الوحيد ولا الأفضل. الطلّاب كانوا مصدر المجلّات والأندية، ورسخت القناعة لديهم ألّا أحدَ يستطيع تغيير قصّتهم.
يحضرني هنا خليل السكاكينيّ، قبل أكثر من مئة عام تنبّه إلى أنّ إذلال الطلبة نابع من ثلاثة مصادر، هي: وجود علامات، وجوائز، وعقاب. وحين أسّس مدرسةً في 1909 في القدس، كان شعارها: "إعزاز التلميذ لا إذلاله"، وطبّق هذا الكلام فعليًّا عبر: لا علامات، ولا جوائز، ولا عقاب. إن طرحتَ هذا الطرح اليوم، سيسألك الناس: لماذا سيدرس الطالب إن لم يكن ثمّة علامات وجوائز وعقاب!
- سنسألك لاحقًا عن إمكانيّة استعادة هذه الرؤية اليوم، وتطبيقها، لكن نودّ لو تعطينا الآن لمحةً عن مرحلة الانتفاضة الأولى، كانت أيضًا مرحلةً حافلةً في حياتك وتجربتك بوصفك تربويًّا ومعلّمًا.
في العام الدراسيّ 1986 – 1987 كنت عميدًا لشؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، واندلعت الانتفاضة في كانون أول ديسمبر 1987، وأغلق الاحتلال المؤسّسات التعليميّة الفلسطينيّة، فبدا لي الإغلاق فرصةً، فرصةً للتعلّم. التقيت مع مجموعة من مدرّسي بيرزيت، وتساءلنا: ما العمل؟ كانت لديّ مقترحات لجامعة بيرزيت، ولم تُقبل، فقرّرت ترك الجامعة نهائيًّا. خرجت وأسّست (تامر). كانت مؤسسةً ضدّ المأسسة.
سجّلنا المؤسّسةَ في القدس في 1989، وحصلنا على تصريح للعمل بوصفنا مؤسّسةً، لكن دون أيّة ميزانيّة. وصار لنا في شعفاط مقرٌّ للمؤسّسة. انطلقنا من فكرة السبعينيّات: التعلّم قدرة عضويّة، وكلّ ما يحتاجه التعلّم كي يحدث هو أجواء حقيقيّة غنيّة حيّة فيها كثير من المعطيات، ليست خطًّا مستقيمًا. كانت الفكرة الرئيسة في مؤسّسة تامر هي توفير أجواء تعلّميّة بكلّ المعاني المختلفة. وبدأنا حملة قراءة على صعيد فلسطين في 1992.
في السنة نفسها، أعلنّا عن أسبوع قراءة وطنيّ، وتركنا لكلّ مشارك فعل ما يريد. كان ثمّة حيويّة كبيرة في المجتمع بسبب الانتفاضة، ولِجان الأحياء، وكانت روح المبادرة عاليةً. من عكّا حتّى رفح، انتظمت مجموعات للقراءة في أسبوع القراءة. ثمّ خرجنا بفكرة جواز سفر للقراءة، بعنا منه مئة ألف نسخة في أوّل سنة. فيه معلومات عن الكتب التي قرأها كلّ حامل جواز. لم نضع قائمة كتب، كان الطلّاب يختارون. كانت هناك سبعة جوازات متتالية، يكون الطالب قد قرأ 150 كتابًا عند بعد الانتهاء منها. أيضًا كان لدينا شخصيّة مسرحيّة طوّرها يعقوب أبو عرفة مع فاتح عزّام، شخصيّة "نخلة الشبر"، كنّا نذهب إلى القرى، فيخرج الأطفال مشيًا لاستقبالنا، ونجد أهل القرية في انتظارنا. بعد العرض، كان يعقوب يطلب من الأطفال أن يخرجوا للمسرح أو المنصّة، ليقولوا ما يريدون. ومرّةً في غزّة كنّا نخطّط لعرض لثمانين شخصًا، فوجدنا أربعمئة طفل، والعشرات منهم يريدون مشاركة قصصهم وتجاربهم، كانت "مظاهرات" من نوع خاصّ.
- هل من الممكن استعادة هذه التجارب اليوم؟
حاليًّا ننفّذ "مجاورات" أكثر من أيّ شيء آخر. إنّنا متوقّفون الآن بسبب كورونا. نظّمنا عبر تطبيق "زوم" 12 لقاءً عن فيروسات عقليّة. في الأزمات يُترك الناس وحدَهم. المؤسّسات والأطر غير قادرة على الفعل، فيأخذ الناس قرارهم ودورهم، وهذا شيء أساسيّ وهامّ جدًا من وجهة نظري.
اليوم تغلي في نفوس الشباب حول العالم فكرة الخروج من الإطار المؤسّسيّ، أن يعملوا دون خبراء ونماذج وسلطات. اليوم في الحجر ربّما تكون الفرصة أكبر للانفكاك عن الشخص الذي يريد توجيهي وإخباري ما أفعل، وما لا أفعل. التعليم الرسميّ كما يظهر غير قادر على التحرّر من كتب مقرّرة والعودة إلى كتب بيان وتبيين والعودة من منهاج إلى رؤية في المعرفة ترتبط بحقيقة أنّ الإنسان يتغذى من أربعة أنواع من التربة (التي يجب أن تشكّل المنهاج): التربة الأرضيّة والثقافيّة والمجتمعيّة والوجدانيّة. صعب تغيير المناهج لكن يمكننا إدخال هذه الأتربة في أعمالنا، كلٌّ وفق سياقه.
أعمل اليوم على هذه الفكرة وأرى أنّها أساس حياتنا وتعلّمنا وثقافتنا. أيّ شيء لا ينبع من تربة لا ينمو. انظروا إلى جمال اللغة العربيّة، نضيف حرف الياء إلى "تربة" فتصير "تربيةً"، ثمّة علاقة حرفيّة بينهما.
في المجاورات، المسؤوليّة هي للذات، لا يوجد مسؤول إلّا ذاتك. المجاورة تحمي مثل رحم الأمّ، خاصّةً إن ركّزت على أنواع التربة الأربعة.
المجاورات تحدث عفويًّا بكثرة، مثلًا: الشبّان الذين يجتمعون للغناء والدبكة، دون مؤسّسة ولا نظام. النوادي التي تحدّثت عنها هي مجاورات، العمل التطوعيّ هو نوع من المجاورة. في فلسطين كانت سجون الاحتلال تجربةً في المجاورة، كان الطالب يُعتقل عدّة أشهر، وحين يخرج يكون شخصًا آخر بخبرات حياتيّة، وثقة بالنفس، ولسان طلق. كان الأسرى يتجاورون.
يوجد الكثير مما يمكن فعله، قد لا نستطيع تغيير المناهج وأشياء أخرى في التعليم، لكن لا يوجد ما يمنع أربعة أشخاص مثلًا عن الاجتماع معًا ليقوموا بنشاطات معيّنة، من المهمّ تشجيع هذا، وتأكيد أنّهم مسؤولون عن أنفسهم وتعلّمهم. تنشغل المؤسّسات والمنظّمات بأشياء قابلة للقياس، لكنّ ما لا يقاس، ويرتبط بـ"العافية"، هو مسؤوليّة الشخص نفسه.
فلنتحدّث عمّا هو مستطاع. مثلًا: فعل النطق والإصغاء بوصفه أساسًا في المجاورة. إنّه يمكن أن يتمّ داخل المدارس، يمكن أن ندخله إلى الحصّة. مع معلّمات من شعفاط في القدس، أدخلنا موضوع الاستماع إلى الصفّ. بدأت المعلّمات بسؤال طالب في بداية كلّ حصّة أن يحدّث الصفّ بما فعله منذ خرج من المدرسة يوم أمس، حتّى وصل اليوم إليها، ماذا رأى؟ وما هي الأشياء التي فكّر فيها وفعلها؟ الطفل يبدأ بعد هذا الاستماع بالتفكير والانتباه لما يحصل حوله، ويبدأ بالتعامل مع ما يحصل معه على أنّه خبرات وتجارب، تصبح عند مشاركتها مصدرًا للمعرفة. في النهاية، المكوّن الرئيس للإنسان هي قصّته. هذا ممكن مع الطلّاب الأصغر سنًّا، كون المنهاج أقلّ شراسةً منه في المراحل الأكبر، ويمكن إدخال النطق والإصغاء للحصّة.
- وماذا عن قصّة المعلّم نفسه؟
ربّما نحتاج الوصول إلى القناعة التي وصلتُ لها بسبب كلّ ما مررت به. الإصغاء أكبر هديّة يمكن أن يهديها المعلّم للطلبة. فالإصغاء أكثر من أيّ شيء آخر يساعد الطلبة في ترتيب عالمهم الداخليّ بأنفسهم. في 2008 بعد عودتي من هارفارد، كانت قناعاتي ترسّخت، ولم يكن لديّ أي اهتمام بالعمل في الأكاديميا. بدأت العمل مع أمّهات معلّمات من مخيم شعفاط في القدس، اشتغلت معهنّ لسنتين. قلت لهنّ: إن كنتنّ قادرات على تدبّر أمور حياتكنّ في وضع مثل وضع المخيّم، وما تزلن تحافظن على المحبة والأمل، فما الذي يمكنني تقديمه لكنّ! دوري ببساطة أن أصرّ على دور "المرآة"، التي تنظرون فيها لتروا الكنوز التي في دواخلكنّ.
هذا أسلوبي. إذا لم يبدأ الشخص من تأمّلاته وخبراته واجتهاده، فأيّ شيء يبنيه سينهار لأنّه بدون أساس. مع النساء كان سهلًا أن تعلن الكنوز عن نفسها، لأنّهنّ قادرات على تدبير أمور معيشتهنّ في ظروف قاهرة. قلت لهن: "أنتنّ العمود الفقريّ للشعب الفلسطينيّ، لا المؤسّسات ولا الأحزاب. لو أننا استبدلنا بأيّ واحدة منكنّ خمسةً من علماء التربية وعلم النفس والإدارة، لن يستطيعوا أن يفعلون ما تفعلن، وأن يبذلوا ما تبذلن من جهد نفسيّ وتربويّ واجتماعيّ وإداريّ، إنّ إدارة شؤونكنّ في ظروف مثل هذه شيء لا يقدر عليه المتخصّصون".
قبل تفشّي كورونا أيضًا، استعملت الأسلوب نفسَه مع نساء مركز الأميرة بسمة بحيّ النزهة في عمّان. في البداية قلت: ليس عندي ما أشاركه معكنّ. يجب أن يخرج كلُّ شيء منكنّ، وتتكلّمن. أوّلَ الأمر لم يعرفن عن أيّ شيء يحكين، وبمجرّد أن بدأت بعضهنّ بالحكي، حكي قصصهنّ اليوميّة المألوفة، بدأن يدركن أنّ قصصهنّ تستحقّ أن تُحكى، وخضنا سنة وسبعة أشهر حافلة بالقصص.
الخلاصة، في شعفاط وفي الدهيشة وفي النزهة، لم أعطِ ورقةً واحدةً للقراءة، فقط نبدأ بالمعرفة والمعاني التي تكوّنت عندهنّ في حياتهنّ. يحتاج الأمر صبرًا بلا شكّ. أسوأ ما في المدنيّة الحديثة أنّ السرعة صارت قيمةً، بل وقيمةً أساسيّةً. ينظّمون ورشةً مدّتها ثلاثة أيّام، ويسلّمون المشاركين شهادةً والتي بالضرورة تكون شهادة مزوّرة! هذا شيء مؤلم ولا بدّ من أن نستحضره دائمًا لنفعل عكسه. مجرّد الإصغاء تعلّم.
- فلنتحدّث عن "العافية" خاصّةً في الأوضاع التي نعيشها اليوم، مثل كورونا والأزمات الراهنة التي تعصف بنا، ما توصيفك للعلاقة بين التعلّم والعافية؟
العافية قيمة. المعرفة ليست قيمةً، العلم ليس قيمةً. حتّى المجاورة ليست قيمةَ. المجاورة بنية أساسيّة في المجتمع. أمّا العافية، فهي قيمة. والتعلّم هو قدرة عضويّة. هذه القدرة أُخفيتْ وخُرّبت من قبل التعليم الرسميّ الذي بدأ في أوروبا قبل 400 سنة. ما أراه وأعتقد به أنّ عافية الإنسان الذهنيّة والعقليّة خاصّةً، مرتبطة بالتعلّم كقدرة عضويّة. التعلّم قدرة بيولوجيّة، يمكن تخريبها، ويمكن استخدامها لأغراض سيّئة. التعلّم ليس قيمةً في حدّ ذاته. لقد حوّلوا التعليم إلى قيمة حين ألحقوا به فكرة الشهادات، أنت متعلّم والبرهان على ذلك أنّ لديك شهادة!
اليومَ مع كورونا، أرى أنّ التعليم عن بعد فيه مضرّة تفوق الفائدة؛ يظلّ الطفل جالسًا ساعاتٍ أمام شاشة، والشاشة نفسها ضارّة، إلى جانب الجلوس ساعات طويلةً. هذه مَضرّة. الطفل متوتّر، والجسم ساكن، والحركة لمن فيه عمره شيء أساسيّ. التعليم عن بعد مصمّم على أنّ إنهاء المنهاج هو المطلوب. المنهاج صار أهمّ من كلّ شيء.
كورونا وترامب، أمران من الضروريّ أن يهزّانا لتنبيهنا إلى أنّه ثمّة شيء خطأ في نمط حياتنا. من المهمّ عناية الناس ببعضهم في مجاورات لا تتطلّب إذنًا ولا رخصةً ولا ميزانيّات. إنّها أمل بالنسبة لنا. هي عمليّة بطيئة تحتاج صبرًا وإيمانًا، وتحتاج رؤًى، لا أهدافًا.
العالم العربيّ ما زال قائمًا على وجود ترابط خارج الدولة. العلاقات بين الناس ما زالت أساسيّة، تجد ذلك حتّى في المدن. أنا أقول: إنّ لدينا مقوّمات للبقاء والحياة أكثر من الولايات المتّحدة الأمريكيّة مثلًا. برأيي إن انحلّت الدولة عندهم فليس لديهم بديل. أمّا نحن، فمن ينظر إلى اليمن وغزّة يبصر أعجوبةً في البقاء. لا تزال لدينا لغة عربيّة حيّة، وعلاقات حيّة بالكامل.
يجب أن يكون العيش بعافية ضمن مجاورات هو الرؤية التي تحكم التعلّم. ما نحتاجه موجود لدينا، المهمّ أن نعيَ ذلك. لسنا بحاجة لاستيراد شيء ما دمنا بعافية.
أثناء دراستي للماجستير في أواسط الستينيّات كنت معجبًا ببرتراند راسل Bertrand Russell، كنت معجبًا جدًّا بالمنطق والبديهيّات والوصول إلى نتائج، لكنّني شعرت بوجود خطأ ما، كلّ هذه الطريقة ملهية، لأنّ الأهمّ هو ما لم أنتبه له؛ راسل لم يعرف الحياة، لم يختبرها بيديه، هذا ما جعلني أبتعد عن المؤسّسة التعليميّة. في أوّل صيغة قدّمتها لأطروحة الدكتوراة، قالوا لي: إنّ المنهجيّة غير واضحة! قلت لهم: بالعكس، لا توجد منهجيّة. أنا لم أستعلمها، كنت قد مررت بتجارب أفضت إلى نتائج مذهلة. كان نهجي التأمّل في خبرات أمرّ بها والاجتهاد في تكوين معنى وفهم لها. النظريّات والمفاهيم نحتاجها في أمور تقنيّة، أمّا في الحياة فهي مشوّهة.
أيضًا تمرّدت على المؤسّسة الدينيّة. والدي ابتعد عن الكنيسة، لأنّهم يستخدمون اللفّة اليونانيّة في الصلاة، وكان يسأل عن السبب، فلا يحصل على إجابات، وذهب ليستمع إلى لقاءات دينيّة يعقدها خاله في بيته عبر مجاورة. الدين كالتعلّم يفقد روحه وجوهره حين يتمأسس.
تمرّدت في السبعينيّات على المؤسّسة الأكاديميّة والدينيّة، وكتبت كتيّبًا اسمه "مسيحيّة أمّي ومسيحيّة الغرب"، وفي 2006 حين تحدّث البابا ضدّ الإسلام، أرسلت له رسالةً من عشر صفحات، لأحدّثه عن الإسلام الذي أعرفه، وعن فهمي للمسيحيّة البعيدة عن مسيحيّة روما.
ترسّخت قناعتي أنّ الإنسان مرجع نفسه لكن ضمن مجاورات. يخسر الإنسان إذا لم ينظر إلى نفسه على أنّه مرجع وإلى المجاورة على أنّها "رحِم"، ولا يصمد في عالم شرس. أنا معجب بالإمام عليّ بوصفه مربّيًا. لديه مقولتان:
"ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه". و"قيمة كلّ امرئ ما يحسنه".
هاتان العبارتان يجب أن تكونا العمود الفقريّ للتعليم العربيّ. فيهما كل ما يعافينا من المدنيّة الحديثة، والأيديولوجيّة المهيمنة.










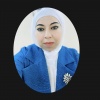


 نشر في عدد (3) شتاء 2021
نشر في عدد (3) شتاء 2021