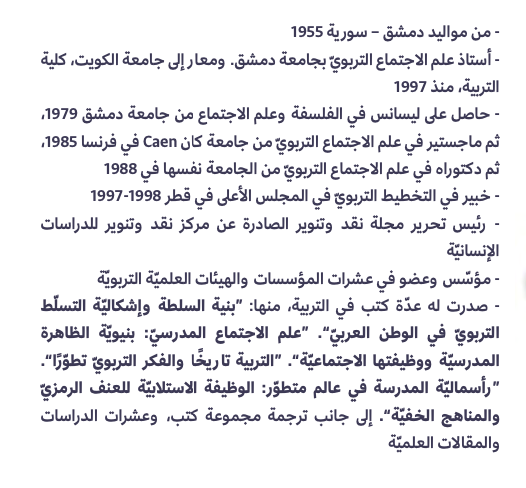
-
تحدّثتَ عن التغيير في التربية الذي يسير ببطء، وعن نماذج مختلفة للتغيير، ومن هنا ميّزت بين التجديد والتغيير: هل من نموذج تتبنّاه قد يؤسّس برأيك لتغيير التعليم في العالم العربيّ؟ هل بات كافيًا أن نبقى في التجديد؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ إيقاع التغيّر والتجديد في التربية والتعليم يتمّ على إيقاع التغيير في المجتمع بصورة عامّة، ووفقًا للقوانين التي تحكم التغيّر الاجتماعيّ. وممّا لا شكّ فيه أنّ التعليم يمتلك هامشه الخاصّ في التغيّر، ولكنّ هذا الهامش محدود جدًّا عندما نقارنه بالتغيّر التربويّ الذي يتمّ وفق قانونيّة التطوّر الاجتماعيّ العامّ. فالأنظمة التربويّة قد تتحرّك وفق قوانين مضادّة للتقدّم الاجتماعيّ، وقد تتحرّك في اتّجاه التغيّر التقدّميّ في المجتمع.
وهنا نأتي إلى إشكاليّة الفصل بين التغيّر والتجديد. والتجديد هو نوع من التغيّر المقصود والموجّه بإرادة المؤسّسات الاجتماعيّة الفاعلة: كأن يقوم وزير بوضع خطّة لتجديد الخطط المدرسيّة أو مناهج المدرسة بصورة مقصودة، وغالبًا ما يكون الهدف تطويرَ الأنظمة التربويّة بصورة من الصور. وغالبا ما يكون اتّجاه التجديد نحو الأفضل.
ويمكن هنا أيضًا أن نميّز بين التغيير والتغيّر، فالتغيير يكون أشبه بالتجديد، إذ توجد غالبًا إرادة فاعلة تقوم بإدارة التغيّر نحو أهداف محدّدة، وهنا يتجانس مفهوم التغيير مع مفهوم التجديد، ولكن دائمًا يجب أن نحتسب اتّجاهات التجديد والتغيير، فقد تكون إيجابيّة أو سلبيّة، والطابع السلبيّ والإيجابيّ مرهون بالطابع الأيديولوجيّ السائد في المجتمع والتربية.
على سبيل المثال: عندما تقوم جهة تربويّة ما بإحداث تجديد في المناهج وفق تصوّرات ليبراليّة، هذا سيبدو تجديدًا تطوّريًّا بالنسبة لليبراليّين، ولكنّه قد يبدو تخريبًا بالنسبة لأصحاب التيّارات التقليديّة. ويبقى علينا هنا أن نقول بأنّ التغيّر يختلف عن التغيير لأنّه ينطلق من الحركة الطبيعيّة القائمة في المجتمع دون أن يكون إراديًّا قائمًا على الرغبة في التجديد، فعلى سبيل المثال: قد يرتفع عدد الطلّاب الملتحقين بالمدرسة، والأمر ناتج عن حركة زيادة عدد السكّان. في هذه الحالة نقول هذا تغيّر تربويّ. ولكن عندما تقوم الوزارة بالتوسّع في عدد المدارس نقول بأنّ هذا تغيير موجّه إراديّ. وهذا يعني أنّ مفهوم التغيير أقرب إلى مفهوم التجديد والتطوير في البنية التعليميّة. ومع الأسف فكلّ من هذه الكلمات يوظّف في مكان الآخر مجازيًّا، وقليل من الباحثين الذين يميّزون في الحدود الدقيقة التي تفصل بينهما.
إنّ تغيير التعليم لا يتمّ وفق نماذج معيّنة بل تفرضه الضرورة التاريخيّة، ويمكن الاستفادة من التجارب العالميّة في بناء نموذج للتغيير، ومثل هذا النموذج ليس إبداعًا أو اختراعًا فرديًّا، فالتجارب العالميّة في مختلف أنحاء العالم تعطينا تصوّرات علميّة مبنيّة على المعرفة الموضوعيّة بصيرورة التطوير وآليّاته في المجتمع. وأنا في هذا السياق أقول، وأتحمّل مسؤوليّة قولي: إنني أرفض المقولة السائدة بأنّ "إصلاح التعليم يؤدّي إلى إصلاح المجتمع"، هذه مقولة فوضويّة لا تجد لها ما يساندها في الواقع؛ فالتربية أداة مجتمعيّة مهما تغيّرت وغيّرت في ذاتها، فهذا التغيّر محدود وقاصر بالعلاقة مع التغيّر الكبير الذي يجري في المجتمع، والمجتمع بصيغته الكلّيّة هو الذي يغيّر التربية ويتغيّر معها. وهذا يعني أنّه لا يمكن للتربية أن تغيّر في المجتمع دون إرادة المجتمع في أكثر صيغة شمولًا.
هذا يعني أنّ أيّ تغيير حضاريّ أو تربويّ لا يمكن أن يتمّ إلّا في سياق مشروع اجتماعيّ سياسيّ اقتصاديّ تربويّ متّفق عليه بين مؤسّسات المجتمع. وتبيّن التجارب في مختلف البلدان التي حقّقت نجاحًا تربويًّا ونهضويًّا أنّ هذا النجاح كان نتاجًا لمشروع سياسيّ اقتصاديّ اجتماعيّ تربويّ، كما حدث في سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبيّة وفيتنام وفنلندا والنروج والسويد وجنوب إفريقيا، ففي كلّ هذه التجارب كان مشروع النهضة مشروعًا سياسيًّا بالدرجة الأولى، ومن ثمّ اتّخذ هذا المشروع صبغته الاجتماعيّة التربويّة؛ فالتعليم لا يتغيّر إلّا بوجود إرادة مجتمعيّة تغيّره وتضعه في مساره الحضاريّ، هذا هو الأمر الذي علّمتنا إيّاه التجارب. والعامل المشترك في معظم هذه التجارب هو المناخ السياسيّ الديمقراطيّ الذي تمّت فيه عمليّة التطوير والنهوض الحضاريّ لهذه البلدان. وهذا يعني أنّ احتمال حدوث تطوير للتعليم في مجتمعاتنا مرهون إلى حدّ الضرورة القصوى بوجود أنظمة ديمقراطيّة تتبنّى مشروعًا حضاريًّا تربويًّا متكاملًا في مختلف النواحي والاتّجاهات. باختصار، تتمثّل رؤيتنا للإصلاح التربويّ في أنّه لا يمكن أن يتمّ إلّا في إطار إصلاح سياسيّ اجتماعيّ، ومن غير ذلك سيراوح التعليم في مكانه بصورة منافية لحركة التطوّر والتجديد التي نشهدها في المجتمع.
-
نهج التربية النقديّة والتربية التحرّريّة لم يعودا مرتبطين فقط بالاستعمار الغربيّ المباشر لبعض الدول، فالنظام النيوليبراليّ الذي طغى على عمليّة التعليم في العالم شوّه صور العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص وشرع الهيمنة الثقافيّة والسياسيّة... في العالم العربيّ، لماذا ما يزال صوت التربويّين النقديّين والتحرّريّين غير مسموع؟
لم تكن العدالة الاجتماعيّة يومًا في أفضل حالاتها في أيّ وقت مضى ولن تكون على ما أرى في أيّ وقت قادم، فالعدالة كانت غائبة إلى حدّ كبير في ظلّ الاستعمار بأيّ شكل اتّخذه أكان كولونياليًّا أو ليبراليًّا أو نيوليبراليًّا. فالعدالة مسألة وجوديّة وحلم إنسانيّ لم يتحقّق بصورته المثاليّة قطّ، ولن يتحقّق، والصراع الإنسانيّ الأبديّ كان دائمًا وأبدًا حول العدالة، وكلّما استطاع الإنسان أن يحقّق في دروبه النضاليّة تقدّمًا على طريق العدالة في صيغة من الصيغ انبثقت صيغ أخرى جديدة من الظلم أكثر فتكًا وأشدّ هولًا. وأرى ضمن هذا السياق أنّ مسألة العدالة لا ترتبط بالاستعمار فحسب، بل ترتبط بمختلف المظاهر الوجوديّة للحياة، فالدول التي نالت استقلالها اليوم لا تطبّق العدالة، بل ربّما كانت العدالة أفضل في العهد الاستعماريّ. فالعدالة مسألة طبقيّة تتعلّق بالتفاوت الاجتماعيّ بين الناس والفئات الاجتماعيّة.
وفي مستوى التعليم تنعكس الظروف الاجتماعيّة للأفراد والطبقات في التعليم بصورة حتميّة، فالطبقات الميسورة تحظى بتعليم أفضل، والطبقات الفقيرة مدارسها أقلّ كفاءةً وأهليّةً. وتكافؤ الفرص مسألة غائبة في التعليم العربيّ بصورة عامّة، وهو رهن الوضعيّات الاجتماعيّة للأفراد. فالمدارس الخاصّة والمميّزة على سبيل المثال لا الحصر، تكون من نصيب الأغنياء والموسرين، والمدارس العامّة تكون من أجل الطبقات العامّة. وممّا لا شكّ فيه أنّ اللّامساواة التربويّة تأخذ ألف شكل وألف لون، ولا يمكن ضبطها في صيغة واحدة. ومنها أنّه لو وضعنا صيغةً واحدة للتعليم لظهرت مسألة اللّامساواة بقوّة. فالأطفال يدخلون إلى المدرسة، لكنّ القويّ هو الذي يفوز دائمًا، والأقوى غالبًا ما تميّز عن الضعيف بامتيازاته الاجتماعيّة والثقافيّة، وهذا الاختلاف لا يمكن السيطرة عليه أو ضبطه ضمن مفهوم العدالة. وهنا أرى أنّ جزءًا من العدالة التربويّة يتمثّل في القدرة على تحسين ظروف الحياة وأسبابها لأبناء الفئات الفقيرة والمعوزة.
إنّ سماع الصوت رهين بمن يريد أن يسمع، فأصوات التربويّين النقديّين العرب قويّة بما فيه الكفاية لتُسمع من في أذنه صمم. ولكنّ المشكلة أنّه ثمّة كثير ممّن لا يريد أن يسمع أبدًا، وإن سمع فإنّه يستنكر ما قد يسمع. فأصوات النقديّين لا تُسمع، لأنّها تهدّد المصالح والأيديولوجيّات السائدة في التعليم وفي التربية. فالتربية في بلادنا محكومة بالطغمة من أنصار الأيديولوجيّات التقليديّة التي ترفض التجديد والابتكار والتغيير، وتريد المحافظة على التربية كأداة في ترويض الناشئة والأطفال على الاستسلام لكلّ ما هو قائم في المجتمع من سلبيّات مدمّرة، أهمّها مقاومة الإبداع والابتكار والتجديد. ولا يخفى مطلقًا أنّ الأنظمة الاستبداديّة التي تعتمد المدرسة كأداة أيديولوجيّة في ترسيخ قيم الاستبداد والاستعباد ترفض أيّ نقد أو مراجعة نقديّة لأوضاع التربية، وتحاول أن تحافظ على المدرسة بوصفها أفضل أداة لإنتاج مجتمع تهيمن فيه النخب الأوليغارشيّة الإقطاعيّة القديمة. ومن هذا المنطلق فإنّهم يصمّون آذانهم كي لا يسمعوا أصوات النقد والتفكير أو التجديد، وإن سمعوها قمعوها وقمعوا المنادين بها، وخنقوا أصواتهم وضربوا مكامن وجودهم.
-
لا بدّ من السؤال عن التعليم خلال الجائحة: بعيدًا عن ذكر الإشكاليّات والتحدّيات، كيف يمكن بالفعل استغلال الأزمة لإحداث تغيير ولو بسيط؟ وما الجديد برأيك الذي أظهرته الجائحة خاصّة فيما يرتبط بدور المعلّم ودور الطالب ودور الأهل حتّى؟ هل من بوادر إيجابيّة يمكن البناء عليها أو التفاؤل بها؟
جاءت جائحة كورونا على غير موعد بوصفها كارثةً يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ الإنسانيّة، لا سيّما من حيث تأثيراتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولكن وكما يقول بعض المفكّرين: "إنّ المصائب تحمل في خطوبها بعضًا من الأمل"؛ فكثيرًا ما تؤدّي الأزمات والويلات والكوارث إلى نتائج في صالح البشريّة بصورة اكتشافات علميّة واختراعات. والسؤال هنا: ما الذي يمكن لهذه المصيبة الكورونيّة أن تحمل للتربية العربيّة المستقبليّة؟ وهل ثمّة بصيص أمل في أن تكون صدمتها مفيدةً في مجال تطوير التربية العربيّة؟
جاء كورونا اليوم ليصعق المدرسة العربيّة بصدمته الوجوديّة العاتية التي يرجى لها أن توقظ التعليم العربيّ، وتخرجه من كهوفه المظلمة ومن مستنقعاته الآسنة، وقد حانت اللحظة التاريخيّة ليقظة التعليم العربيّ من سباته الأسطوريّ علّه يخرج من دوائر اختناقه إلى عالم النور والحياة. وممّا لا شكّ فيه أنّ مستقبل التعليم العربيّ سيكون بعد الكارثة مستقبلًا ملحميًّا مثقلًا بالأحداث الجسام والقرارات الصعبة الحاسمة، فثمّة تحوّلات عميقة جوهريّة ستقلب ظهر المجنّ للتعليم التقليديّ بمرتكزاته وفلسفاته وهيكليّاته المترهّلة. ومع أهمّيّة إدراكنا اليوم لأمر التغيير في بنية التعليم، فإنّ كثيرًا من الغموض والضبابيّة ما زال يلفّ طبيعة هذا التغيير واتّجاهاته.
أمّا فيما يتعلّق بدور العائلة فإنّ أثر كورونا كان أيضًا كبيرًا جدًّا، لقد نبّهتنا الجائحة من جديد إلى أهمّيّة الدور المتعاظم للأسرة في مجال التربية، وأكّدت رفضًا جديدًا لمقولة "موت العائلة لصالح مؤسّسات الرعاية الاجتماعيّة والمدرسة". لقد أكّدت الجائحة أهمّيّة العائلة وخطورة دورها في العمليّة التربويّة واستطاعت أن تحقّق نوعًا من التواصل العميق بين المدرسة والأسرة، فأصبحت الأسرة مشاركًا حيويًّا في العمليّة التربويّة، وقد تطلّب الأمر أن يمارس الآباء دور المعلّمين والمربّين، وأن يشاركوا فعليًّا في العمليّة التربويّة والتعليميّة لأطفالهم بالتعاون والتفاعل مع المعلّمين والمشرفين. ونحن على يقين أنّ هذا النوع من التعليم قد ولد بعض الصعوبات الحياتيّة للأسرة تتعلّق بالعمل والتجهيزات والظروف المحيطة بعمليّة التعليم، لكن في النهاية وضعنا كورونا في سياق تجربة جديدة يتعلّم فيها الآباء كيف يمارسون دورهم التربويّ وكيف يشاركون في مسؤوليّة تعليم أبنائهم عن قرب وبعد، وفي المسؤوليّة التربويّة لأبنائهم. وهي المشاركة التي كنّا نفتقدها قبل كورونا حيث كان الآباء يرمون بمسؤوليّتهم التعليميّة على عاتق المعلّمين والمدرسة. ويضاف إلى ذلك كلّه تمكين الآباء من تطوير خبراتهم ومعارفهم الإلكترونيّة في مجال التعليم عن بعد، وإغناء ثقافتهم الرقميّة في مختلف ميادين العمل، لأنّ هذه التجربة فرضت عليهم تنمية ثقافتهم الرقميّة وتطويرها في اتّجاهات مختلفة تحت تأثير تعاملهم مع أطفالهم، وضرورة تقديم العون لهم في دروسهم ومحاضراتهم وواجباتهم.
لقد نتج عن جائحة كورونا تقدير كبير لأهمّيّة المدرسة ودورها في حياتنا الإنسانيّة، ففي اللحظة التي وجد فيها الآباء والأمّهات أنفسهم وجهًا لوجه مع أبنائهم وأطفالهم في المنزل الذي تحوّل إلى أجواء شبيهة بالمدرسة، أدرك الآباء قيمة العمل التربويّ للمدرسة، وبدؤوا يشعرون بأهمّيّة الدور التربويّ والاجتماعيّ الذي تقوم به المدارس في مجال العناية بالأطفال. وقد ازداد شعور الأهالي بالامتنان والعرفان لدور المعلّمين، الذي لا يقدّر بثمن في تحقيق رفاهيّة الطلّاب والمجتمع في آن معًا.
أخيرًا، نقول: إنّه يجب علينا أن نبني على هذه التجربة، فكلّ صعوبة وكلّ تحدّ يواجهه الإنسان أو المجتمع ينتج عنه فوائد وخبرات جمّة، وهذه التجربة بالتأكيد ستغنّي تجاربنا ومعارفنا وخبراتنا التربويّة، وستغنّي ميدان العمل في تربية الأبناء والأطفال والناشئة، ويبنى على ذلك تطوير كبير في المناهج والطرائق التربويّة التي ستصبح أكثر فاعليّة ونشاطًا وإبداعًا في مجال التربية والتعليم عمومًا.
-
كتبت عن دور المرأة، مثلًا: كتاب الاستلاب الرمزيّ للمرأة في الخليج العربيّ. برأيك، إلى أيّ حدّ أثّر تغييب المرأة عن صنع القرارات عربيًّا في تغيير وتطوير التعليم؟ ومن ناحية أخرى كيف أثّر المنهج التعليميّ في تعميق هذه الهوّة؟
أغلب النصوص المدرسيّة تعمل على تقديم المرأة في صورتها التقليديّة أمًّا وزوجًا وطبّاخةً وخيّاطةً وحطّابةً وخدّامةً. حتّى عندما يراد للمرأة أن تقدّم بصورة فعّالة إيجابيّة، فإنّ المناهج تضعها في صورتها "المعياريّة" بوصفها ممرّضةً أو معلّمةً وسكرتيرةً ومضيفةً، وهذا يعني أنّها ما زالت تحاصَر في أدوارها التقليديّة حتّى مع مطلع الألفيّة الجديدة. ويمكن في هذا السياق ملاحظة أنّ هذا التصوير للمرأة بهذه الكيفيّة ليس أمرًا عفويًّا، بل هو مقصود موجّه أيديولوجيّ. تتعمّد نصوص القراءة إخفاء الطابع الثقافيّ والتعليميّ للمرأة، وفي كثير من الحالات تبرز جهلها وأمّيّتها. وهذه هي الصورة الاستلابيّة التي تكرّسها المدرسة على أنّها ثقافة أنثويّة اغترابيّة تقلّل من أهمّيّة المرأة ودورها في المجتمع بوصفها إنسانةً متحرّرةً خلّاقةً مبدعةً مساويةً للرجل في مختلف مجالات الحياة والوجود.
وعلى الرغم من التقدّم الكبير في تعليم المرأة ووصولها إلى مواقع متقدّمة في العمل وإدارة المجتمع، فإنّ ذلك لا يعبّر عن تحرّر حقيقيّ للمرأة. إنّ وصول مجموعة من النساء إلى قبّة البرلمان وإلى حقائب وزاريّة وإلى مقاعد الجامعة لا يعني أنّ المرأة قد حقّقت تقدّمها الإنسانيّ، وأنّها أصبحت على قدم المساواة مع الرجل. فالتحليل السوسيولوجيّ لأوضاع المرأة يؤكّد _بصورة مستمرّة_ استمرار العقليّات القديمة في التعامل مع المرأة، وفي النظر لها، وفي الدور المسند إليها.
في دائرة هذا التحليل نستطيع أن نقول: إنّ تعليم المرأة يأخذ من جهة الشكل طابعًا تحرّريًّا، لكنّه من جهة المضمون يأخذ طابع استغلال جديد لعمل المرأة وطاقاتها بوصفها قوّةً منتجةً توضع تحت سيطرة غيرها. ونخرج بنتيجة أنّ التعليم يعزّز دونيّة المرأة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا فيما لو نظرنا إلى المعيار الذي تقوم فيه المدرسة بإنتاج الصورة التقليديّة للمرأة العاجزة الضعيفة القاصر العاطفيّة، وإعادة إنتاجها.
-
أطلقتم مجلّة "نقد وتنوير" وتفاعلتم عبر المشاركة والتأسيس في كثير من المبادرات على صلة بالتعليم والتربية عربيًّا، ما الأثر الذي أحدثته هذه المبادرات، وأيّها تقاطع مع توقّعاتك؟ أيضًا ما الذي لم يتحقّق، وكنت تراه ممكنًا؟
شكرًا على الإشارة إلى مجلّتنا "نقد وتنوير" التي تأسّست بمبادرة مجموعة من المفكّرين والباحثين في العالم العربيّ في مختلف العلوم الإنسانيّة، وهي تهدف إلى ممارسة الفكر النقديّ في واقع التربية والمجتمع العربيّ المعاصر. واستطعنا مع هيئات التحرير والمساندة أن نوصل صوت التنوير إلى شريحة كبيرة من المفكّرين والطلّاب والباحثين وأن نحقّق ممارسةً نقديّةً تنويريّةً واسعةً في النظام التربويّ العربيّ وفي مقاربة مختلف الأنظمة الاجتماعيّة والسياسيّة. ونحن لا نستطيع تقدير الأثر، فالأثر الفكريّ الذي تمارسه أيّ مجلّة يصعب تحديده، وما نحن في نهاية الأمر إلّا منبر تنويريّ بين عدّة منابر فكريّة وثقافيّة عربيّة، نتمنّى أن نحقّق نجاحًا وسطها. ونحن في المجلّة لا نتبنّى تيّارات فكريّة أيديولوجيّة أو سياسيّة أو عقائديّة من أيّ نوع، ولذا فإنّ المجلّة تعتمد على نشاط هيئاتها الفكريّة والناشطين النقديّين من مختلف البلدان العربيّة. ونتوقّع في حقيقة الأمر أن تتزايد أهمّيّة المجلّة وأن يتعاظم دورها في هذا الميدان مع مرور الزمن.
-
بالحديث عن المبادرات، كيف تنظر إلى مبادرة "منهجيّات"، بصفتها مجلّةً تربويّةً عربيّةً قائمةً على مشاركة التجارب وإتاحة منصّة للتفاعل بين المعلّمين وأطراف العمليّة التربويّة جميعها؟
عندما وقعت على موقع المجلّة وأعدادها الثلاثة، كنت أكتب خاتمة كتاب ألّفته لمركز دراسات الخليج حول التعليم الإلكترونيّ عن بعد في ظلّ جائحة كورونا، ونظرًا لأهمّيّة الموضوعات التي طُرحت في المجلّة، توقّفت عن الكتابة وبدأت قراءةً شغوفةً للمقالات التي كُتبت عن هذا الموضوع، ومن ثمّ وظّفت هذه القراءة، وما فيها من أفكار جديدة ضمن كتابي. وقد أرسلت الموقع إلى زملاء لي يعملون على هذا الموضوع، وشكّلت هذه الأعداد مصدرًا للبحث والدرس حول كورونا. ومرّرت موقع المجلّة لطلّاب الدراسات العليا والماجستير للإفادة أيضًا. ودون مجاملة، يشكّل الموقع منبرًا تربويًّا نقديًّا مضيئًا في مجال المعرفة التربويّة، وسيكون له باعتقادي في المستقبل شأن كبير في مجال معرفة تربويّة تنويريّة غير تقليديّة مؤمنة بالمستقبل في العالم العربيّ.













 نشر في عدد (4) ربيع 2021
نشر في عدد (4) ربيع 2021