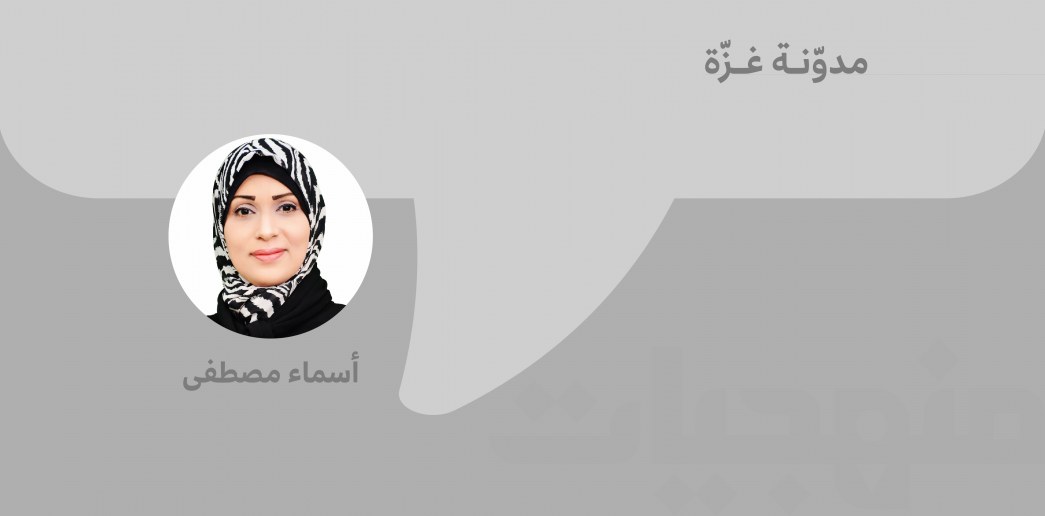لم تكن المدرسة مجرّد جدران تلمّ شمل التلاميذ، بل كانت بيتًا آخر لأطفال غزّة. لكنّ الحرب حوّلت كلّ شيء إلى أطلال، وصار الطريق إلى الفصل ممزوجًا برائحة البارود وغبار الإسمنت المتناثر. أمام بوّابة حديديّة ملتوية بفعل القصف، جلس عدد من الأطفال يرقبون بقايا سبّورة مائلة، نصفها مكسور والآخر مغطًى بطبقة سميكة من الغبار.
دخلت المعلّمة المبادِرة، آلاء، بخطوات بطيئة إلى نقطتها التعليميّة التي أطلقت عليها "مدرسة الأمل". تحمل في يدها بعض الأوراق الممزّقة التي جمعتها من بيتها قبل أن يُقصف. توقّفت لحظة عند العتبة، تنظر حولها: المقاعد محطّمة، النوافذ بلا زجاج، الهواء محمّل برائحة الاحتراق. ومع ذلك، ابتسمت وهي تقول بصوت حاولت أن تجعله واثقًا: "صباح الخير يا حلوين". كانت عيونهم تردّ التحية قبل ألسنتهم، لتقول: "لو لم يبق لنا شيءٌ سوى التراب، سنبقى هنا، وسنتعلّم".
في مدرسة "الأمل" يجلس التلاميذ متقاربين على الأرض. بعضهم أحضر كراتين فارغة لتكون دفاتر مؤقّتة، وعددٌ قليلٌ اجتهد في شراء دفتر صغير وقلم. لم يكن هناك جرسٌ لبدء الحصّة، بل كان صوت العصافير المتبقية في محيط الركام، هو الإشارة الوحيدة بأنّ الأطفال هُنا على موعدٍ مع يوم جديد، ودرسٍ جديد.
رفع طفل صغير يده بخجل، سألها: "مس، ممكن أحكي لك شو حلمت الليلة الماضية؟" ابتسمت آلاء، وسألته "ماذا رأيت يا آدم؟" قال إنّه رأى نفسه يسير بين زملائه في المدرسة، يرتدي الزيّ المدرسيّ، ويعيش يومًا من أيّام الحياة اليوميّة الطبيعيّة. قامت المعلّمة بعدها برسم نصف دائرة بيضاء على ما تبقى من سبّورتها المحروقة وقالت: "الأحلام درسنا الأوّل، اكتبوا ما تتمنّون".
بدأ الأطفال يخطّون كلمات مبعثرة: "أريد بيتًا جديدًا"؛ "أريد أن ترجع أمّي إلى الحياة"؛ "أريد أن أكون طبيبًا أعالج الجرحى"؛ "أريد أن ألعب في حديقة منزلي". وبينما كانت الكلمات تتناثر على الكرتون والحجارة، بدا الفصل وكأنّه يستعيد شيئًا من روحه القديمة، تلك الروح التي قاومت الموت كي تمنح الصغار نافذة صغيرة على الحياة.
في تلك اللحظة، أيقنت المعلّمة أنّ غزّة ستظلّ تكتب حتّى تحقّق أحلامها.
المعلّمون جنود من نوع آخر
في صباح بارد، قبل أن تشرق الشمس تمامًا، خرج الأستاذ فؤاد من خيمته المؤقّتة في مخيّم نزوحه في وسط قطاع غزّة. كان يحمل في يده حقيبة جلديّة قديمة نجت من تحت أنقاض بيته، بداخلها بقايا طباشير وقلمٌ وبعض الأوراق. سار على قدميه أكثر من ثلاثة كيلومترات وسط طرق مليئة بالحُفر والركام، ليصل إلى النقطة التعليميّة التي لا تشبه المدرسة بالمعنى التقليديّ في شيء، بل جدران وُضِعَ "شادر" بلاستيكيّ ليكونَ للأطفال سقفًا يحميهم من زخّات المطر إن تساقط. نصف البناية مهدّم وفناءٌ صغيرٌ أمامها فارغ بلا مقاعد.
وعندما وصل، وجد مجموعة من الأطفال ينتظرونه خارج حدود المكان، "تأخّرت يا أستاذ، اشتقنالك". لم يكن بينهم من يرتدي زيًّا مدرسيًّا، ولا معه حقائب ملوّنة، كما اعتاد في سنوات ما قبل الحرب. كانوا يلبسون ملابس شتويّة أغلبها بالٍ، تبرّعت بها بعض الجمعيّات الخيريّة. وحملوا في أيديهم كراتين أو ألواح خشبيّة صغيرة للكتابة عليها. يقول الطفل إسلام: "أخذت كرتونتي خلسةً من بين كراتين جمعتها أمّي لتشعل نارًا للطهو اليوم". ابتسم الأستاذ فؤاد على الرغم من التعب، وقال: "صباح الخير يا أبطال، اليوم عندنا درس جديد".
لم تكن لديه سبّورة كاملة، فأكمل كتابة المعادلة الرياضيّة على الحائط المحروق المكمّل للسبّورة، ثمّ التفت إلى طلّابه ليشرحها وكأنّ شيئًا حوله لم يحدث. كان يرفع صوته أحيانًا ليغطي على أصوات الطائرات التي تحلّق في السماء، أو على هدير طيرانٍ حربي يهوّم فوق رؤوس الأطفال على ارتفاع منخفض. ومع كلّ صوت مدوٍّ، ينكمش الأطفال لحظة، ثمّ يعيدون عيونهم إلى معلّمهم، كأنّهم يستمدّون منه شجاعة للاستمرار وأمانًا للبقاء.
المعلّمة ليلى، هي الأخرى، استطاعت بجهدٍ عزيزٍ أن تحوّل ركنًا صغيرًا من مركز إيواء تنزح فيه، إلى ما يشبه الفصل الدراسيّ. لم يكن لديها سوى دفتر واحد وقلم، فكانت تكتب الأسئلة بيدها على الأوراق كافّة، وتقوم بتوزيعها على الطلّاب لتقوم بالشرح والتوضيح. ولأنّها فقدت منزلها وزوجها في القصف، كان البعض يتوقّع أن تنهار، لكنّها كانت تقول دائمًا: "أنا هنا كي لا ينهار أطفالكم".
في كلّ حصّة، كان المعلّمون يواجهون تحدّيات مضاعفة: كيف يدرّسون المنهاج وسط انقطاع الكهرباء وغياب الكتب؟ وأيّ نوعٍ من المناهج يدرّسون؟ وكيف يحمون صغارهم من الانهيار النفسيّ وهم أنفسهم مثقلون بالجراح؟ كانوا يبتكرون طرقًا بسيطة وأحيانًا بدائيّة لكنّها ملهمة: يرسمون الخرائط بالتراب، ويكتبون الحروف على ألواح خشبيّة متكسّرة، ويحوّلون أغاني الأطفال البسيطة إلى دروس في اللغة والرياضيّات.
ومن بين تلك القصص، تبقى حكاية المعلّمة "أسماء شتات" واحدة من أكثر الحكايات إلهامًا، حيث اعتقلها جيش الاحتلال لشهورٍ طويلة، وتعرّضت فيها إلى القهر والعتمة والجوع. لكنّهم لم يستطيعوا أن يسلبوا منها إيمانها برسالتها. عندما أُطلق سراحها، لم تكن الراحة أوّل ما فكرت فيه، بل أن تذهب إلى مدرستها. في صباح اليوم التالي مباشرة، حملت حقيبتها البالية، وتوجّهت بخطوات ثابتة نحو مدرستها التي نجت جزئيًّا من القصف، وتحوّل نصفها الآخر إلى مركز إيواء للنازحين. استقبلتها زميلاتها بدموع الفرحة؛ فرحة بفكّ القيد، وأخرى بقدومها مباشرةً إلى المدرسة. كما استقبلتها الطالبات بدهشة ممزوجة بالفرح، ولم يصدّقن أنّ معلّمتهنّ التي سمعنَ أنّها أسيرة، قد عادت إليهنّ. حين وقفت أمام السبّورة المائلة، قالت بصوت متهدّج لكنّه مفعم بالقوّة: "كنتُ على يقينٍ من أنّني سأقف هنا مرّةً أخرى، أنا هنا لأكمل الدرس".
أولئك المعلّمون يشبهون أشجار الزيتون العتيقة: قد تُحرق أوراقها وتُكسر أغصانها، لكنّها تبقى ضاربة بجذورها في الأرض. إنّهم يعلّمون مع أنّ الجدران تهدّمت، يبتسمون مع أنّ قلوبهم تنزف، ويصرّون على أن يبقى التعليم نارَ سلامٍ لا تنطفئ وسط الظلام.
والأطفال... أبطال على الرغم من الجراح
وفي ظلّ حرب الإبادة كانت الطريق إلى المدرسة مغامرة يوميّة، يختلط فيها الخوف بالأمل. لم يعد الأطفال في غزّة يرتدون زيّهم المدرسيّ النظيف، أو يحملون حقائب ملوّنة كما كانوا من قبل، بل صاروا يشقّون طريقهم عبر الركام والطرقات المهدّمة، يحمل كلّ منهم قلمًا أو دفترًا متهالكًا كأنّه سلاحه الشخصيّ.
معتز، طفل في الصفّ الخامس، فقد بيته وكلّ كتبه. في إحدى المرّات، عَثر على قلم رصاص قرب أنقاض منزله، التقطه ومسحه بيده كأنّه وجد كنزًا. ومنذ ذلك اليوم، صار لا يفارقه أبدًا، يضعه في جيبه أثناء النوم ويُخرج منه كلّ ما تبقى له من أحلام. حين وصل إلى الفصل، جلس على الأرض ورسم بالقلم نفسه كلمة "غزّة" على كرتونة قديمة.
سندس، طفلة في الصفّ الرابع، حضرت درس الرياضيّات مع أنّها لم تنم ليلتها بسبب القصف المتواصل. كانت عيناها مثقلتين بالتعب، ومع ذلك أبقت يدها مرفوعة طوال الحصّة. حين سألها المعلّم لماذا تصرّ على المشاركة، قالت: "لأنّ صوتي يجب أن يبقى عاليًا، أعلى من أصوات القصف".
أمّا يوسف، فقد كان يحفظ دروسه على ضوء شمعة صغيرة، بعد أن فقد الكهرباء منذ سنوات. وعندما دخل الصفّ وطلب منه المعلّم قراءة نصّ قصير، قرأه بإتقان. يوسف أدهش الجميع حقًّا.
إسراء، طفلة من مخيّم جباليا في نزوحها قبل الأخير منه، كانت تستيقظ مع الفجر، تودّع أمّها بخوف، وتسير مع صديقاتها نحو النقطة التعليميّة في مدرسة شبه مدمرة. في الطريق، كان عليهنّ الالتفاف حول حفرة كبيرة أحدثها صاروخ، ثمّ أن يقطعن مسافة طويلة على أقدامهنّ. وعندما وصلن أخيرًا، استقبلتهنّ المعلّمة صابرين بابتسامة دافئة، وقالت: "أنتنّ اليوم بطلات… وصولكنّ وحده إنجازٌ عظيم".
في كلّ صباح، كان مشهد هؤلاء الأطفال وهم يتجمّعون حول معلّميهم وسط الركام يبعث على الدهشة. بعضهم يكتب على بقايا أوراق وكتب، وبعضهم يحاول المشاركة بدفتر ممزّق بين اثنين أو ثلاثة. ومع هذا كله، كان في عيونهم بريق غريب: خليط من العناد والبراءة، وكأنّهم يتحدّون العالم بأنّهم سيبقون طلّابَ علمٍ حتّى الرمق الأخير، مهما حدث.
النقاط التعليميّة في غزّة مساحة أمل وامتداد حلم
في غزّة، الفصل الدراسيّ لم يعد جدرانًا وأبوابًا، بل أصبح مساحة مقدّسة يقيمها الأطفال ومعلّموهم فوق أنقاض الخراب. لم يكن مكانًا يقتصر على الطباشير والكتب، بل هو مكانٌ مكتنزٌ بالإصرار والعزم على أن يبقى الحلم حيًّا ممتدًّا عبر الأجيال.
في إحدى مدارس النصيرات التي تحوّل نصفها إلى ركام، قرّر المعلّمون والأطفال أن يخصّصوا زاوية صغيرة من الفناء لدرس الصباح، سقفها سماءُ غزّة الممتلئ بأسراب الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، وأرضها مفرشٌ صغير "حصيرة". ومع ذلك، حين يقف الأطفال تجدهم يقفون بانتظام الصفّ الواحد، يردّدون النشيد الوطنيّ، مشهدٌ مهيب يبدو وكأنّهم يشيّدون وطنًا كاملًا بأصواتهم.
الطفلة مريم، حملت علمًا ممزّقًا عثرت عليه بين بقايا مدرسة أخرى. خاطته أمّها بخيوط بيضاء، وجاءت به كلّ صباح لترفعه في بداية الحصّة. حين سألها زميلها لماذا تصرّ على حمله على الرغم من تمزّقه، أجابت: "حتّى لو هو مقطّع… بيرفرف".
وفي لحظات الصمت، كان المعلّمون يعملون بكلّ جهدٍ وعزيمةٍ وأمل على تحويل الفصل إلى مساحة للتنفّس. إحدى المعلّمات طلبت من الأطفال أن يرسموا ما يتمنّونه بعد الحرب. رسم بعضهم بيتًا بحديقة، وآخرون رسموا كتبًا ودفاتر، أحدهم رسم سيارته المستقبليّة، وإحداهنّ رسمت فراشة ملوّنة بألوان زاهية تحيّي الأمل من جديد. لكن طفلًا صغيرًا رسم حمامة تطير فوق بحر غزّة. نظر إليها وقال: "هذه مش حمامة… هذه أنا".
أحيانًا، كانت الحصص تتحوّل إلى جلسات حكاية. يروي الأطفال ما فقدوه، من بيوت وأصدقاء وألعاب، ثمّ يسألهم المعلّم: "طيّب… شو عندكم الآن؟" فيبدأ أحدهم: "عندي خيمة، عندي قلم، عندي أمّي، عندي أمل"، وآخر يقول: "عندي صوتي"، وثالث: "عندي أنتم".
حتّى ضحكات الأطفال شكّلت فعلًا مقاومًا. ففي يومٍ ممطر، تسرّبت المياه إلى خيام النازحين، كما تسرّبت إلى الفصل المكشوف، فانشغل الأطفال بجمعها في علب فارغة. كان المشهد مأساويًّا بالفعل، لكنّ أحد الاطفال قفز فجأة وسط الماء وبدأ يضحك. تبعه آخرون، فامتلأ الركام بالضحكات. عندها قالت المعلّمة بصوت مرتجف: "أنتم أقوى من كلّ شيء… أنتم الحياة".
لم تكن مجرّد نقاط تعليميّة، بل كانت نوافذَ أمل، وملاذًا يواجه فيه الأطفال وحشيّة الحرب بأقلام صغيرة وأناشيد بريئة.
بعد أن كتبت هذه السطور، أدركت أنّني لا أكتب عن الآخرين فقط، بل أكتب عن نفسي أيضًا. عن رحلتي التي حملتني بين عشرة نزوحات، من خيمة إلى أخرى، ومن مدرسة مهدّمة إلى ساحة مؤقّتة. لم يكن النزوح يطفئ رسالتي، بل كان يضاعفها ويزيدها إصرارً وأملًا. في كلّ مكان وصلت إليه كنت أبحث عن الأطفال، أجمعهم حولي، وأفتح لهم نافذة صغيرة على الحياة، وسط هذا الخراب.
لم تكن معي سبّورة ثابتة، ولا أقلام تكفي. لكن كان معي إيمان بأنّ التعليم هو الأمان الأخير الذي لا يمكن أن يسقط بالقصف. كتبت على سبّورةٍ صغيرة أحيانًا، وعلى الكرتون أحيانًا أخرى، وكنت أرى في عيون الأطفال أنّ الحرف البسيط قد يكون طوق نجاة، وأنّ الدرس الصغير قد يرمّم قلبًا مكسورًا، بل ويعيد بناء الوطن.
لهذا، حين أكتب عن فصول غزّة المحترقة، فإنّني لا أكتب فقط شهادة، بل أدوّن مقاومة يوميّة عشتها مع زملائي المعلّمين، ومع أبنائي الطلّاب. نحن الذين لم نملك إلّا أقلامًا نصف مكسورة، وسبّورات محترقة، وقلوبًا مفعمة بيقين أنّ الكلمة أقوى من نار الإبادة. قد تحترق جدران كافّة مدارسنا، لكنّ السبّورة التي نحملها في أرواحنا لن تنطفئ أبدًا.