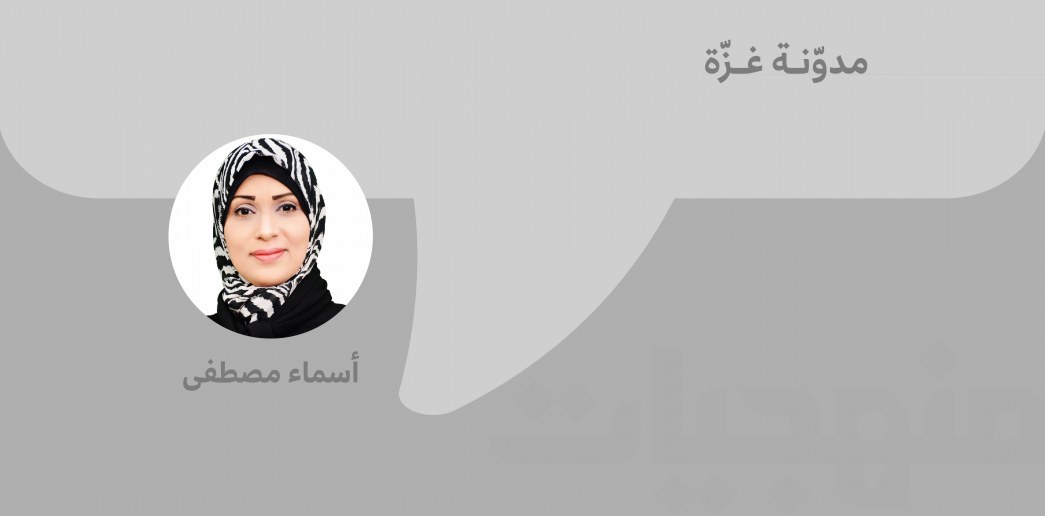في كلّ سنة، وفي العشرين من نوفمبر تحديدًا، يقف العالم ليحتفل باليوم العالميّ للطفل؛ يوم خُصِّص للتذكير بحقوقهم، ولإحياء النقاشات حول رفاههم، ولإطلاق المبادرات التي تضمن لهم بيئة آمنة وسعيدة. لكن في غزّة، لا يشبه هذا اليوم شيئًا مما يُبثّ عبر منصّات اليونيسف أو تقارير المنظّمات الدوليّة، ولا يوازي تلك الصور الملوّنة التي تُظهر أطفال العالم وهم يطلقون البالونات ويبتسمون أمام كاميرات الاحتفال.
في غزّة، يصبح هذا اليوم مرآة مؤلمة تعكس حجم الانهيار الإنسانيّ الذي أصاب الطفولة، وحجم التناقض الصارخ بين نصوص الاتفاقيّات الدوليّة وبين واقع الأطفال الذين يُقتلون ويُشرَّدون، ويُحرَمون من التعليم والغذاء والمأوى.
يأتي اليوم العالميّ للطفل هذا العام، وغزّة تعيش واحدة من أكبر الأزمات الإنسانيّة خلال العقود الأخيرة. ومع أنها أرضٌ مليئة بالأطفال — أكثر من نصف سكانها دون سن الثامنة عشرة- إلّا أنّ طفولتهم اليوم معلّقة، ومختطفة، ومُحاطة بانعدام الحماية على نحو لم يشهده العالم المعاصر. وبينما تتّجه الأنظار إلى الاحتفالات العالميّة، يبقى الطفل الغزّيّ المثال الأكثر وضوحًا على فشل المنظومة الدوليّة في حماية أضعف الفئات الإنسانيّة.
مفارقة الاحتفال العالميّ وواقع الطفولة في غزّة
بينما يكتب العالم شعارات مثل "لكلّ طفل حقّ"، ويجتمع الخبراء حول طاولات مستديرة لمناقشة تطوير التعليم أو زيادة فرص اللعب، يعيش الطفل الفلسطينيّ في غزّة واقعًا نقيضًا تمامًا.
فالمعايير العالميّة التي وُضعت لحماية الأطفال، مثل اتّفاقيّة حقوق الطفل ( CRC) التي صادقت عليها معظم دول العالم، تنص على حقوق أساسيّة: الحقّ في الحياة والبقاء والنموّ، والحماية من العنف، والتعليم والغذاء والصحّة واللعب والهويّة، والبيئة الآمنة.
وتُظهر القراءة الدقيقة لتفاصيل الحياة اليوميّة في غزّة أنّ جميع الحقوق الأساسيّة للطفل تتعرّض لانهيار ممنهج وشامل. فالأمن الشخصيّ غائب، والبيئة الآمنة التي يفترض أن تحتضن نموّ الطفل باتت مجرّد ذكرى. والتعليم الذي يشكّل بوابة المستقبل مهدّد بالتوقّف الكامل، أو هو انهار بالفعل. أمّا الغذاء، وهو الحدّ الأدنى من متطلّبات البقاء، فلم يعد متوفّرًا على نحو ثابت أو كافٍ يضمن الصحّة والنمو. والمأوى الذي يوفّر الاستقرار تحوّل إلى ركام، في ظلّ دمار واسع للبيوت والملاجئ. وانهيار الخدمات الصحيّة جعل المرض والإصابة أخطر من القصف ذاته. كما غاب اللعب، وهو حقّ أساسيّ في تشكيل شخصيّة الطفل وصحّته العاطفيّة، وتفاقمت الأخطار التي تتهدّد الصحّة النفسيّة، حيث يعيش الأطفال مستويات غير مسبوقة من الصدمات والخوف المستمرّ. وفوق كلّ ذلك، يبقى حقّ الحياة نفسه غير مضمون، في واقع يكشف انهيارًا كاملًا لمنظومة الحماية الإنسانيّة.
هذه المفارقة تثير أسئلة مهنيّّة ضروريّة:
ما جدوى توصيات الأمم المتّحدة إذا كانت عاجزة عن حماية طفل واحد داخل خيمة قُصفت؟
ما معنى نشر تقارير “التقدّم العالميّ في حقوق الطفل” بينما الأطفال في غزّة يعيشون كارثة تراكميّة تُفقدهم كلّ مقومات النمو السليم؟
وهل يمكن لليوم العالميّ للطفل أن يبقى يومًا احتفاليًّا بينما جزء من أطفال العالم يُبادون بشكل ممنهج؟
الطفل الغزّي في سياق الانهيار الإنسانيّ:
أوّلًا: الحقّ في البقاء والحماية… التهديد الوجوديّ الأكبر
يُعدّ حقّ الطفل في الحياة والحماية الركيزة الأولى التي أرستها الاتّفاقيّات الدوليّة، غير أنّ واقع غزّة يقدّم صورة نقيضة تمامًا لهذه المبادئ. فالطفل الغزّيّ يعيش في بيئة تُعدّ الأكثر خطورة على وجوده الجسديّ والنفسيّ، حيث يتشكّل يومه ضمن دائرة من القصف المستمرّ، وانعدام الأمن، والتعرّض إلى العنف المباشر، وفقدان الأسرة أو أحد أفرادها. وتُضاعف الإصابات الجسديّة غير المعالَجة انكشافه امام الخطر، في ظلّ انهيار المنظومة الصحّيّة، فيما يضطرّ إلى الوقوف لساعات طويلة في طوابير الماء والطعام كجزء من “روتين” البقاء. تضاف إلى ذلك احتماليّة الإصابة بالأمراض من دون أيّ رعاية، ما يجعل الطفل في غزّة أمام سلسلة من التهديدات الوجوديّة المتلاحقة. ليست هذه الانتهاكات حالات فرديّة أو طارئة، بل تعكس منهج انهيار شاملًا لكلّ نظام يفترض أن يحمي الطفولة ويصون حقّها الأول: الحقّ في الحياة.
ثانياً: الحقّ في التعليم… من مقاعد الدراسة إلى ساحات النزوح
كان التعليم أحد أهمّ مصادر الأمل للأطفال في غزّة على رغم سنوات الحصار الطويلة، غير أنّ الحرب الأخيرة أطاحت بهذا الركن الأساسيّ من حياة الصغار. فقد تحوّلت آلاف المدارس إلى أنقاض أو ملاجئ مكتظّة، وفقد الأطفال ملايين الساعات التعليميّة التي لا يمكن تعويضها بسهولة. يعيش أطفال كثر اليوم بلا مناهج، بلا دفاتر، بلا بيئة صفّيّة، وبلا معلّمين قادرين على العمل بأمان. كما يستحيل تطبيق التعليم الإلكترونيّ مع انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، في ظلّ محاولات يائسة للطلّاب لإكمال دراستهم على ضوء الهاتف أو البلاستيك المحترق. لقد تخطّى الوضع حدود “تعطّل التعليم” ليصبح تهديدًا مباشرًا لبنية الوعي والمعرفة والمهارات المستقبليّة. التعليم في غزّة لم يعد حقًّا يحتاج إلى الدعم، بل أصبح حالة طارئة تستوجب تدخّلًا دوليًّا عاجلًا لإنقاذ جيل كامل من السقوط في فجوة مستقبليّة عميقة.
ثالثاً: الأمن الغذائيّ… طفولة تنمو في ظلّ الجوع
يُشكّل الجوع أحد أخطر الأزمات التي تواجه الأطفال في غزّة، إذ تُظهر المؤشّرات أنّ النقص الحادّ في الغذاء بات جزءًا من الحياة اليوميّة للصغار. فغياب التغذية السليمة يؤدّي إلى توقف النموّ الطبيعيّ، وضعف المناعة، وتراجع القدرة على التركيز، وإعاقة التطوّر المعرفيّ، فضلًا عن زيادة قابليّة الإصابة بالأمراض. يعيش كثير من الأطفال على وجبة واحدة بسيطة في اليوم، بينما ينام آخرون بلا عشاء، ويكتفي بعضهم بالخبز والماء لفترات طويلة. الجوع هنا ليس ظرفًا عابرًا، بل بنية قاسية تؤثّر في الجسد والعقل والنفس معًا، وتخلّف آثارًا ممتدّة قد تلازم الطفل مدى حياته. استمرار هذا الوضع يعني أنّ الطفولة في غزّة تكبر وهي تُصارع الجوع قبل أيّ شيء آخر.
رابعاً: الصحّة النفسيّة… طفولة مثخنة بالصدمة
لا يمكن تناول واقع الطفولة في غزّة من دون الوقوف أمام الانهيار النفسيّ العميق الذي يعيشه الأطفال نتيجة الحرب. فقد خلّفت التجارب القاسية مستويات غير مسبوقة من الصدمة، تجلّت في كوابيس متكرّرة، وتبوّل لا إراديّ، وصمت مفاجئ، ونوبات بكاء، وفقدان الثقة، وشعور دائم بالخوف، واضطراب التعلّق، إضافة إلى الإحساس المستمرّ بانعدام الأمان. كما يبرز النضج المبكرّ القسريّ لدى كثير من الأطفال الذين اضطرّوا إلى تقمّص أدوار تفوق أعمارهم، فيما تظهر مؤشّرات اكتئاب الأطفال وفقدان القدرة على اللعب أو التفاعل. هذه الأعراض ليست ردود فعل مؤقّتة، بل مسارات ممتدّة قد تظلّ حاضرة لسنوات طويلة. ووفق المعايير المهنيّة، يحتاج هؤلاء الأطفال إلى برامج دعم نفسيّ مستمرّ، ومساحات آمنة للعب، وإعادة بناء الروتين، إلى جانب وجود بالغين داعمين. لكنّ غزّة تفتقر إلى كلّ هذه العناصر، ما يجعل الأثر النفسيّ للحرب هو الأكثر رسوخًا في ذاكرة الطفولة ومستقبلها.
خامساً: الحقّ في اللعب… الرفاه الذي أصبح حلمًا بعيدًا
اللعب ليس ترفًا في حياة الطفل، بل عنصرًا جوهريًّا في نموّه المعرفيّ والاجتماعيّ والنفسيّ. غير أنّ أطفال غزّة محرومون اليوم من هذا الحقّ الأساسيّ، فالمساحات الآمنة للّعب تكاد تكون معدومة، والمحيط تغلب عليه الأخطار، وألعاب الأطفال إمّا مكسورة أو مطمورة تحت الأنقاض. يعيش هؤلاء الصغار بلا فرص للمتعة أو الترفيه، وقد استُبدل اللعب بأدوار مرتبطة بالبقاء مثل جمع الماء أو الوقوف في الطوابير. هذا الانقطاع الحادّ عن اللعب يوقّف جزءًا مهمًّا من نموّ الدماغ، ويقيّد مهارات التفاعل الاجتماعيّ، ويعزّز الإحساس بالتهديد المستمرّ. بذلك، يتحوّل اللعب من نشاط يوميّ طبيعيّ إلى رفاهٍ مفقود، تستحيل ممارسته في ظلّ بيئة غير آمنة.
إعادة تعريف الطفولة في غزّة… من طفولة النموّ إلى طفولة الصمود
تحليل واقع الطفل الغزّيّ يضعنا أمام حقيقة قاسية: الطفولة كما يعرفها العالم لم تعد موجودة في غزّة. فقد بات الطفل شاهدًا على الدمار، وحاملًا لهمّ النجاة، ومشاركًا في تدبير تفاصيل حياة النزوح، وراشدًا قبل أوانه بفعل المسؤولياّت المفروضة عليه. أصبح الطفل مكلَّفًا بأدوار تفوق طاقته، فاقدًا المكان والروتين واليقين الذي يُشكّل أساس الشعور بالأمان. وهذه التحوّلات العميقة تنقل الطفل من “مرحلة النموّ الطبيعيّ” إلى ما يمكن تسميته طفولة الصمود، أي الطفولة التي تُبنى على النجاة وتحمّل الأعباء بدل اللعب والتعليم والطمأنينة. الطفل هنا لا يمارس حقوقه، بل يواجه الظروف بقوة اضطراريّة كي يبقى على قيد الحياة.
توصيات مهنيّة لإنقاذ الطفولة في غزّة
إنقاذ الطفولة في غزّة لم يعد ترفًا فكريًّا، ولا بندًا إنسانيًّا يُدرج في تقارير المؤسّسات، بل أصبح ضرورة وجوديّة تتطلّب إعادة بناء جذريّة لأنظمة الحماية والرعاية. تبدأ هذه العمليّة من إعادة تشكيل نظام حماية متكامل للأطفال، يضمن لهم بيئات آمنة تتوفّر فيها المساحات الصديقة، وتُفعَّل ضمنها منظومة استجابة نفسيّة عاجلة قادرة على التعامل مع الصدمات المستمرّة. فالأطفال لم يعودوا بحاجة إلى برامج شكليّة، بل إلى بنية واقعيّة تحمي حياتهم من الخطر المباشر والمتكرّر.
وفي المسار نفسه، تبدو إعادة ترميم النظام التعليميّ مهمّة عاجلة لا تحتمل التأجيل، إذ ينبغي توفير مدارس مؤقّتة آمنة تتناسب مع ظروف الطوارئ، إلى جانب دعم المعلّمين الذين يعملون في أقسى الظروف، وإمدادهم بخطط تعليم مرنة وموادّ بديلة تساعدهم على ضمان استمراريّة العمليّة التعليميّة. التعليم هنا ليس مجرّد حقّ، بل هو آخر خيط يربط الأطفال بملامح المستقبل.
أمّا الصدمة النفسيّة التي يعيشها أطفال غزّة، فهي جرح مفتوح يحتاج إلى برامج دعم متخصّص تُبنى بجديّة واحتراف. ويتطلّب ذلك تدريبًا نوعيًا للميسّرين والمعلّمين على التعامل مع الصدمات، ودمج أساليب التفريغ النفسيّ ضمن العمليّة التعليميّة اليوميّة، بحيث يصبح الدعم النفسيّ جزءًا من روتين التعافي، وليس نشاطًا ثانويًّا.
ولا يمكن لأيّ إصلاح أن يتحقّق من دون تعزيز الأمن الغذائيّ والصحيّ للأطفال، عبر خطط تغذية طارئة تضمن الحدّ الأدنى من الاحتياجات، وحملات تطعيم واسعة تعالج الانقطاع الطويل للخدمات الصحيّة، إضافة إلى فتح ممرّات طبّيّة آمنة تسمح بوصول العلاج بلا عوائق. فالجوع والمرض يحاصران الطفولة كما تحاصرها الحرب، ولا يمكن الحديث عن حماية من دون ضمان أبسط مقوّمات البقاء.
ويتطلّب المشهد أيضًا انخراطًا فاعلًا ومسؤولًا من المجتمع الدوليّ، يتجاوز حدود البيانات والمواقف الرمزيّة، إلى الضغط الحقيقيّ لوقف استهداف المدنيين، وتفعيل أدوات الحماية القانونيّة للأطفال وفق القانون الدوليّ، ودعم آليّات المساءلة لضمان عدم إفلات الانتهاكات من العقاب. فالأطفال هم الحلقة الأضعف، وأيّ صمت على استهدافهم شراكة في الجريمة.
اليوم العالميّ للطفل يبدأ من غزّة
الحديث عن اليوم العالميّ للطفل يفقد معناه حين يُستثنى منه أطفال غزّة. فأيّ احتفال يتجاهل أنّ غزّة اليوم هي البقعة الأكثر إلحاحًا للدفاع عن الطفولة، يتحوّل إلى ممارسة فارغة من الأخلاق والإنسانيّة. أطفال غزّة لم يطلبوا الكثير: طلبوا قليلًا من الأمان؛ صفًّا دراسيًّا يحمل ملامح المدرسة؛ لعبة صغيرة؛ سقفًا يحميهم؛ نومًا هادئًا؛ ووجبة دافئة. لكنّهم وجدوا أنفسهم أمام جوع وقصف وتهجير وصدمة تتجاوز قدرتهم وأعمارهم.
في هذا اليوم العالميّ المخصّص للطفل، يصبح لزامًا على العالم أن ينتقل من الوعود إلى الأفعال. وعلى المؤسّسات الدوليّة أن تدرك أنّ حماية الطفل ليست شعارًا ولا امتيازًا، بل واجب أخلاقيّ وإنسانيّ لا يحتمل التأجيل. فالمستقبل المستدام يبدأ من حماية الأطفال ، وبالتحديد ، أطفال غزّة، الذين يرسمون بخوفهم وصمودهم ملامح الحقيقة الأكثر إيلامًا.
هذا اليوم يجب أن يُقرأ من غزّة أوّلًا؛ لأنّها تمثّل الاختبار الحقيقيّ لميزان الإنسانيّة. فإذا لم تُحمَ طفولتها، فلا معنى لأيّ احتفال في أيّ مكان آخر.