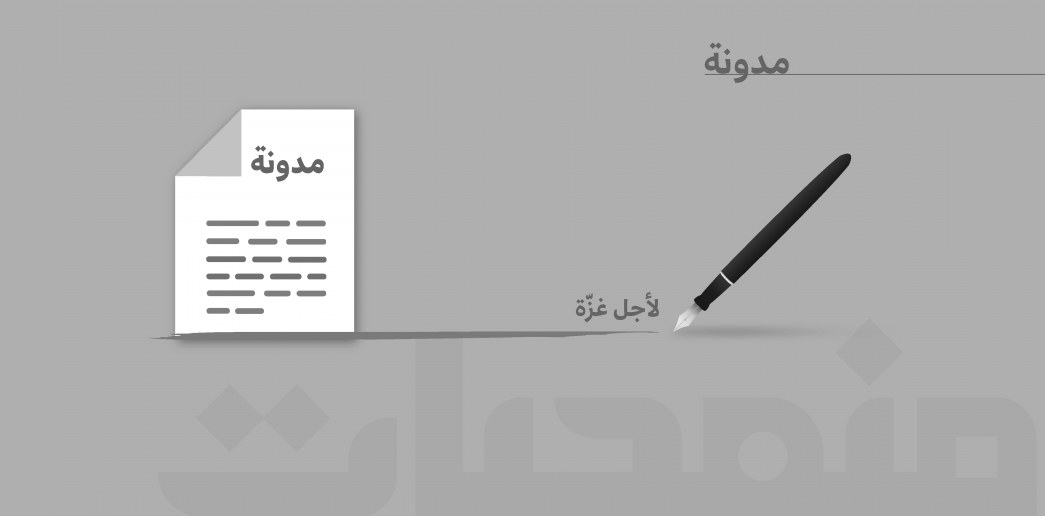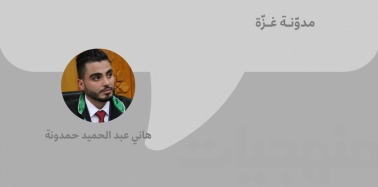ما يزال التعليم في قطاع غزّة متوقّف بالكامل جرّاء الحرب على غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وما يزال الطفل الفلسطينيّ يُحرم من أبسط حقّ من حقوقه في الحياة، التعليم. من غير تناسي حرمانه من حقّه في الأمان، وحقّه في الحياة، وحقّه في الغذاء والعلاج واللعب. ثمّة أمور تحدث من حولي تجعلني أعيد النظر في محاولاتي البسيطة من أجل هؤلاء الأطفال، في كلّ مكان أنزح إليه بين حين وآخر.
هنا خيمتي التي أقيم فيها بعد نزوحي إلى منطقة مواصي رفح، بالقرب من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزّة والشقيقة مصر. هنا، نزحت منذ مطلع عام 2024 حتّى الآن. وبين ما يزيد على مائتيّ ألف خيمة، يقيم مئات الآلاف من الأطفال من فئات عمريّة مختلفة، أغلبهم ما بين الخمسة سنوات والعشرة، يذهب وقتهم هباءً، وتضيع أعمارهم سدى. كنتُ إذا رأيت أحدهم، أمعنت النظر إليه لأتبسّم في وجهه، وأخبّئ الحسرة في قلبي. لطالما اعتقدت أنّ الابتسامة بيننا مفتاح التواصل، كي أتمكّن من التحدّث إليهم، ولا سيّما أنّهم يعيشون أصعب أيّام حياتهم، وأغلبهم وصل به الحال إلى فقدانه الرغبة بالكلام مطلقًا.
استغرق الأمر أسبوعين كي أنشئ علاقة معلّم بطلّابه، وفي الوقت ذاته علاقة أمّ بأبنائها، كنت قريبة منهم جدًّا، إلى الحدّ الذي يمكّنني من أن أروي لهم كلّ يوم قصّة، تمنحهم درسًا في الحياة، ويتعلّمون منها مبدأ وقيمة ذات فائدة، ويستطيعون روايتها لعائلاتهم وذويهم داخل الخيمة. كنت أبادرُ في ردّ التحيّة عليهم، وأتعرّف إلى ذويهم، خصوصًا أمّهاتهم، لبناء جسرٍ متين من التواصل الاجتماعيّ بيننا في الخيام، أستطيع من خلاله تكوين مجموعة متجانسة من الأطفال، متقاربين في العمر نوعًا ما، لأقدّم إليهم ما حُرِموا منه منذ أربعة شهور بالتمام والكمال قدر الاستطاعة.
ومع مرور الوقت، أصبحتُ صديقةً لأكثر من ستّين طفلة، لكل واحدة منهنّ قصّة من القهر والألم، ترويها لنا عندما نلتقي على تلّة صغيرة في العراء. كنتُ أشاركهم قصصهم، ومن ثمّ أروي لهم قصّة هادئة تأخذهم إلى عالم غير عالمنا المليء بالقتل والموت والدمار. كنتُ أشعر بشغف الأطفال عند الاستماع إلى قصّتي، وألحظُ على وجوههم الشعور بالسعادة والأمل نسبيًّا.
وقبل كلّ لقاء مع أطفالي، أقوم بالتحضير مسبقًا، وكأنّني أشرح درسًا في داخل الغرف الصفّيّة، وأقوم بتجهيز الأسئلة التي سأناقشها معهم بعد الانتهاء من رواية القصّة، كي نُوزّع الهدايا على الأطفال المشاركين في المناقشة، وتقديم الإجابات الصحيحة.
هنا يجمعنا الحبّ والأمل، بين خيامنا شديدة البرودة، صغيرة الحجم، باهظة الثمن. تجمعنا المعاناة، وتُوحّدنا مرارة الفقد والوجع. تتشابه آلامنا، ونتّفق دومًا في حبّنا للحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلًا.
من بين الركام خرجنا آلاف المرّات، ونجونا، لننجح في إعادة بناء الإنسان، وإعادة تأهيله للحياة. نجحنا في نفض غبار الألم والقهر عنّا بمواساتنا بعضنا البعض، واستماعنا إلى بعضنا البعض. يُطمئنُ أحدنا الآخر بأنّ القادم لنا جميعًا أجمل ممّا مضى، وأنّ الحرب قد تصنع منّا أشخاصًا آخرين، يحبّون غزّة أكثر، ويحبّون فلسطين أكثر وأكثر... ويذودون عنها.
إنّ أعظم فائدة لعمل المعلّم هو محبّة طلّابه له، واقتدائهم به، وسؤالهم عنه إن غاب. لم أكن أعلم أنّ حالنا في غزّة سيصل إلى ما نعيشه الآن تمامًا، من تشريد وفقد ودمار، الأمر الذي يجعلني أفكّر ألف مرّة كيف يمكنني مدّ يد العون للآخرين بما أستطيع، وكيف لي أن أخفّف عنهم آلامهم وأوجاعهم، وأستثمر في عقولهم وقلوبهم وأوقاتهم. وأن أمدّ يد العون لذويهم في كيفيّة التعامل مع أطفالهم فترة الحرب على غزّة، والتي باتت تمزّق أوصالنا، وتدمّر منازلنا ومدارسنا بالكامل.
أصبحنا نبحث عن مكان يؤوينا، لا عن معلّم يعلّم أبناءنا. حربٌ ضروس، أخذت منّا كلّ شيء، إلّا الأمل الذي أراه واضحًا كالشمس في عيون أطفالنا الصغار مع كلّ لقاء في الخيمة التعليميّة.