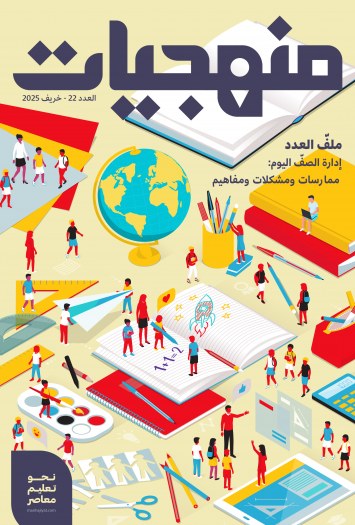في تعريف التعليم الشامل أو الجامع، لا بدّ من التمييز بين التعليمين الشموليّ والشامل: فالتعليم الشامل ترجمة Inclusion، والتعليم الشموليّ ترجمة Holistic. إذًا الحديث عن توجّهين تعليميّين مختلفين في المقاربات والاستراتيجيّات والأهداف.
في ملفّ العدد 23 من منهجيّات، نتناول موضوع التعليم الشامل، والذي يظهر من ترجمته هذه توجّهًا إلى شمول التعليم كلّ المتعلّمين الموجودين في مكان التعلّم، أكان صفًّا أم تجمّعًا في مكان مفتوح بغرض التعلّم. وهذا الكلام قد يبدو بديهيًّا إن لم نغص فيه، لأنّ الكثير من الممارسات التعليميّة، ولا سيّما تلك التي تنطلق من منهاج ثابت وموحّد لجميع المتعلّمين في مرحلة محدّدة، تتميّز بمستوى موحّد من التدريس والنشاطات والمقاربات والتوقّعات والتقييمات. وفي هذه الممارسات تحييد لمتعلّمين كثيرين موجودين في الصفّ الواحد، وهم بالطبع لن يكونوا على مستوى واحد من القدرات والأمزجة التعلّميّة والتفضيلات وغير ذلك.
التعليم الشامل الذي تطوّر من دمج المتعلّمين ذوي الصعوبات التعلّميّة، ليصل إلى شمول التعليم كلّ المتعلّمين في الصفّ على اختلافاتهم، يعني ألّا يترك متعلّم من غير تعليم يناسبه، على رغم وجود معايير ثابتة تحدّدها المناهج والكتب والموادّ التعليميّة، وذلك تحقيقًا للعدالة الحقيقيّة في التعليم؛ إذ كيف يمكن توقّع مستوىً واحد من متعلّمين مختلفي الأعمار؟ أو يأتون من بيئات اجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة مختلفة؟ كما إنّ الأمر ينطبق على المتعلّمين ذوي الصعوبات التعلّميّة في المدارس الدامجة، أي كيف يشمل التعليم في الصفّ الجميع؟
الجهود العظيمة التي يبذلها المعلّمون لكي يضمنوا حقّ كلّ متعلّم في التعليم، داخل الصفّ والمجموعة، من غير تمييزه أو عزله بوصفه "حالة فرديّة"، لا يمكن إلّا الانحناء أمامها، والتركيز على ضرورة دعم المؤسّسة التربويّة للمعلّمين في جهودهم هذه كي يجعلوا مهمّتهم أكثر سلاسة، وأقلّ إنهاكًا.
هذه الأسئلة محور ملفّنا للعدد 23 من منهجيّات، والذي يركّز على تجارب المعلّمات والمعلّمين وخبراتهم في التعامل مع تنوّع طلبتهم. وسنحبّ أن نقرأ عن هذه التجارب في واحد من المواضيع الآتية:
1. التعليم الشامل في الصفوف مختلفة الاعمار، ولا سيّما في الكثير من البيئات الريفيّة. كيف تعامل المعلّم مع هذا الواقع، وهل كانت الاستراتيجيّات والمقاربات التي استعملها مرضية له؟
2. التعليم الشامل والمناهج الثابتة: كيف تعامل المعلّم مع جمود المناهج ومخرجات التعليم، كي يشمل التعليم الجميع في الصفّ؟ وما دور الإدارة التربويّة في رفد هذه المحاولات أو إعاقتها؟
3. التعليم الشامل في الصفوف الدامجة: كيف جعل المعلّم الدمج حقيقيًّا؟ ما المصادر التي لجأ إليها لإعانته في مهمّته؟ وما دور المدرسة والمشرفين التربويّين في العمليّة؟
4. التعليم الشامل في الصفوف المتنوّعة الجنسيّات: كيف استطاع المعلّم تخطّي الفروقات اللغويّة والثقافيّة في الصفّ لإنشاء تعليم يطال الجميع؟ علامَ ركّز، وماذا استثنى؟
5. التعليم الشامل في البيئات المختلفة في المرجعيّة الثقافيّة والاقتصاديّة: كيف يمكن تطويع التعليم كي لا يستثني احدًا في المستويات والأنشطة والتوقّعات؟ ما القاسم المشترك الذي تمحور حوله التعليم؟
6. التعليم الشامل في أوقات الأزمات: كيف جرّب المعلّم تأمين تعليم شامل للمتعلّمين في أوقات الأزمات؟ وفي زمن الحرب، مثل غزّة والضفّة وجنوب لبنان، ما الممارسات التعليميّة التي هدفت إلى تأمين تعليم لطلّاب مختلفين وتحت الصدمة؟
7. ممارسات تعليميّة أمّنت العدالة في التعليم لمتعلّمين مختلفين.
وغير ذلك ممّا فاتنا من التعليم الشامل في تجارب التربويّين العرب الغنيّة، بالمعنى الإيجابيّ والسلبيّ لهذا الغنى.
سنستقبل مشاركاتكم حتّى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، على الإيميل: [email protected]