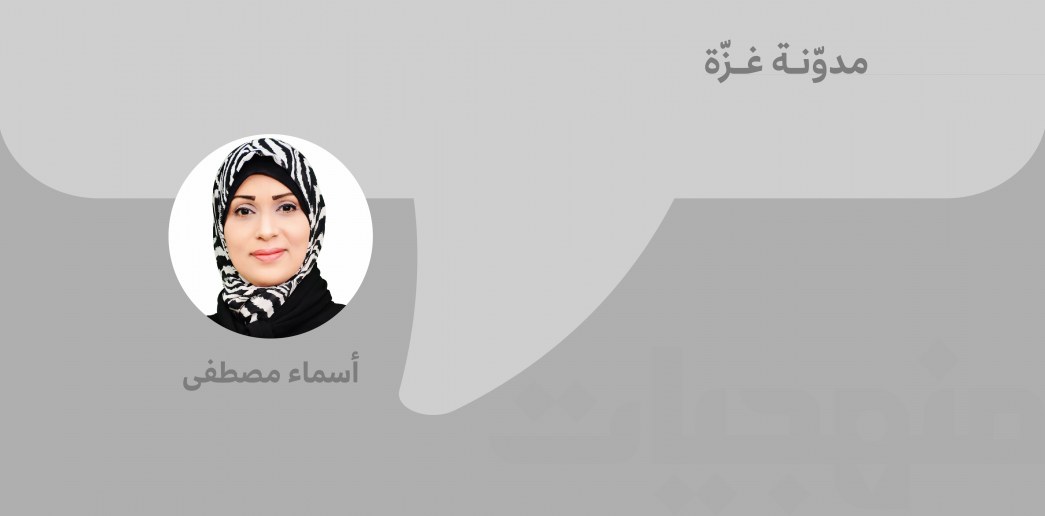من نافذة منزلي المحطّمة في مخيّم جباليا للاجئين شمال قطاع غزّة، لمحتُ جاري يزن طفلًا صغيرًا ينحني بين الركام. استوقفتني طريقته في البحث عن شيء ما، فقرّرت أن أراقبه إلى أن يجده. كانت يداه الصغيرتان تنزلقان فوق الغبار والحجارة، يقلّب القطع الثقيلة ببطء، ويمسح العرق عن جبينه بكمّ قميصه الممزّق. بدا كأنّه يبحث عن كنز دفين وسط هذا الخراب.
واصل الطفل الحفر بين الفتحات الضيّقة، يزيح حجرًا هنا وآخر هناك، كأنّ قلبه يقوده إلى شيء يعرف مكانه تمامًا بين ركام منزله. مرّت نصف ساعة وأنا أراقبه، إلى أن غلبه البكاء، وجلس على ركبتيه منهكًا، ثمّ علا صوته فجأة يصرخ، ينادي على أخيه فرِحًا:
"وليد… يا وليد! وجدتها!"
أسرع أخوه نحوه، ورأيتهما يسحبان حقيبة مدرسيّة متربة. فتحاها بحذر، فتناثرت منها كتب ودفاتر وأغراض "يزن" المدرسيّة. تجمّدت عيناي بالدمع، حين رأيت الطفل يحتضن الحقيبة بكلّ قوّته، يقبّلها باكيًا فرِحًا كما لو أنّه استعاد قلبه وطفولته وكلّ ما سُلب منه دفعة واحدة.
ذلك المشهد البسيط ليس مجرّد حكاية عابرة من بين آلاف القصص في غزّة. هو صورة مكثّفة لمعنى الفقدان؛ إذ تتحوّل الحقيبة المدرسيّة من مجرّد غرض يوميّ إلى رمز لطفولة منهوبة وأمل محاصر. فحين يحتضن الطفل حقيبة مليئة بالكتب والدفاتر، يتمسّك بآخر خيط يربطه بحياته الطبيعيّة: مدرسته، وأحلامه الصغيرة التي حوّلها الدمار إلى أنقاض.
هذا المشهد اختزل قضيّة ضياع التعليم في غزّة، والذي لم يقتصر على غياب المقاعد الدراسيّة أو إغلاق المدارس، بل امتدّ إلى عمق التجربة النفسيّة والتربويّة والاجتماعيّة للطفل. فكلّ حقيبة مفقودة تعني حلقة مقطوعة من ذاكرة جيل كامل. وكلّ كتاب مدفون تحت الركام، عنى بابًا أُغلق في وجه المعرفة. وهنا يبدأ السؤال الأكبر: ماذا يعني حرمان جيل كامل من حقّه في التعليم؟
الأثر النفسيّ والوجدانيّ: فقدان الأمان والهويّة الطفوليّة
حين يفقد الطفل مدرسته، فإنّه لا يفقد جدرانًا وصفوفًا فحسب، بل يخسر فضاءً نفسيًّا كان يوفّر له الشعور بالانتماء والاستقرار. إذ تعتبر المدرسة بالنسبة إلى الطفل أكثر من مكان للتعلّم؛ إنّها مساحة لبناء الهويّة، والتفاعل الاجتماعيّ، ولتجربةٍ أُولى مع النظام والنجاح والتقدير. في غزّة، حيث تحوّلت المدارس إلى ركام، أو ملاجئ مكتظة بالنازحين، وجد الأطفال أنفسهم محرومين من هذا الإطار النفسيّ الحامي.
ويوضّح علم النفس التربويّ أنّ الشعور بالأمان هو الشرط الأوّل لعمليّة التعلّم. أثبتت الدراسات أنّ الطفل الذي يعيش صدمات مُتكرّرة، ويرى الدمار ويختبر الفقدان، لا يستطيع أن يركّز المعلومات أو يخزّنها في ذاكرته طويلة المدى. وتُشير الأبحاث أيضًا إلى أنّ الصدمات المزمنة تؤثّر في الجهاز العصبيّ للطفل بشكل سلبيّ، فتزيد من مستويات القلق والارتباك، وتُضعف القدرة على الانتباه والتركيز، ما يجعل عمليّة التعليم شبه مستحيلة في ظلّ غياب الدعم النفسيّ.
ولا يقف الأثر عند حدود التركيز أو التحصيل الدراسيّ، بل يمتدّ إلى بناء الصورة الذاتيّة. فالطفل الذي كان يفتخر بحقيبته وأقلامه ودفاتره، يفقد مع غيابها جزءًا من هويّته الذاتيّة. فهو يرى نفسه الآن بلا مقعد، بلا فصل، بلا أحلام واضحة. يتسلّل إلى وعيه الباكر شعورٌ بالعجز والدونيّة، إذ يشاهد أقرانه في العالم ينعمون بمدارسهم وكتبهم بينما هو يبحث عن حقيبة بين الركام. هذا الإحساس يولّد داخله ما يسميه علماء النفس بـ "الحرمان المقارن": شعور يولد عندما يدرك الفرد الفجوة بين ما يعيشه وما يعيشه الآخرون، فينشأ الإحباط والغضب. وقد تنتج عنه نزعات انتقاميّة في مراحل متقدّمة.
أمّا على المستوى الوجدانيّ، فإنّ انقطاع التعليم يضاعف الإحساس بالفقدان. فالتعليم ليس وسيلة لاكتساب المعرفة وحسب، بل هو طقس يوميّ ينظّم حياة الطفل ويمنحه إيقاعًا حياتيًّا وحيويًّا مألوفًا. وحين ينكسر هذا الإيقاع، يصبح اليوم مجرّد فراغ طويل يمتلئ بالخوف والانتظار. هذا الفراغ، بحسب الدراسات النفسيّة، يفتح الباب واسعًا أمام اضطرابات ما بعد الصدمات (PTSD) التي تتجلّى في الكوابيس، والانطواء، ونوبات الغضب غير المبرّرة، وصعوبات في تكوين العلاقات الاجتماعيّة وما ينتج عن ذلك من اضطرابات في حياته الاجتماعيّة.
ولا يمكن إغفال أثر ذلك في تطوّر "الهويّة المستقبليّة". فالأطفال عادة يرسمون أحلامهم بالمدرسة: فمنهم من يحلُمُ أن يكونَ طبيبًّا، أو معلّمًا، أو مهندسًا. لكن في غزّة، حين يُمحى هذا الأفق، ينشأ جيلٌ بلا صور واضحة لمستقبله، ما يزيد احتمالات الانخراط في دوائر الإحباط أو حتّى السلوكيّات الخطرة.
الأثر التربويّ: انقطاع السلسلة المعرفيّة وغياب الفرص
التعليم هو العمود الفقريّ لأيّ جيل يسعى للبناء والازدهار. وفي مرحلة الطفولة المبكرة، تُشكّل المدرسة والصفوف الدراسيّة شبكة حيويّة لبناء مهارات أساسيّة في القراءة والكتابة والحساب. عندما تُقصف المدارس وتُدمّر المكتبات، كما يحدث في غزّة منذُ عامين بلا توقّف، فإنّ هذا الانقطاع لا يُحدِث مجرّد توقّف مؤقّت في التعلّم، إنّما يخلق فجوة معرفيّة عميقة تتراكم مع الوقت. يفقدُ الأطفال القدرة على متابعة المفاهيم تدريجيًّا، ما يؤدّي إلى ضعف في استيعاب الموادّ المعقّدة مستقبلًا. هذا الانقطاع، المعروف في الدراسات التربويّة بـ"انقطاع السلسلة التعليميّة"، يترك أثرًا دائمًا في قدرة الطفل على التعلّم مدى الحياة.
تشير أبحاث علم النفس التربويّ إلى أنّ التعلّم في الطفولة المبكرة، مرتبط بشكل مباشر ببناء الدماغ وتطوير الذاكرة والمهارات التنفيذيّة. وعليهِ فإنّ غياب التعليم المستمرّ، حتّى ولو لبضعة أشهر، يؤدّي إلى تأخّر في تطوير التفكير النقديّ، وحلّ المشكلات، والقدرة على التركيز. هذه الفجوة تتّسع عندما يُحرم الطفل من الممارسة اليوميّة للقراءة والكتابة، وتصبح عمليّة التعويض لاحقًا صعبة ومعقّدة، خصوصًا في ظلّ استمرار الصدمات البيئيّة والنفسيّة، ما يؤدّي إلى صعوبة وتعقيد أكثر في إيجاد حلول لها.
ولا يقتصرُ الأثر التربويّ على المعرفة الأكاديميّة فحسب، بل يمتدّ إلى المهارات الحياتيّة الضروريّة للنموّ الاجتماعيّ والمهنيّ. فالمدرسة توفّر للأطفال بيئة منظّمة لتعلّم الانضباط، والعمل الجماعيّ، والمسؤوليّة، وحلّ النزاعات. وعند غيابها، تتوقّف هذه العمليات، ويُحرَم الطفل من التدريب العمليّ على الحياة اليوميّة، ما يضعف قدرته على التكيّف مع المجتمع لاحقًا وبناء حياته بطريقة سويّة.
علاوة على ذلك، يؤثّر انقطاع التعليم في تكافؤ الفرص. فالأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات يُجبرون على مواجهة تحدّيات مزدوجة، مثل فقدان الوصول إلى المعرفة والموارد التعليميّة، وغياب بيئة داعمة تمكّنهم من التعلّم خارج الصفّ. يخلق هذا الأمر فجوة تعليميّة هائلة بين هؤلاء الأطفال وأقرانهم في البيئات المستقرّة، ويزيد احتماليّة تراكم العجز المعرفيّ والاجتماعيّ لديهم على المدى الطويل، بما يُهدّد فرص اندماجهم في الحياة الأكاديميّة والمهنيّة مستقبلًا.
يتّضح ممّا سبق، أنّ الحرب على التعليم في غزّة لا تُخلّف آثارًا مادّيّة فحسب، بل تنسج شبكة معقّدة من التداعيات التربويّة والنفسيّة والاجتماعيّة التي تطال الأطفال في عمق تكوينهم. إنّ فقدان المدرسة وما تحمله من رمزيّة للأمان والانتماء، إلى جانب انقطاع السلسلة التعليميّة وغياب الفرص المتكافئة، يفضيان إلى حالة من الاضطّراب النفسيّ والاجتماعيّ، ويؤسّسان لأزمة معرفيّة وهويّاتيّة طويلة الأمد. فالطفل المحروم من التعليم لا يخسر فقط قدرته على التحصيل الأكاديميّ، بل يفقد أيضًا أحد أهم دعائم بناء هويّته المستقبليّة وثقته بذاته وبالعالم من حوله. ومن هنا، فإنّ الاستجابة لهذه الأزمة لا يمكن أن تُختزل في إعادة بناء المدارس، بل يجب أن تتبنّى استراتيجيّات شموليّة تراعي الأبعاد النفسيّة والتربويّة والاجتماعيّة، بما يعيد إلى الأطفال حقّهم في التعلّم الآمن بوصفه الركيزة الأساسيّة لأيّ نهضة إنسانيّة ومجتمعيّة مستدامة.