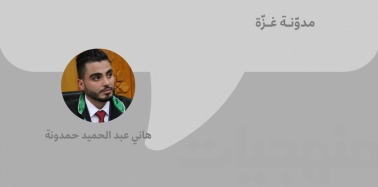هل امْتلَكتم لقَباً مميّزا عندما كنتم صِغاراً؟
أنا امتلكتُ العديد منها، وهي: سوسو، سوسة، سوس، وأم السّوس. لكنّ (سوسو) هي المفضّلة لَديّ. كانت شقيقتي (بهيّة) الأكثر تَدليلا لي باستخدام هذا اللقب اللطيف من بين أخواتي السِّت، التي كنتُ رقم سبعة والصغرى بينهن.
لطالما نظرتُ إلى شقيقاتي اللواتي يَكبُرنني بسنوات كثيرة، وكأنّهن نساءٌ عملاقات؛ فلا شقيقةَ تُقاربُني بالسّن بينهن، وكنتُ أحلمُ أنْ أصبحَ عملاقةً مثلهن ومثلَ أمّي. ومع مُضيّ السنوات، كبُرت، وبقيتُ سوسو الصغرى والمُدَلّلة، لكنني لَم أعُد بحَجمِ عُقلة الأصبع، بل أصبحتُ (سوسو عملاقة).
وبما أنني أنتمي إلى أسرةٍ تربويةٍ، بوجود والدٍ مُعلّم، وأربع شقيقات معلمات، وشقيقة خامسة مديرةِ مدرسة، وشقيق معلّم من حمَلةِ الدكتوراة، أضحيتُ أنا (بالوراثة) معلمةً أيضا، أو هكذا بدا لي.
في بداية عملي كمُعلمة، صادفَ أن اختارَتني مديرية التربية والتعليم، لأدَرّس طالباتِ المرحلة الثانوية، لم أشعر وقتها أنني معلمة مُستَجدة؛ يبدو أنّ جيناتي الوراثية لعبَت دورها في تشكيل شخصيتي المهنيّة، فبدا لي أنني خُلِقتُ لأكون معلمة.
كانَ تدريس هذه المرحلة، تجربةً مهنيّة مميزة، جعَلتني أقفُ كلّ يوم أمام فتياتٍ يُدانينَني في السّن، معَ تقاربٍ في الاهتمامات وشكل الملابس أيضا. لَم أفكّر وقتها بصورتي في مُخيّلتِهن، ربما بدوتُ شابّة مثابرة و(عصريّة) كما عبّرت بَعضُهن، لكن ما كنتُ حريصةً عليه، هو تأديَة رسالتي بأمانة تجاه هذه المرحلة المِفصَلية في حياة هؤلاء الطالبات المُقبلات على الجامعة، وأن أُنجزَ أطروحة الماجستير بمهارة وسرعة في الوقت نفسه.
العثور على "سوسو" العملاقة
في السنوات الثلاثة الأولى من وظيفتي، عمِلتُ أمينةً للمكتبة المدرسية إلى جانب التدريس، فقرأتُ الكثير من قصص الأطفال، وروايات اليافعين، وكنتُ وقتها مُهتمّة بروايات الكبار، وأكتبُ القصص القصيرة لهم أيضا. قرّرتُ أن أكون مسؤولةَ مكتبةٍ مثابرةً، يَعُزّ عليها أنْ يَمضيَ يومٌ دون أنْ تستعيرَ فيه طالباتُ المدرسة وطلابُها قصصا للقراءة، لا سيّما الأطفال في الصفوف الأساسية الأولى، الذين بدأتُ اقتربُ من عالمهم شيئا فشيئا، من خلال القصص.
في سنةٍ لاحقة، تمّ ضَبط جدوَل حِصصي بشكل مختلف، فأصبحتُ معلمةً للصف الرابع الأساسيّ إضافةً للمرحلة الثانوية، فواجهتُ أطفالا في سنّ التاسعة، يطلبونَ منّي أنْ أُبِطئ في كتابَتي، وأنْ أجعلَ خطّي أكبر، وألّا أتحدّثَ بالعربية الفصحى طويلا، ويجتمعون مثل النّحل حولي وفوق رأسي وتحت طاولتي وبين أكتافي عندما أصَّحِح دفاترَهم وكُتبَهم، ويتذمّرون من أشياء بدَت لي بسيطةً وتافهةً.
شعرتُ وأنا أراقبُ نظراتِهم المُتفحّصة لي، وقاماتِهم المحدودة جانبي، وضحكاتِهم الشقية عندما أقوم بأيّ شيءٍ يثير فيهم الدهشة، ورَهبَتهم عندما أمشي باتجاههم، وتأملّهم لحَرَكاتي وسَكَناتي، واطمئنانَهَم عندما أُرَبّت على أكتافهم أو أمسحُ على رؤوسهم الصغيرة، وكأنّ شيئا من الماضي استفاق بداخلي. شعرتُ بين كلّ تلك العيون الواسعة التي تنظر إليّ باهتمام، أنني عملاقة، لكنّها عملاقةٌ لطيفة؛ لم تتخلّص بَعدُ من كونها (سوسو).
ظننتُ أنّ هذا الشعور سيصاحبُني في ذاك العام الطارئ فقط، ولَم أكُن أعرف وقتها، أنني سأستمر في تعليم هذه الفئة العمرية فترة طويلة؛ إذ طلبتُ من مديرية التربية والتعليم نقلي إلى مدرسةٍ للأطفال، أعني المراحل التعليمية الأولى فقط، لسببٍ صحيٍّ في البداية، حاولَتْ بعده المؤسسة الرسميّة إعادتي لتعليم الكبار، لكنني رفضت؛ فقد تعَلّقتُ بالكتكوتات الصغيرات، اللواتي أحبَبني أيضا وتعلّقن بي.
لطالما لاحقتني صورةُ الأم أو الأخت الكبيرة، التي يحيط بها الأطفال، ويمسكون بِطرفِ فستانها وبنطالها ومِعطفها؛ كي يلحقوا بها إلى المكتبة وغرفة المعلمات والطابق العلويّ من المدرسة والطابق السفلي وإلى الساحة وإلى سيارة السيرفيس عند نهاية الحصص وإلى دورة المياه أيضا، كي يقولوا لها ما في جُعبتهم: يا مِس (سوسو العملاقة) إحنا بنحبّك. شوفي أنا رسمتْ صورتِك مبارح وأنتِ بالصف. إنت بتحبّيني أكتر وإلا بتحبّي صاحبتي؟ مين بتحبّي أكتر البنات أو الأولاد؟ طَب مين الأشطر البنات أو الأولاد؟ أنا (أولة) الصف وإلا مين؟ يا مِس (سوسو العملاقة) إنت متزوجة؟ قديش عندك أطفال؟ يييي!!! ليش لسّا مش متزوجة؟! يعني ما عندك أولاد وبنات؟؟؟.."
كلّ تلك العبارات والأسئلة كانت تلاحقني، وتجعلني سعيدة؛ فأنا (سوسو عملاقة وديمقراطية)؛ مستعدة لسماع كل ما لَم أستَطع قَوله لمعلمتي، التي كانت (عملاقة) بالنسبة لي يوما ما، لكن بدون ألقاب لطيفة؛ حيث لَم يكن بإمكاني الحديث بحرية مع مُدَرّساتي ومديرتي، أو التعبير عن مشاعري لهن، خصوصا في المرحلة الأساسية الدُّنيا.
لكن، هل هذه هي صورتي في خيال الأطفال أيضا؟ هل أنا ( سوسو عملاقة) حقا؟؟ أم أنني مجرّد معلمة تستطيع بتكشيرة واحدة أن تُطيّرَهم إلى القُطب الشمالي؟
وحدَها الغَمَرات والابتسامات ورسائل الحُب والفَضفضة والقُبَل وال(هييييي) في بداية الحِصص كانت تطمئنني، وتجعلني أتساءل عمّا تحمله رؤوسُهنّ الصغيرة من أمنيات.
عماليق صغيرة
منذ ذلك الحين، توسّعتْ خِبرتي مع الأطفال، وأصبحتُ أؤمن بوجود عماليق صغيرة في داخل كل واحدٍ منهم. وقرّرتُ اقتناص الفُرَص التي تُثري تجربتي في التعامل معهم؛ فاستخدمتُ الأسلوب القصصي الغنّي كأداةٍ مساعدة، لإيصال المعلومات والمعارف، حتى أصبحَ نهجا أعتَمده. ولَم أكتَفِ بالقصص المنهجيّة، بل بِتّ أختارُ القصص اللامنهجية الممتعة كي أقرأها لهم في الأوقات المتبقيّة من حِصصي، وبعض حصص (الإشْغال). وزادتْ لهفتي لِتعلّم الوسائل والأساليب التعليمية النّشِطة لاستخدامها في التدريس؛ فانضممتُ إلى المدرسة الصيفية التابعة لمؤسسة عبد المحسن القَطّان، التي تُعنى بتأهيل المعلمين الفلسطينيين والعرب في حقل الدراما، وواصلتُ تدريبي معهم لسنوات، وحرصتُ على تطبيق ما تعلمتُه مع الطالبات، فتحوّلتْ حِصصي داخل الصف إلى مسرح، ومختبرٍ للتجارب، وإلى مهرجان أحيانا. وكنتُ في غاية الامتنان، عندما طلبتْ منّي مديرية التربية والتعليم تدريب زميلاتي من معلمات المرحلة الأساسية الدُنيا، على التعليم بوساطة الدراما، لثلاث سنوات.
واصلتُ تلقّي التدريبات في حقل الدراما والمسرح وسينما الناشئة وعلم المكتبة والكتابة الإبداعية والنقدية للأطفال والفتيان والتعليم الجامع (المَبني على دَمج ذوي الإعاقة). وامتلأت دروسي بالرسم وتمثيل الأدوار والتعبير الشفهي والكتابي والغناء والمعلومات الإثرائية والأسئلة الشفوية والكتابية. وكتبتُ قصصا للأطفال تَحوّل بعضُها إلى إنتاجٍ ورقيّ، وبعضها تحوّل إلى إنتاجٍ بوساطة (فيديوهات أنيميشن) ودُمى. أما التدريب الأقسى، فكان بعد تجربة الأمومة، التي خَلقت منّي (سوسو عملاقة جدا)، إذْ رزقني الله بتوأميْن، تعلّمتُ منهما، وجعلاني أتعمّق أكثر، في غابة الأطفال المشاكسين والعنيدين والحنونين واللطيفين والقنوعين والأنانيين والمُعافين وذوي الهِمم. فزادَ فَهمي لشخصياتهم وحاجاتهم، وإحساسي بمشاعرهم.
كنتُ أريد لدَرسي أن يكونَ وقتا مُستقطعا من الحياة، لهنّ ولي. فأبدأُ حين أرى لَهفَتهن، وأغيّر أسلوبي عندما أشعرُ أنّ طاقاتهن بدأ بالخفوت، وأتوقّف عندما يشعرنَ بالتعب أو الملل؛ فلا معنى لأيّ شيء، عندما يحسّ الطفل بمشاعر سلبية. وأهمس لنفسي: تحتاجُ أوطاننا لعماليق قادرين على البناء والابتكار، عماليقَ يقفون في وجه الاحتلال والفساد والغش والرجعية، فإنْ أهملناهم، سيتحوّلون إلى عماليق هادِمة، تعيث في الأرض فسادا.
حقول الأطفال الواسعة والمتشابكة
علّمتُ الأطفال اللغة العربية والتربية الإسلامية والتنشئة الاجتماعية والوطنية والفنون والتربية الرياضية. كانَ تحدّيا صعبا، أن أوصِلَ ما أريدُ إلى طفلاتٍ اعتَدنَ التلقينَ الأكاديمي والمُجتمعيّ. كانَ تحدّيا أن أتحوّل إلى أرنبٍ يقفز في حصّة الرياضة، وإلى حَكواتيّة في حصّة أخرى، وأن أكونَ فنّانة -موهوبةً نسبيا- في الرسمِ والتشكيل.
كانَ تحدّيا وواجِبا، أن أزيل غُمّة العبارة التي يسمعها معظم الأطفال: "إذا فعلتُم كذا وكذا، فسوفَ يغضبُ منكم الله، ويِضعكُم في النار". كانَ لِزاما علَيّ أن أكون صوفيّة تتحدّث عن عشق الله، وعن حرصِه علينا، وعن حبّه الشديد لنا، وعن صَفْحه عن أخطائنا. كانَ لِزاما عَليّ، أنْ تعرفَ طفلاتي في المدرسة، أنّ إماطة الأذى عن الطريق، ومساعدة الآخرين، وكَتم الأسرار، وغيرها من القيم النبيلة التي ترتقي بها الأمم، تزنُ عند الله الكثيرَ الكثير، بدلا من أن يَرتَعِبن من "جهنّم الحامية".
كانَ لِزاما علَيّ، أن تكونَ فلسطين من البحر إلى النهر، حاضرةً على لساني في كل حين، وأن أستخدم تعبير "الأرض المحتلة" عند الحديث عن قُرانا ومُدُننا التي أطلقَ العالم عليها اسما بغيضا، وهي ميزةُ المعلمين الفلسطينيين أجمعين. كانَ عَليّ أنْ أستخدم كلمة وطن، عندما أتحدّث عن إحدى الدول العربية والإسلامية؛ كي يعرف الأطفال أنّ لهم إرثا واسعا وغاليا. وكان عَلَيّ أن أصِفَ بحبٍّ ودفء كلّ ثورات الشعوب وقضاياها في العالم، وكلّ الأديان التي يدين بها البَشر؛ كي يفهم الأطفال أنّ لهم امتدادا إنسانيا هم مستقبلُه وقوامه.
لطالما آمنتُ أنّ عَلَيّ أنْ أكون معلمة بحقّ، بعيدا عن كلّ الأوصاف والألقاب الرّنانة؛ كي يَشعر الأطفال أنّ لديهم حِصّةً مميزةً في كلّ مرّة، وكي يعلموا أنّ بإمكانهم أن يقولوا ويفعلوا ما يشاؤون، ويتعلموا من أخطائهم.
مرّة، طلبت منّي إحدى المؤسسات التربوية والثقافية في فلسطين، أن أكتبَ عن تجربتي في التعليم، وقامت بنشرها في كتابٍ ورَقيّ مع تجارب متنوعة لبعض التربويين الفلسطينيين. كتبتُ يومها بشغفٍ كما أكتبُ الآن، وقد مرّ على مسيرتي المهنية، ثلاثة عشرَ عاما، قضيتهُا معلمةً في مدارسَ تابعة للحكومة، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، و(حكواتية) في بعض المؤسسات، وكاتبة للأطفال، وقد سمّيتُ مقالتي يومها (ساحرة بلا عصا)؛ فهذا ما شعرتُ به وقتها. لكنّ هذه الساحرة، أخذت شكلا جديدا مع تتابع سنوات تعليم الأطفال، فهي ترى نفسها الآن (سوسو العملاقة)؛ المعلمة التي تسعى لتطوير أدواتها وزيادة خبرتها بقوّة وثبات، وفي قلبها طفلةٌ تُساندها نحو الأفضل، وترعى خطواتها، وتُباركها.