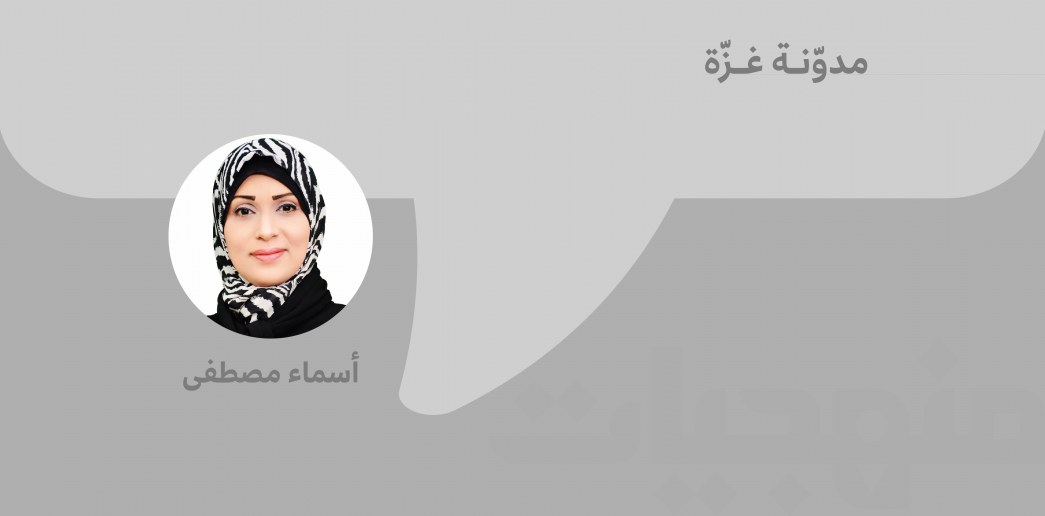في صباحٍ ليس كأيّ صباح، استيقظت غزّة على نبأ يشبه المعجزة. كان يوم 14 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2025 يومًا للفرح النادر في زمنٍ غارقٍ بالحزن، يومًا كتب فيه طلّاب فلسطين وطالباتها صفحةً من النور بعد انطواء سجلٍّ طويلٍ من الرماد. في هذا اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانويّة العامّة، بعد عامين من الحرب والإبادة، عامين من القصف والنزوح، من الدمار الذي التهم المدارس والمنازل والمكتبات والدفاتر، لكنّه لم يلتهم العقل الفلسطينيّ ولا الحقّ المقدّس في التعليم.
في هذا اليوم، لم يحتفل الطلّاب بنتائج امتحانات، بل بانتصار الإنسان على الفناء، بانتصار الكتاب في حرب التجهيل الممنهجة، وبأنّ المداد أقوى من الدماء، وأنّ من استطاع أن ينجح وسط الركام لا يمكن أن يُهزم أبدًا.
كانت تجربة الثانويّة العامّة في زمن الحرب تجربة استثنائيّة بكلّ المقاييس، فقد بدأت امتحانات الثانويّة العامّة في غزّة في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر 2025، بعد عامين من الإبادة التعليميّة والتعليم الشعبيّ البديل في الخيام ومراكز الإيواء. تقدّم إلى الامتحانات أكثر من 26 ألف طالب وطالبة من مختَلف محافظات القطاع، على الرغم من النزوح المتكرّر وتدمير المدارس وفقدان الكتب والمعلمين (الجزيرة نت). وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت نظامًا إلكترونيًّا جديدًا يُعرف باسم "وايز سكول" (Wise School)، وهو نظام رقميّ متكامل لتسجيل الطلبة ومتابعة بياناتهم ودرجاتهم وتنظيم قاعات الامتحان إلكترونيًّا، ما ساعد في تسهيل الإجراءات في ظلّ غياب البنية التحتيّة التقليديّة. كما أتمّ 31 ألف طالب من مواليد 2007، الدفعة التالية لمواليد 2006، امتحانات الثانويّة العامّة، وغزّة على قيد انتظار نتائجهم خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله.
وتعتبر تجربة طلبة الثانويّة العامّة في غزّة خلال الحرب واحدة من أكثر التجارب قسوة وتحدّيًا في تاريخ التعليم الفلسطينيّ؛ إذ وجد هؤلاء الطلبة أنفسهم أمام امتحان لا يقيس فقط تحصيلهم الدراسيّ، بل يقيس أيضًا قدرتهم على الصمود والبقاء وسط أهوال الإبادة والدمار. لم يكن العام الدراسيّ كسابقه، ولم تُفتح المدارس أبوابها كما في الأعوام الماضية. فالكثير من المدارس دُمّرت أو تحوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين، والصفوف التي كانت تضجّ بأصوات المعلّمين والطلّاب أصبحت ركامًا أو ساحات خالية إلّا من الغبار والذكريات.
لم يتلقَّ معظم الطلبة أيّ دروس منتظمة داخل القاعات الدراسيّة كما جرت العادة، إذ انقطع التعليم الوجاهيّ لأشهر طويلة، وتشتّت الطلبة بين مناطق النزوح، وتفرّق المعلّمون في خيام اللجوء أو بين المدن المدمّرة. لكن مع ذلك، لم يتوقّف الأمل، ولم تنطفئ رغبة هؤلاء الشباب بمتابعة طريقهم نحو المستقبل. لجأ الطلبة إلى الاعتماد على التعلّم الذاتيّ بكلّ ما استطاعوا من وسائل، فكان الإنترنت و"يوتيوب" نافذتهم الصغيرة نحو المعرفة. جلس كثير منهم تحت خيمة، أو في غرفة صغيرة تفتقر إلى الكهرباء، يحمّلون مقاطع الفيديو التعليميّة على هواتفهم القديمة، ويعيدون مشاهدتها مرارًا ليفهموا درسًا في الفيزياء، أو مسألة في الرياضيّات، أو نصًّا أدبيًّا باللغة العربيّة.
وفي ظلّ غياب التعليم النظاميّ، انتشر ما يمكن تسميته بـ"مدارس الظلّ"، وهي حلقات صغيرة من الطلبة والمعلّمين يجتمعون في أماكن مؤقّتة، في البيوت، أو الزوايا الآمنة من المساجد، أو حتّى تحت الأشجار، ليتلقوا دروسًا خصوصيّة مقابل مبالغ ماليّة تفوق قدرة أسرهم. تحمّل كثير من الطلبة وأولياء الأمور أعباء ماليّة ثقيلة، إذ اضطرّوا إلى دفع ما تبقّى لديهم من مدّخرات، أو بيع مقتنيات بسيطة لتأمين رسوم الدروس الخصوصيّة، إيمانًا منهم بأنّ التعليم هو الاستثمار الأخير في زمن الحرب.
لم يكن الطريق إلى تلك الدروس سهلًا. خاطر الطلبة بحياتهم في سبيل العلم، يتنقّلون بين المناطق المهدّدة بالقصف، يحملون دفاترهم في حقائب صغيرة وكأنّها دروع واقية. كانوا يعرفون أنّ كلّ خطوة نحو معلّمهم قد تكون الأخيرة، ومع ذلك كانوا يسيرون في الطرق المدمّرة، يتنفّسون الغبار، ويكملون المسير نحو حلمهم. كثيرون منهم عادوا إلى بيوتهم وقد أنهكهم الخوف والتعب، لكنّهم لم يتراجعوا. كانوا يؤمنون بأنّ العلم في زمن الإبادة شكل من أشكال المقاومة.
ومع اقتراب موعد الامتحانات، واجه الطلبة تحدّيًا جديدًا لا يقلّ خطورة عن الحرب نفسها، وهو الوصول إلى مراكز الامتحان في ظلّ انقطاع الكهرباء وغياب الخدمات الأساسيّة. فقد فُرض عليهم الانتقال إلى مناطق تتوفّر فيها خدمة الإنترنت والطاقة، حتّى يتمكنوا من الدخول إلى النظام الإلكترونيّ الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، وهو نظام "وايز سكول" (Wise School) الذي اعتمد لتسجيل الطلبة وإدارة الامتحانات. كانت هذه الخطوة تنظيميّة مهمّة، لكنّها في واقع غزّة المحاصر تحوّلت إلى عبء إضافيّ على الطلبة الذين اضطرّوا إلى التنقّل يوميًّا عبر طرق مدمّرة، من أجل الوصول إلى تلك المناطق المحدودة التي تتوفّر فيها الطاقة وخدمة الإنترنت. واصطفّ بينهم الكثير من المبادرين، المعلّمين والمهندسين وخبراء تقنيّين، لمواجهة أيّ مشاكل فنّيّة - تقنيّة قد تواجه الطلّاب أثناء تأديتهم الامتحانات إلكترونيًّا، ولأوّل مرّة في حياتهم.
وتحت حرّ الشمس، وفي ظلّ انعدام المواصلات الآمنة، سار الطلبة مسافات طويلة للوصول إلى قاعات الامتحان. بعضهم ركب عربات صغيرة، وآخرون استقلّوا دراجات أو مشوا على الأقدام. كانت وجوههم تحمل مزيجًا من الخوف والإصرار، وبين أيديهم أقلامهم وكرّاساتهم التي بقيت نظيفة على الرغم من كلّ ما حولها من رماد. داخل القاعة، كان الصمت يختلط بصوت الطائرات، وكان المراقبون يحاولون تهدئة القلوب المرتجفة. لم يكن الامتحان مجرّد اختبار في الرياضيّات أو اللغة، بل امتحان في الإرادة والصبر وتثبيت الهويّة الفلسطينيّة وإثباتها.
عاش هؤلاء الطلبة تجربة استثنائيّة بكلّ معنى الكلمة. لم يتلقّوا دروسًا منظّمة. لم يراجعوا مع معلّميهم كما في السنوات السابقة. لم يتمكّنوا من التدريب على الامتحانات التجريبيّة، أو مناقشة الأسئلة بصوت مرتفع داخل الصفوف. كلّ شيء تعلّموه كان حصيلة جهدهم الشخصيّ ومثابرتهم الفرديّة. ومع ذلك، حين أُعلنت نتائج الثانويّة العامّة في الرابع عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2025، أذهلوا العالم. كانت النتائج شهادة جديدة على أنّ الشعب الفلسطيني لا يُهزم بالخراب، وأنّ أبناء غزّة قادرون على انتزاع الحياة من تحت الركام.
أثبت طلّاب الثانويّة العامّة هذا العام أنّ التعليم في غزّة ليس مجرّد نظام أكاديميّ، بل هو معركة وعي وصمود. وأنّ الإرادة التي تكتب الدروس على ضوء الشموع وتراجع الدفاتر بين أصوات الانفجارات، إرادة لا يمكن محوها. هؤلاء الطلبة لم ينجحوا في امتحاناتهم فقط، بل نجحوا في إعادة تعريف معنى التعليم نفسه: تعليم يولد من تحت النار، ويزهر على الرغم من الحصار، ويعلن للعالم أنّ المستقبل ما زال ممكنًا، وأنّ في غزّة ما يستحقّ الحياة والعلم والحلم.
هم أبطال الحياة في زمن الرماد، أبناء الخيام ومراكز الإيواء، أبناء المدارس المهدّمة التي تحوّلت إلى أطلال. جلسوا في الصفوف حين أمطرت السماء نارًا، حفظوا الدروس على ضوء الشموع حين انقطعت الكهرباء لشهور، واستيقظوا على أصوات الطائرات ليكملوا مراجعة الدروس بين الغارات. من بين جدرانٍ متصدّعة وأرضٍ يغمرها الغبار، خرجوا بأوراقهم، بدفاترٍ نجت من القصف، بقلوبٍ ارتجفت خوفًا كلّ ليلة، لكنّها نهضت كلّ صباح لتتعلّم.
كانت الطالبة التي فقدت والدها تحت الركام تكتب اسمه في رأس الصفحة كلّ صباح، كأنّه ما زال يوقظها للمدرسة. وكان الطالب الذي نزح عشرة مرّات يحفظ معادلات الكيمياء على أصوات المدافع، يخطّه على جدار خيمته بقلمٍ مكسور. كانت معلّمتهم المفقودة حاضرةً في وجدانهم، تهمس لهم: "اعمل لغدك كأنّك تعيش أبدًا".
طلّاب الثانويّة العامّة يكتبون التاريخ
في كلّ بيتٍ من بيوت غزّة، كان اسم طالب أو طالبة يتردّد كأغنية انتصار. لم يكن أحد ينتظر درجاتٍ مرتفعة فقط، بل كانوا ينتظرون دليل الحياة. أن يظهر اسمك في قائمة الناجحين يعني أنّك ما زلت حيًّا، أنّك لم تُمحَ من ذاكرة البلاد، وأنّك ما زلت تملك القدرة على الحلم، على الرغم من أنّ كلّ شيء من حولك يقول العكس.
كان هذا اليوم يوم ولادة جديدة لغزّة.
المدينة التي دُمّرت مدارسها، قُصفت جامعاتها كافّة، أُبيدت مكتباتها، نهضت وقالت: "ها نحن هنا". لم تكن نتائج الثانويّة العامّة مجرّد حدثٍ إداريّ، بل بيانًا وطنيًّا يعلنه الجيل الجديد:
لا يمكن محو الفلسطينيّ من الوجود، لأنّنا نعيد بناء أنفسنا بالعلم، كما سنعيد بناء بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا.
غزّة التي نزفت طويلًا، أهدت العالم هذا اليوم مشهدًا يُبكي ويبهج في آنٍ: طلّاب يلوّحون بأوراق النجاح أمام خيامهم؛ أمّهات تزغرد على الرغم من الدموع؛ آباء يحملون صور الأبناء الشهداء الذين حلموا بهذا اليوم ولم يشهدوه. كانت فرحة انتصار الوعي على محاولات الإبادة.
الحقّ المقدّس في التعليم
في كلّ شرعةٍ دوليّة، يُذكر أنّ التعليم حقّ من حقوق الإنسان. لكنّ الفلسطيني وحده حوّل هذا الحق إلى فعلٍ مقدّس. منذ النكبة الأولى، ظلّ التعليم عند الفلسطيني فعلًا مقاومًا بامتياز. كان اللاجئون الأوائل يحملون كتبهم في طريق المنفى، كما يحمل الفلّاح بندقيته. واليوم، في سنة 2025، تتكرّر الحكاية بأشدّ صورها قسوةً وبهاءً في آن.
هؤلاء الطلاب لم يدافعوا عن حقّهم فحسب، بل دافعوا عن فكرة التعليم ذاتها في وجه الموت. قالوا للعالم أجمع: "ربّما تستطيعون هدم مدارسنا، لكنّكم لن تستطيعوا هدم إرادتنا في التعلّم". وربّما كان مشهد الطلّاب الذين جلسوا للامتحان في خيامٍ أقيمت على ركام المدارس، أكبر شهادة على أنّ الفلسطينيّ لا يُهزم، وأنّ الوعي لا يُباد.
أرقام النجاح لا تقيس حجم المعجزة
حين أعلنت النتائج، تهافتت القلوب قبل الأعين على شاشات الهواتف القديمة، تلك التي نجت من الحرب. لم تكن الأرقام في الجداول كالأرقام المعتادة، كانت رموزًا للبطولة والصبر. كلّ رقم نجاحٍ كان مرادفًا لنجاةٍ من الموت. كلّ علامةٍ كانت دليلًا على معركةٍ انتصر فيها طالب على الفقد والجوع والظلام.
كانت كلّ غزّة في هذا اليوم ناجحة، لأنّ من استطاع أن يواصل التعلّم وسط المجازر نجح قبل أن يرى نتيجته. ولأنّ في غزّة، لا يُقاس النجاح بالدرجات، بل بقدرة الروح على الصمود.
بداية الطريق
هذه النتيجة لم تكن نهاية المطاف، بل بداية الطريق.
جيل 2025 في غزّة هو جيل ما بعد الإبادة التعليميّة. هذا الجيل الذي سيعيد بناء المدارس والجامعات، لا بالحجارة وحدها، بل بالأفكار. جيلٌ لن ينسى أنّ كل صفحةٍ من كتابه كانت تحميه من الجنون والضياع، وأنّ كلّ كلمةٍ قرأها كانت درعًا في وجه المحو. سيكبر هؤلاء الطلبة ليكونوا أساتذة وأطبّاء ومهندسين. لكن، قبل كل شيء، سيكونون حرّاسًا للذاكرة الفلسطينيّة وشهودًا على قسوة التجربة، وهم من قال عنهم الشهيد الدكتور رفعت العرعير، الأديب والأستاذ الجامعيّ الفلسطينيّ الذي اغتيل في غزّة بداية حرب الإبادة:
"إذا كان لا بدّ أن أموت
فلا بد أن تعيش أنت
لتروي حكايتي".
هذا الجيل الذي سيروي الحكايات كلّها، سيقول للعالم بعد سنين: "نحن الذين درسنا تحت القصف، وتخرّجنا من قلب المأساة".
وسيظلّ يوم 14 تشرين الأوّل/ أكتوبر من كلّ عام، يومًا وطنيًّا في الوجدان الفلسطينيّ، يومًا يحتفى فيه بقداسة التعليم وخلود الوعي.