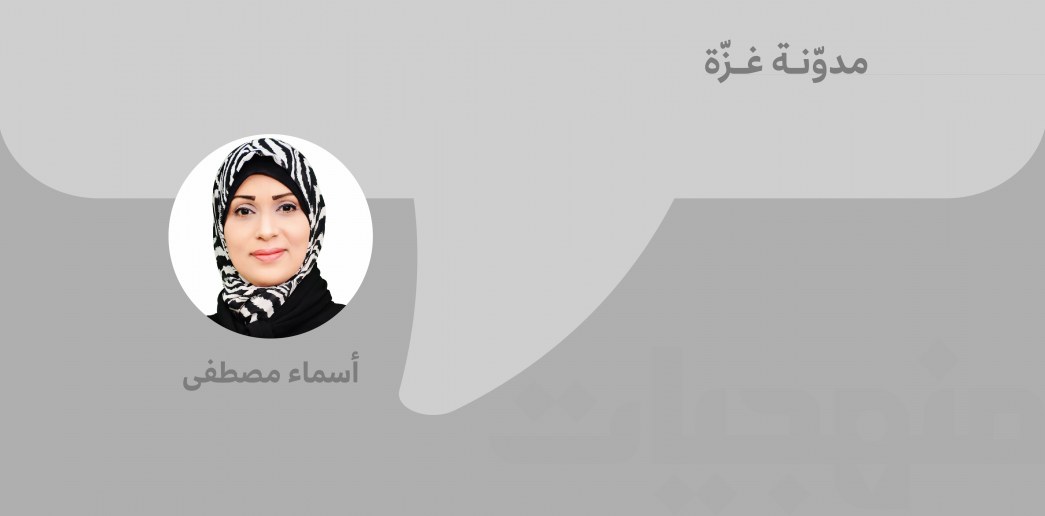بينما ينشغل العالم اليوم بالتحضيرات لاستقبال العام الدراسيّ الجديد 2025 - 2026، إذ تستعدّ المدارس والجامعات في مختلف الدول لفتح أبوابها أمام ملايين الطلّاب، ويتسابق الأهالي في شراء الحقائب والكتب والأدوات المدرسيّة، ويضع المعلّمون خططهم الدراسيّة ويتهيّؤون لبرامج تطويريّة جديدة، تبقى غزّة استثناءً مأساويًّا. على أرضها، تحت نار الإبادة الجماعيّة، يدخل الأطفال عامهم الدراسيّ الثالث على التوالي وهم محرومون من أبسط حقوقهم: الحقّ في التعليم.
وفي الوقت الذي تتزيّن فيه المدارس حول العالم لاستقبال طلّابها، يستمرّ تحوّل مدارس قطاع غزّة إلى أطلال مدمّرة بفعل القصف، أو إلى ملاجئ للنازحين الذين فقدوا بيوتهم. آلاف الصفوف الدراسيّة تحوّلت إلى ركام، والمقاعد التي طالما احتضنت الأطفال لم يبقَ منها سوى خشب متفحّم أو حديد ملتوٍ. لم تعد أصوات الأجراس تدقّ، ولا يتعالى صخب التلاميذ في الساحات، بل يسود الصمت عن التعليم المُوحش الذي يقطعه بكاء الأطفال وضحايا الحرب.
بعد مرور عامين كاملين من الانقطاع عن التعليم في غزّة، لم يعد مساره واضحًا، ولم يعد مستوى الأمل في العودة إلى مقاعد الدراسة النظاميّة يزيد عن نسبة عشرة بالمائة؛ فالمستقبل التعليميّ لأجيال كاملة يعيش حالة من الضبابيّة، إذ يدخل الطلّاب عامًا ثالثًا بلا صفوف منظّمة، أو مناهج محدّثة، أو استقرار نفسيّ يمكّنهم من استعادة شغفهم بالتعلّم. آلاف المعلّمين إمّا نزحوا، أو فقدوا أسرهم، أو استشهدوا تحت القصف، ما يجعل العمليّة التعليميّة أكثر هشاشة من ذي قبل. حُرم أطفال غزّة التواصل الطبيعيّ مع المعرفة، وبناء أحلامهم ومستقبلهم، مثل أقرانهم في العالم. ليس فقط لأنّ المدارس مدمّرة أو مغلقة، بل لأنّ شعورهم العميق بعدم الأمان يجعل التعلّم شبه مستحيل:
فالطفل الذي لا يعرف إنْ كان سيستيقظ غدًا تحت سقف آمن، أو سيظلّ حيًّا، كيف يمكنه أن يحفظ درسه أو يخطّط لغده؟
وتعيش غزّة اليوم مأساة تعليميّة غير مسبوقة. جيلٌ بأكمله مهدّد بفقدان سنواته الذهبيّة في التعلّم والتطوّر. حرمان التعليم ليس مجرّد انقطاع عن الدروس، بل هو محاولة منهجيّة لاغتيال المستقبل، لقتل الحلم، لزرع الجهل بدل المعرفة. وبينما يستعدّ العالم لمستقبل أكثر إشراقًا من خلال الاستثمار في التعليم، يُدفع أطفال غزّة إلى مستقبل مظلم، مثقل بالخوف والحرمان، على مرأى ومسمع من العالم.
لكن... هناك قبس لا ينطفئ
ومع هذا الواقع القاسي، لم ينطفئ تمامًا نور التعليم في غزّة.
فبين الركام والخيام، ظهرت مبادرات فرديّة وجماعيّة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. معلّمون ومعلّمات، على الرغم من الألم والنزوح وفقدان أحبائهم، بادروا إلى إنشاء نقاط تعليميّة بديلة للأطفال في المخيّمات، منذ بداية حرب الإبادة على غزّة. وتستمرُّ المبادرات وتزداد يومًا بعد يوم النقاط التعليميّة وتتوسّع، ترى المعلّمين المبادرين يقومون بعقد جلساته التعليميّة على الأرض أو تحت خيمة مهترئة، مستخدمين دفاتر قليلة أو ألواحًا خشبيّة بسيطة.
ولم تقف المؤسّسات التعليميّة المحلّيّة والدوليّة مكتوفة الأيدي، بل حاولت هي الأخرى مدّ يد العون إلى الأطفال المتعلّمين من خلال معلّميهم. فعملوا، بكلّ جهد، على توفير خيام صفّيّة أو توزيع موادّ تعليميّة بدائيّة، ليبقى خيط من الأمل مشدودًا بين الأطفال والمعرفة. وعلى الرغم من قلّة الإمكانيّات وانعدام الموارد، إلّا أنّ هذه الجهود مثّلت نافذة أمل صغيرة يتنفّس منها الأطفال، وبادرة تمنعهم من الغرق الكامل في بحر التجهيل المتعمد. ويُسَجّلُ للمعلّمين المبادرين سطر مُشرّف من النضال في تاريخ الإبادة التعليميّة التي مُورست على غزّة؛ حيث لم يتوقّفوا عن تأدية واجبهم الإنسانيّ والوطنيّ، وأداء رسالتهم السامية، فكانوا من حملَ شعلة الأمل وسط ظلام التجهيل الدامس. جلس كثيرٌ منهم مع الأطفال يقرؤون لهم قصصًا، يعلّمونهم الحروف، يكتبون على ورقٍ بالكاد وُجِد، أو على كرتون مُعاد استخدامه، فشكّلت هذه اللحظات لدى الأطفال استراحة قصيرة من الرعب اليوميّ، ومتنفّسًا لطيفًا لهم ليشعروا أنّ التعليم ما زال حقًّا ممكنًا، حتّى لو بطرق بدائيّة.
كانت نتيجة ذلك بشكل رئيس، إسهام هذه المبادرات الفرديّة في تعزيز الصمود النفسيّ للأطفال. فمنحتهم شعورًا بأنّهم ما زالوا طلّاب علمٍ في الحياة، وأنّهم جزءٌ من مسار تعليميّ وإن كان هشًّا. لكنّ الحقيقة المؤلمة أنّ هذه الجهود، مهما كانت عظيمة، تظلّ غير كافية أمام حجم الكارثة. فالتعليم يحتاج إلى بيئة آمنة ومناهج وبنية تحتيّة وإمكانات بشريّة ومادّيّة، وهو ما يكاد ينعدم اليوم في غزّة، ويقودنا إلى مخاوف احتضار التعليم الشعبيّ في غزّة بشكل كامل، وهو الأمر الذي لا تُحمدُ عقباه جملةً وتفصيلًا.
وعلى الرغم من ذلك، تبقى هذه النقاط التعليميّة أشبه بجذورٍ ممتنّة بعمق في أرض غزّة "حامية حمى التعليم" زمن الإبادة والتهجير والتجويع؛ ومضات نور صغيرة تتحدّى ظلام التجهيل، وتحمل رسالة واضحة:
التعليم في غزّة لم يمت، بل يقاوم، ويؤكّد أنّ حُبّ المعرفة أقوى من كلّ محاولات القمع والإبادة.
عن دفء الحنين الدافع
حين أغمض عيني وأتذكّر مدرستي، يملؤني حنين لا يُحتمل.
أشتاق إلى طابور الصباح، حين كنّا نقف أنا وطالباتي بانتظام واحترام أمام العلم الفلسطينيّ. ننشد النشيد الوطنيّ ونردّد التحيّة بصوت واحد مليء بالحياة. أشتاق إلى سبّورتي، إلى دفاتري وكتبي، إلى حصص اللغة الإنجليزيّة التي كنت أشرح فيها عن مدينة القدس، وأرى بريق الفضول في عيون الطالبات.
كم أفتقد زميلاتي المعلّمات، ضحكاتنا في غرفة المدرّسات، ومديرة المدرسة التي كانت تشجّعنا على تطوير أنفسنا باستمرار. كانت مدرستي تعجّ ببرامج التعليم الإبداعيّ، من مسرحيّات مدرسيّة وأنشطة فنّيّة، إلى مسابقات ثقافيّة وورش عمل تهدف إلى صقل شخصيّة الطالبات وتنمية قدراتهنّ. في مكتبتي المدرسيّة، كانت الأرفف عامرة بالكتب المتنوّعة، والطالبات يجدن فيها عالمًا رحبًا للمعرفة والاستكشاف.
أمّا اليوم، فأقفُ عاجزة عن فعل شيء، ولا أملك سوى الذكريات. لكنّ هذه الذكريات نفسها تدفعني إلى التمسّك بالأمل والعمل من أجل إعادة بناء ما فقدناه. أشتاق إلى الجلوس مع طالباتي أضع لهنّ خططًا دراسيّة، وأفكّر في طرق جديدة لجعل دروسهنّ أكثر متعة وفائدة. كنت أؤمن دومًا أنّ التعليم ليس مجرّد نقل للمعرفة، بل هو بناء للإنسان وصياغة للمستقبل.
اشتياقي إلى مدرستي ليس فقط حنينًا للمكان، بل هو حنينٌ للرسالة التي كنت أحملها، وللأثر الذي تركته في قلوب طالباتي. أفتقد ملامح الطموح في عيونهنّ حين نتحدّث عن المستقبل، حين نتبادل الأحلام حول ما سيصبحن عليه: طبيبات، مهندسات، معلّمات، كاتبات...
لقد كانت المدرسة فضاءً للحلم، وحاضنةً للأمل، واليوم أشعر بفراغ هائل يحاول أن يبتلع كلّ ذلك.
ومع ذلك، يمدّني هذا الحنين بطاقة لمواصلة الطريق. فما زلت أكتب وأخطّط، وأحاول أن أبتكر طرقًا جديدة للتعليم حتّى ولو كنت في خيمة نزوح. فالتعليم ليس مكانًا فقط، بل هو رسالة وروح، وأنا مؤمنة أنّ هذه الروح لن تُكسَر.
غزّة والأمل صنوان
على الرغم من الدمار الذي شهده قطاع التعليم في قطاع غزّة، ومع أنّ العام الدراسيّ الثالث يمرّ على أطفال غزّة بلا مدارس منظّمة ولا صفوف آمنة، إلّا أنّ الأمل لم يمت في قلوب الغزّيّين. صحيحٌ أنّنا نعيش وسط الألم كمن يسير في نفق مظلم طويل، لكنّنا نؤمن أنّ هناك ضوءًا في نهايته، ضوءًا سيعيد الحياة إلى مدارسنا وابتسامة طلّابنا.
فالأطفال الذين يرسمون على رمال المخيّم أحرفهم الأولى، هم أنفسهم الذين سيكتبون في المستقبل قصصهم بمداد النجاح.
البنات اللواتي يحفظن جملًا إنجليزيّة من دروسي القديمة في الخيام، ما زلن يحلمن أن يصبحن معلّمات وطبيبات ومهندسات.
والأولاد الذين يركضون خلف كرة مصنوعة من القماش في ساحات النزوح، سيكبرون ليبْنوا وطنًا أكثر صلابة ممّا مضى، ويكملون الحلم والمسير.
كما يتجسّد الأمل أيضًا في عيون الأمهات اللواتي، على الرغم من فقدهنّ، ما زلن يرسمن مستقبلًا لأبنائهنّ، وفي عزيمة المعلّمين الذين يصرّون على التدريس، ولو تحت ظلّ شجرة، أو بين خيام مهترئة. التعليم بالنسبة إلينا لم يعد مجرّد منهج أو شهادة، بل صار شريان حياة، دليلًا على أنّنا ما زلنا نتمسّك بإنسانيّتنا، ونرفض أن يُختطف مستقبلنا.
أمّا أنا، وبعد سبعة عشر عامًا من العمل والعطاء، ما زلت أحلم باليوم الذي يعود فيه طابور الصباح ليملأ الساحات من جديد، ونرفع علم فلسطين بأيدٍ صغيرة نقيّة لم تلوّثها الحرب. أحلم أن نعود لنملأ الدفاتر بالكتابة، والسبّورات بالشرح، وأن نعيد إلى مكتباتنا الكتب، ولقلوبنا الحلم.
غزّة دائمًا على يقين أنّ الحرمان مهما طال لن يكون قدرًا أبديًّا. فالتعليم في غزّة سيعود، وربما أقوى ممّا كان، لأنّنا تعلّمنا كيف نحميه بدمائنا وصبرنا. قد يظنّ العالم أنّ غزّة محاصرة بالحديد والنار، لكنّنا نعرف جيّدًا أنّ غزّة محصّنة بالإرادة والأمل.
ومع الآلام، سنفتح كتابًا جديدًا، وسنكتب من جديد، وسنعلّم أبناءنا أنّ الغد أفضل، وأنّ للعلم جناحين أقوى من كلّ أسلحة الموت، وسيبدأُ عامٌ دراسيٌّ في غزّة عمّا قريب بإذن الله سبحانه وتعالى.