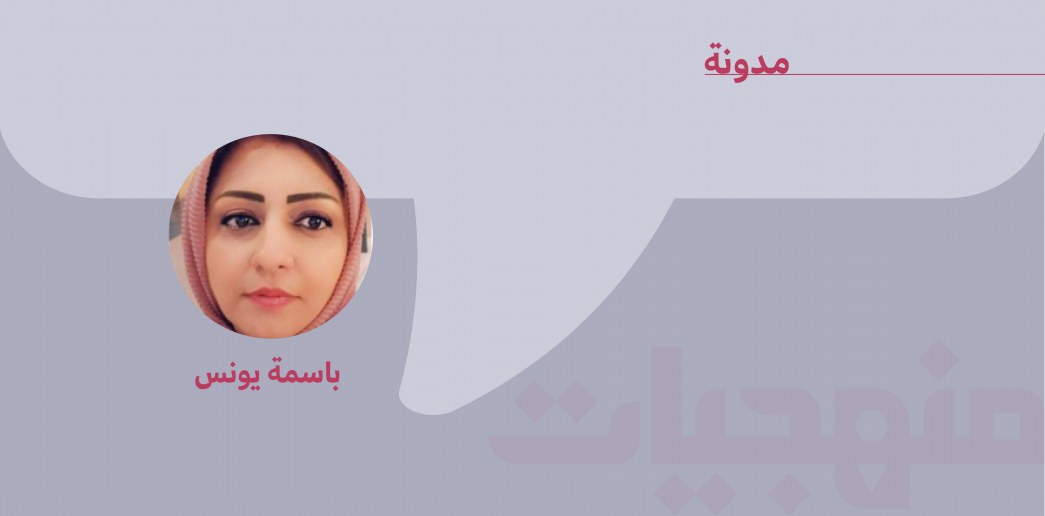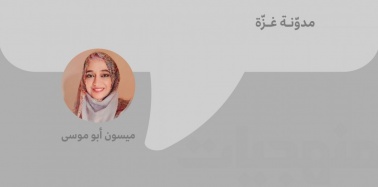مع اقتراب خريف 2025، وجدتُ نفسي أسترجع ما حملته الإجازة الصيفيّة هذه السنة من مشاهد ومقارنات. قبل أسابيع، وقبل بدء الفصل الدراسيّ الجديد، كنت في بيت أهلي في الأردن. ورأيت الأحفاد انشغلوا بهواتفهم وأجهزتهم اللوحيّة، وكأنّهم يعيشون داخل عالمٍ صامت يُغيّب ضحكاتهم ومرحهم. حقًّا الصورة جعلتني أستحضر صيف طفولتي، إذ كانت الإجازة مساحة عامرة بالعلم والروح واللعب.
كنتُ أنتظر العطلة بلهفة، لا باعتبارها فراغًا، بل فرصة للغذاء الروحيّ والمعرفيّ. كنتُ أرتاد دروس الدين بحماسة، أشارك في المسابقات القرآنيّة. ولا أنسى تلك الأيام التي كنتُ أزور فيها المكتبة العامّة القريبة من منزلنا، وكأنّني على موعدٍ لا يُفوّت. كنتُ أعشق هدوء المكتبة، وأتنقّل بين رفوفها كغوّاصٍ في بحر العلم، أتأمّل أغلفة الكتب ورسوماتها، وأختار منها ما أستعيره بشغف. كنت أشعر أنّني أغوص في بحر لا ينضب من الحكايات والمعارف واللعب في الحيّ مع الأصدقاء، كلّها كانت تشكّل لوحة صيفيّة لا تُنسى.
الإجازة آنذاك لم تكن فراغًا، بل كانت رحلة في عوالم الثقافة، وسفرًا إلى فضاءات الفكر، وطاقة روحيّة وإنسانيّة تُغني القلب والعقل. إلى جانب هذا الزاد الفكريّ، كنّا نمارس الألعاب الشعبيّة بكلّ براءة، من "الغميضة" إلى سباقات الجري، ومن كرة التنس إلى الطائرة، نشاطاتٌ كانت تُفرّغ طاقتنا وتُنعش أرواحنا.
أمّا هذا الصيف، فقد بدا مختلفًا. شاشات مضيئة، صمتٌ يطغى على أصوات الضحك، وحركة محصورة في أطراف الأصابع. بدا لي وكأنّ صيف الأطفال اليوم قصير النفس، يفتقد إلى ذلك الزخم الذي كان يمدّنا بالطاقة الإيجابيّة.
ليست هذه مقارنة عابرة بقدر ما هي محاولة لالتقاط الفارق بين زمنين: نحن، جيل الأمس، كنّا نُحصّل من الإجازة زادًا معرفيًّا وروحيًّا يعيننا طوال العام، بينما جيل اليوم يخرج من الإجازة محمّلًا بلحظات افتراضيّة سريعة التبخّر.
لعلّ هذه الملاحظة تدعونا جميعًا إلى التفكير: كيف يمكن أن نصوغ مستقبل عطلات أبنائنا بحيث تحمل من البهجة والعمق ما حملته إلينا؟ وكيف نوازن بين متطلّبات العصر الرقميّ، وحقّ الطفولة في الضحك، واللعب، والتفاعل الإنسانيّ الحقيقيّ؟
هي أسئلة أتركها مفتوحة مع نهاية صيف 2025، على أمل أن تحمل العطلات القادمة فسحات أرحب من المتعة والمعرفة لأطفالنا.