صدر كتاب "السلطويّة في التربية العربيّة" للدكتور يزيد السورطيّ، أستاذ التّربية في الجامعة الهاشميّة في الأردنّ، عام 2009 عن المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ضمن سلسلة "عالم المعرفة". وعلى الرّغم من مضيّ أكثر من عقدٍ من الزّمن على صدوره، فهو مرجع مهمّ لكلّ معلّم وتربويّ يسعى لتشخيص مشكلات التربية العربيّة، ومعالجتها.
يقع الكتاب في مقدّمة وسبعة فصول. يوضّح الكاتب في المقدّمة المقصود بمفهوم السلطويّة في التربية بأنّها المفاهيم والممارسات التربويّة القائمةُ على العنف، والقهر، ومصادرة الحرّيّة، والاستئثار بشأنٍ أو شؤونٍ ممّا يتعلّق بالبيئة التربويّة. كذلك، يظهر الكاتب التناقض الكبير بين ما تهدف التربية لإنتاجه من أفراد متوازنين واعين مبدعين فاعلين، وما تنتجه السلطويّة من أفراد سلبيّين متردّدين مضطربين محدودي الأفق والتفكير. وقد أشار الكاتب إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة لما لها من آثار عميقة تشمل أركان العمليّة التربويّة، وأفرادها جميعًا.
يتحدّث الفصل الأوّل عن مظاهر السلطويّة في العمليّة التعليميّة التعلّميّة، وهي تشمل طرائق التدريس القائمة على التلقين، والتذكّر والحفظ، والتعليم أحاديّ الاتّجاه والمصدر، الذي يهمل جانب الإقناع مُعليًا من شأن العقاب. يرى الكاتب أنّ هذه الطرائق تشيع بحكم عوامل كثيرة من مثل: اعتماد مصدر واحدٍ للتعلّم، وضعف الإدارة الصفّيّة، وتقليديّة المادّة وجمودها. وهي تشمل كذلك المناهج الدراسيّة التي تفتقد لتنويع مصادر التعلّم، التي تبتعد عن واقع الطلبة واهتماماتهم واحتياجاتهم، ولا تراعي فرديّة المتعلّم وخصوصيّته.
إلى جانب طرائق التدريس والمناهج يعرض الكاتب الممارسات التسلطيّة المتعلّقة بالتقويم متمثّلةً في تغليب طريقة تقويم واحدة هي الامتحانات، خاصّةً حين تفتقر إلى المرونة، والعمق في معالجة الموضوعات، وقياس مختلف مستويات المعرفة. ونفهم سلطويّة التقويم على هذه الحال حين يُتّخَذُ هذا المقياس غير الدقيق وغير المُنصِف دليلًا لتصنيف الطلبة، وإصدار الأحكام عليهم بناء على نتائجها.
ينتقل الكاتب في الفصل الثاني للحديث عن السلطويّة في الجانب الإداريّ، فينبّه إلى بعض مظاهر قد تعتري هذا الجانب، فتحرفه عن غايته التوجيهيّة التطويريّة. يبدأ الكاتب بجانب الإشراف التربويّ، ويرى أنّه متى ما افتقد للتشاوريّة والتواصليّة بين طرفي العلاقة، المشرف والمعلّم، فإنّه يخرج عن إطار المساعدة والتوعية والتحفيز إلى إطار التفتيش والاختبار وتصيّد الأخطاء. أمّا فيما يخصّ الإدارة التربويّة فقد تعاني من مظهر سلطويّ يعوق إنجاز المؤسّسات التربويّة بصورة كبيرة، ألا وهو المركزيّة المفرطة في كلّ شيء: في اتّخاذ القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ووضع المناهج، وتدريب المعلّمين، وإدارة شؤون الطلبة، الأمر الذي يفرز كادرًا تعليميًّا سلبيًّا مذعِنًا غير قادر بدوره على زرع قيم التشاركيّة والإيجابيّة، بل وقد يحمل معه عدوى السلطويّة إلى طلبته. أمّا حول الإدارة الصفّيّة، فيرى الكاتب أنّها تحوي اتّجاهين:
اتّجاه وقائيّ: يتّخذ كلّ إجراء يجنّب الصفّ الممارسات السلوكيّة غير المناسبة، فيقدّم تدريسًا فعّالًا، وبيئةً ملائمةً، مادّيّةً ومعنويّةً، ويتّفق مع الطلبة على قوانين واضحة، ويستكشف خصائص الطلبة مسبّقًا من خلال ملفّاتهم، ويبني باستمرار علاقات إيجابيّةً معهم، ويسعى لزرع الانضباط الذاتيّ لديهم.
واتّجاه علاجيّ سلطويّ: يقوم على ارتجاليّة إجراءات إدارة الصفّ وضبطه بناءً على ما يستجدّ من ممارسات خاطئة، بأساليب لها قليل حظٍّ من الأصول التربويّة، وهي أقرب في غالبها إلى الشّدة والعنف بهدف قمع تلك الممارسات، وتخويف الطلبة من عواقبها ومن تكرارها.
أمّا الفصل الثالث فيسلّط الضوء على مظاهر السلطويّة في ميادين التعليم العالي من جامعات ومعاهد حيث يفترض أن يقوم الأستاذ الجامعيّ بمهمّات التدريس، والبحث العلميّ، وخدمة المجتمع في جوّ من الحرّيّة الأكاديميّة الذي لا تعيش هذه الوظائف إلّا فيه. من الجوانب المهمّة في هذا الفصل المقارنة بين حال الحرّيّة الأكاديميّة في معاهد العلم في المجتمع العربيّ قديمًا؛ إذ قدّم التراث التعليميّ العربيّ أرقى صور الحرّيّة في التعلّم، والبحث، والمناقشة، والمناظرة، واختيار المنهاج والطريقة، وحالها اليوم، إذ تحيط بالعمل الأكاديميّ عوامل مُعيقة مثبّطة من قيود إداريّة ومنهجيّة تُفرض على المدرّس، ومن قيود ماديّة أو ماليّة تفرض تحكّمًا في سياسات الجامعة.
وفي الفصل الرابع يأخذ الكاتب قضيّة السلطويّة التربويّة إلى سياق اجتماعيّ، يدرس من خلاله تمثّلات السلطويّة في مشكلات من مثل الأمّيّة من جهة أنّها نتيجة لحرمان شريحة مواطنين واسعة من أساسيّات حقّ التعلّم والتطوّر والسعي نحو مستقبل أفضل، أو من مثل قضيّة التمييز التربويّ القائم على عدم تكافؤ فرص التعليم أو _إن صحّ التّعبير_ تكافؤ جودة التعليم؛ فنجد تباينًا في مستوى التعليم، ونوعيّته يفرض على المتعلّمين بناءً على التباينات الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والجغرافيّة، والجنسيّة لأفراد المجتمع.
وقد خصّص الكاتب الفصل الخامس لمظهر آخر من مظاهر السلطويّة التربويّة هو التسليع التربويّ، أي تحويل التعليم من كونه مهنةً ساميةً تتقدّمُ رسالتها وأهدافها النبيلة على أيّة اعتبارات أخرى إلى كونه سلعةً تخضع للعرض والطلب، فتغدو المعرفة عرضةً للبيعِ والتنافس والتسعير، ويُنحّى عنها _بداهةً_ من لا يملك ثمن هذه السلعة. ويشمل هذا التسليع الموادّ الدراسيّة، والمناهج التعليميّة وحتى الأبحاث العلميّة التي يفترض فيها أن تكون أنموذجًا للمصداقيّة والاستقلاليّة يحتذيه المتعلّمون.
بعد ذلك، يناقش الكاتب في الفصل السادس قضيّتين مهمّتين تفرضان على المتعلّم قسرًا: الانسحاب من الحاضر الذي يعيشه، ويريد تنمية مهاراته وتكييفها مع متطلّباته، إلى الماضي الغابر، ومن واقعٍ عمليّ له شروطه ومعطياته، إلى صورةٍ لفظيّة إنشائيّة تخلو من أيّ بُعدٍ إجرائيّ فعليّ. يسمّي الكاتب القضيّة الأولى الماضويّة، ويوضّح أنّ المقصود بها ليس الانجذاب إلى الماضي والاستئناس بتجاربه فقط، بل وانسياق الحاضر والمستقبل وراء شروط الماضي وإملاءاته، فنرى الأهداف التربويّة، والمناهج التعليميّة، وطرائق التدريس، وأساليب الإدارة، وأدوات التقويم قلّما تخضع لمراجعة دوريّة تستهدف التجديد والتطوير، وقراءة المستقبل في ضوء الحاضر، وتغيير ما يلزم من هذه التفاصيل بناءً على ذلك، بل تفرض على المتعلّم معارف ومهارات وأساليب لا تؤهّله للتفاعل والإنتاج والإبداع في واقعه ومحيطه. أمّا القضيّة الثانية فهي ما يسمّيه الكاتب اللفظيّة، وتعني تركيز العمليّة التعليميّة على البعد النظريّ الإنشائيّ، ونسيان البعد العمليّ التطبيقيّ، ويظهر ذلك في عناصر العمليّة كاملةً؛ فحين تمتلئ المناهج الدراسيّة بالمعلومات دون تطبيق أنشطة، وحين يقوم التعليم على أسلوب واحد هو التلقين، وحين يُقيَّم تعلّم الطالب بمقياس واحدٍ هو الاسترجاع، فإنّ ذلك كلّه يحصر التعليم في جانب لفظيّ غير فاعل.
تُختَتَم فصول الكتاب بسابِعها الذي يستعرض نتائج السلطويّة التربويّة بمظاهرها السالفة، وهي: إعادة إنتاج التسلّط، وإضعاف النظام التعليميّ، وتسهيل التغريب الثقافيّ، وإضعاف التنمية، وزيادة مستوى الاغتراب لدى المعلّمين والطلبة، وإعاقة الإبداع، والملل بما ينتجه من تحدٍّ وعدوانيّة أو انسحاب وسلبيّة. يلخّص المؤلّف مقترحات الحلّ بجعل التشاوريّة والديمقراطيّة ثقافةً عامّةً تبدأ ممارستها في البيت (المدرسة الأولى)، ثمّ في المدرسة على المستويات كلّها، وتغيير المفاهيم الخاطئة التي لم تزل شائعةً حول التعليم وأهدافه وأساليبه ومناهجه، وتبنّي خطّة تطوير شاملة دائمة تستفيد من الماضي وتفهم الحاضر وتستشرف المستقبل.
من وجهة نظري، تكمن قيمة هذا الكتاب في أنّه يدقّ ناقوس الخطر على كلّ مستويات سلّم التربية والتعليم من طلبة ومدرّسين وإداريّين ومشرفين، ويحذّرهم من عواقب هذه الممارسات التي لا تقف عند ركود المستوى التحصيليّ، ولعلّه أهونها وأيسرها، بل وتتعدّى ذلك إلى تخريج أفرادٍ يفتقدون أيّ حسّ فكريّ أو نقديّ أو إنتاجيّ أو حتّى انتمائيّ، أفرادٍ عاجزين عن إبداعِ جديد، أو تطوير موجود، أو معالجة مشكلة، أفراد ألفوا كونَهم مَقودِين لا حولَ لهم ولا قوّة، ولا يملكون فيما يدور في مجتمعاتهم وأوطانهم _وربّما في حياتهم أنفسهم_ من الأمر شيئًا، إذ لطالما سارت الأمور دونَ مشورتهم، أو علمهم، أو مشاركتهم، ولم يجرّبوا يومًا التأثير والمبادرة والنقد، وقد تفرز إلى جانبهم أفرادًا يعتنقون هذه الممارسات السلطويّة، ولا يعرفون بديلًا عنها، فيغرق المجتمع في دوّامة مستمرّة من التسلّط وإعادة صنعه وإنتاجه. وبهذا تفرز المؤسّسات التعليميّة أفرادًا لا ينقلون لمحطيهم إلّا فكرة الانسياق مع الواقع، وممارسة ما مُورِسَ عليهم من سلطويّة. لذلك، أرى أنّ تتبّع مظاهر السلطويّة وممارساتها يجب أن يكون التزامًا يُضاف إلى التزامات المؤسّسات التعليميّة؛ ففي نهاية الأمر، لا تعلّم مع إكراه، ولا تفاعُلَ مع خوف، ولا إبداع مع كَبت.







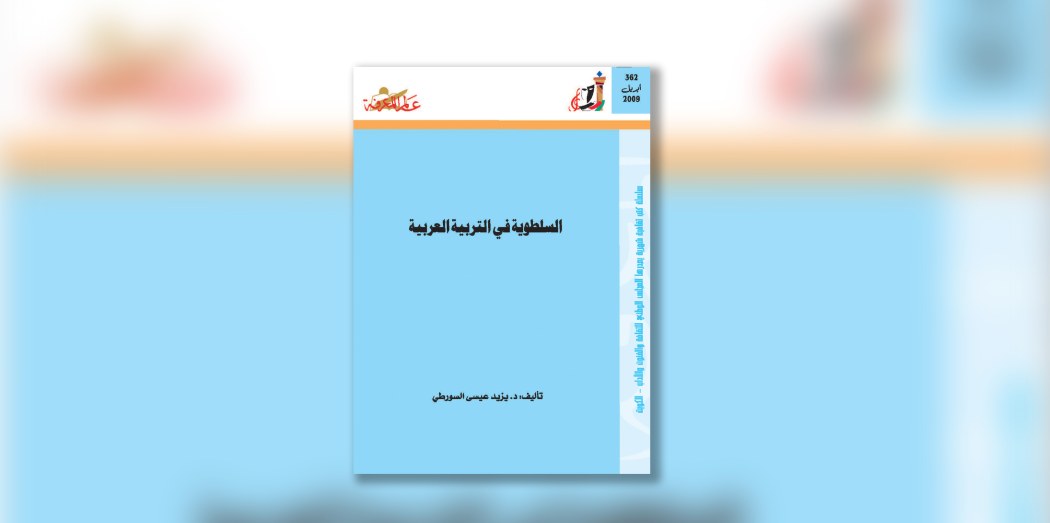


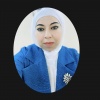


 نشر في عدد (6) خريف 2021
نشر في عدد (6) خريف 2021