الإنسان مخلوق حكّاء بطبيعته، وتلك الطبيعة تسير جنبًا إلى جنب مع تطوّر اللغة لديه. أعمل في مجال رياض الأطفال منذ خمس سنوات. أستعرض في هذه المقالة بداية اكتشافي فنّ الحكي، وكيف قادتني أسئلة الأطفال إلى رحلة تعلّم قطعتها من القاهرة إلى هولندا، ثمّ إلى القاهرة مرّة أخرى، لتجريب ما تعلّمته مع الأطفال، وكيف تغيرّت أدوات فنّ الحكي خلال الجائحة.
البداية... طفل يسأل "لماذا؟"
كنت أقصّ حكاية (الأسد والفأر) على مجموعة من الأطفال (3-5 سنوات) في (مختبر الحكايات). وفيها يتعلّم الأسد حين ينقذه فأر صغير أنّ القوّة ليست في الجسد فقط. بعد انتهاء الحكاية تقدّم نحوي طفل باندهاش، وسألني: "ما الذي حدث للأسد؟" في البداية، حاولت فهم سؤاله بغية أن أستوضح مقصده. قمت بإعادة سرد أحداث القصة مرّة أخرى، وفور أن انتهيت ظلّت في عينيه تلك النظرة التي توحي بعدم الاقتناع. عاود متسائلًا: "لماذا؟"، حاولت الإجابة عن سؤاله، وقد طلب سماع الحكاية مرّة تلو الأخرى. بدا لي الأمر غرائبيًّا! كان الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة يبحث في نفسه، وبنفسه عن إجابة مرضية لأسئلة أثارتها الحكاية في داخله؛ أسئلة يكتشفها كلانا لأوّل مرّة.
قرّرت عوضًا عن تكرار القصة شفاهة كما فعلت سابقًا، أن أقوم بإعادة سردها بطريقة لعب أدوار شخصيّات مختلفة في الحكاية، تارةً يلعب الطفل دور الأسد، بينما أقوم أنا بدور الفأر، ثم نعكس الأدوار. في كل مرة كنت أراقب ردّ فعل الطفل، وأودّ لو نصل إلى لحظة يهتف فيها قائلًا: "وجدتها!". لم أكن أعرف عمّا نبحث، غير أنّ تلك الحكاية التي كنت أظنّها عابرةً بحكم خبرتي في التدريس، فتحت بابًا سحريًّا. أمسك هذا الطفل يدي، ودلفنا سويًّا إليه.
قبل الجائحة، كنتُ أتبع أسلوب الحكي المباشر مع الأطفال وهم يجلسون أمامي في الصفّ. كنت أنظر إلى وجوه الأطفال المعبّرة كلّما تعمّقت في سرد الحكاية؛ ألتقط لحظةً بلحظة ردود فعلهم المنطوقة أو الجسديّة. بحدوث جائحة كورونا، أُغلقت الحضانة
الموروث ... كنز أم (دقة قديمة)؟
دفعتني لحظة الاستنارة تلك إلى فضول لمعرفة لماذا لم يكتف الطفل بما رويته بالفعل؟ لماذا أراد المزيد؟ وجدت نفسي أيضًا أودّ معرفة المزيد عن كلّ ما يتعلّق بعالم الحكايات. بينما أقرأ وأبحث، كنت أتحوّل إلى (تلميذة) خارج الصفّ الدراسيّ. اكتشفت عالمًا سحريًّا مليئًا بحكايات وروايات لا تنتهي، ومن كلّ أنحاء العالم؛ تحمل موروثات شعبيّةً وثقافيّةً عبر الزمن. لم أكن أقرأ الحكايات حسب، بل وأتّفق مع بعضها، وأختلف مع بعضها الآخر. استيقظت بداخلي عين ناقدة.
تتبّعت الحكي بصفتيه فنًّا وتاريخًا. الحكي لون من ألوان الفنون المسرحيّة؛ شخصيّة الحكّاء في الموروث المصريّ الشعبيّ تدعى (الحكواتيّ)، وقد اختفت تدريجيًّا من واقعنا المعاصر، وأصبحت تنتمي إلى ما يسمّى بالدارجة (دقّةً قديمةً). معظم الأطفال اليوم يستخدمون الهواتف الذكيّة لساعات طويلة، فلا متّسع لهذا الفن. تفتّق ذهني عن تساؤل: كيف يمكن إحياء هذا الإرث المنسيّ في عالمنا اليوم؟ وكان هذا السؤال دليل رحلتي التالية في التعلّم.
تلمذة احترافية
ذهبت إلى هولندا وبحثت عن المكان الساحر الذي يدعى "بيت مزراب الثقافيّ"، وهو مركز ثقافيّ يستضيف أمسيّات حكي كلّ مساء لجموع من الناس من جنسيّات وثقافات مختلفة. علمتُ أنّه ثمّة مدرسة خاصّة للحكي تابعة للمركز الثقافيّ. لم أتردّد لوهلة؛ قررتُ الالتحاق فورًا بالمدرسة، وبدأت أولى خطواتي الاحترافيّة في تعلّم (فنّ الحكي) بوصفه فنًّا أدائيًّا. قام بتدريبي الحكّاء المبدع الشهير Sahand Sahebdivani. تعلّمت مهارات مثل: بناء الحكاية، وأدوات الحكي مثل: الصوت وتطويعه لنقل المعنى، والصمت أيضًا. استطعت في فترة قصيرة بناء أوّل عرض حكي لي، وتقديمه في المركز الثقافيّ ذاته. استمرّ العرض نصف ساعة؛ شعرت بتفاعل الجمهور مع حكاياتي الشخصيّة التي كنت أقصّها كأنّي أقصّها على جمهور من غرباء. تعمّقت مهاراتي في الحكي بلا بهلوانيّة أو استعراض. عبّر لي كثيرون عن تأثّرهم بحكاياتي برغم اختلاف ثقافتنا وظروفنا الحياتيّة. وحكى لي بعضهم عن مشاعر مرّوا بها كانت مماثلة لتجربتي، فشعرت بالاتّصال والحميميّة مع من حسبتهم غرباءً.
العودة وخطة العمل
عدتُ إلى القاهرة واستكملت عملي في "مختبر الحكايات" بالحضانة. كان ذلك قبل الجائحة بشهور قليلة. طوّرت أدائي، ووضعت خطّةً أكثر تنظيمًا، من خلال المراحل الآتية:
مرحلة اختيار الحكاية
- ألتقط وأدوّن ملاحظات يوميّةً عن سلوكيّات الأطفال أثناء التعلّم واللعب.
- أقرأ الحكايات الكثيرة من كلا التراثين المصريّ والعالميّ. وأختار الحكاية معتمدةً على نظرتي لاحتياج الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة.
- أحرص ألّا أتعرض إلى أيّة معتقدات دينيّة أو فلسفيّة. أنتقي مواقف إنسانيّةً بسيطةً. بخبرتي التربويّة، أرى أنّه يجب أوّلًا بناء منظومة القيم الداخليّة للطفل بشكل يتيح له التعرّف على المعتقدات المختلفة كافّة بحكايات متنوّعة. في مرحلة لاحقة، يصبح قادرًا على تكوين معتقداته باختياره الحرّ بعد أن يكوّن اللبنات المؤسّسة لمنظومته الأخلاقيّة.
مرحلة بناء الحكاية
- بعد الانتهاء من اختيار الحكاية، أعيد كتابتها من جديد متّبعةً ما تعلّمته من مهارات جديدة، ودمجها بخبرتي في التعامل مع الأطفال يوميّا.
- أفكّك الحكاية إلى مشاهد بصريّة متسلسلة. في تلك المرحلة، أحرص على حذف مشاهد العنف مثل القتل، أو الضرب، أو أيّ انتهاك جسديّ أو معنويّ. أؤمن دائمًا أن العنف المعنويّ أو الجسديّ هو أصل المشكلة، لا حلّها. كما أتأكّد أيضًا من ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين حتّى في تلك السن المبكّرة من التكوّن.
- أستشعر بعمق كلّ شخصيّات الحكاية مع اختلافاتهم، أمنحهم صفات مميّزة، وأتحرّك من خلال حواسّي لأرسم ملامح شخصيّة كلّ دور في الحكاية.
مرحلة الحكي
- أحكي القصّة أمام مجموعة من الأطفال باستخدام مهاراتي الأدائيّة مثل: تغيير صوتي حسب الشخصيّة في أوقات، أو الصمت قليلًا في أوقات أخرى لجذب الانتباه. أهتمّ بإيصال الحكاية بالحواسّ لتتّصل وحواسّ الأطفال المختلفة.
- أراقب ردود فعل الأطفال أثناءَ الحكي. لاحظت استجابةً، وإقبالًا منهم أكبر بكثير من ذي قبل؛ وجدتها في تعبيرات وجوههم وصمتهم التامّ أثناء الحكاية، بل وحين أصمت في لحظات تستمرّ وجوههم متحفزّةً لمعرفة المزيد.
مرحلة ما بعد الحكي
بعد انتهاء الحكاية، نخصّص وقتًا ليخبرني كلّ طفل برأيه/ها. كانت ردود أفعالهم كالآتي:
- أطفال يخبرونني دون مواربة عن رأيهم في الحكاية: إعجابهم ببطل أو بطلة الحكاية، أو استيائهم من أحد الشخصيات، وفي بعض الأحيان خوفهم من شخصيّات بعينها.
- أطفال تأتي ردود فعلهم في صورة تقمّصهم للشخصيّة المؤثّرة في الحكاية، إذ يحملونها معهم وهم يلعبون مع أنفسهم، أو مع أقرانهم.
- أطفال يتفاعلون عن طريق الرسم، وثمّة من يظلّ صامتًا، وبعد مرور أيام يشاركني فجأةً بتعليق أو سؤال يخصّ الحكاية!
تعودت أن أتقبّل كلّ طفل بطريقته، وقدرته على التعبير عن نفسه. حظيت أيضًا بردود فعل من الأهل أنفسهم، حين يتساءلون عن شخصيّة بعينها لم يكفّ الطفل عن الحديث عنها في المنزل.
أثر الجائحة على الحكي
قبل الجائحة، كنتُ أتبع أسلوب الحكي المباشر مع الأطفال وهم يجلسون أمامي في الصفّ. كنت أنظر إلى وجوه الأطفال المعبّرة كلّما تعمّقت في سرد الحكاية؛ ألتقط لحظةً بلحظة ردود فعلهم المنطوقة أو الجسديّة. بحدوث جائحة كورونا، أُغلقت الحضانة، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم. سعيت لإبقاء التواصل مع الأطفال بطريقة جديدة، ألا وهي استخدام الفيديوهات المصوّرة. لم تختلف أيّة مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه، سوى في المرحلة النهائية، إذ كنت أحكي الحكاية وأنا أنظر لعدسة الكاميرا. قمت بتجميع الفيديوهات كافّة عبر قناة خاصّة بي على "يوتيوب" لتكون الحكايات متاحةً للجميع. شاركت الفيديوهات مع أهالي الأطفال من خلال صفحة العمل الرسميّة، ومن خلال صفحتي الخاصّة على "فيسبوك". لم يختلف اختياري لمحتوى الحكاية عن قبل الجائحة بل استمرّ على نفس القواعد التي وضعتها سابقًا، لأنّي أؤمن بها.
تجربة الحكي قبل الجائحة وبعدها لها مزاياها وعيوبها. الحكي المصوّر أتاح لي الفرصة لتقديم الحكاية في أحسن صورة ممكنة. أصبح لديّ الوقت الكافي للتحضير للحكاية والتمرّن عليها مرّات عدّة قبل تصويرها. بتّ أضيف عنصرًا آخر، وهو اختيار ملابس تعبر عن الجوّ العامّ للحكاية أو الشخصيّة الرئيسة. أتيحت لي الفرصة لإشراك الأهل في هذا التواصل الذي كان يحدث سابقًا يوميًّا بيني وبين أطفالهم في الصفّ الدراسيّ فقط. أصبح جمهور الحكاية هو الأطفال وذويهم. أيضًا تواصلت مع مجموعة عمريّة أكبر متمثّلة في إخوة تلاميذي وأصدقائهم. تمكّنت من الوصول عبر فيديوهات القصص إلى أطفال غادروا الحضانة، وبدؤوا الالتحاق بالمدرسة.
بالرغم من كلّ ذلك، كنت أفتقد أن أرى وجوه الأطفال فور سماعهم الحكاية. عبر الفيديوهات المصوّرة، لا أرى ولا أستشعر ردود فعل الأطفال اللّحظيّة كما هو الحال في الحكي المباشر. تأتيني ردود الأفعال في حال الحكي المصوّر من خلال أهالي الأطفال. نظرًا لطبيعة السنّ لصغيرة لطلابي، أتلقّى ردود فعل الطفل من خلال تعليقات الأهالي المكتوبة. من ناحية أخرى، تلقّيت صور أبنائهم وهم يسمعون الحكاية، بفيديوهات، ورسائل صوتية من الأطفال أنفسهم يعبّرون فيها عن رأيهم في الحكاية المقدّمة عبر الفيديو. قام بعض الأهالي باستكمال الحوار الذي تطرحه الحكاية، وتطويره مع أطفالهم.
يمكنني القول، بعد خوض تجربة الحكي الحيّ مع الأطفال، وتجربة الحكي المصوّر: إنّني أريد الاستمرار في الاثنين معًا. أفضّل الحكي المباشر أكثر من المصوّر، غير أنّي تعلّمت كثيرًا من تجربة القناة في "يوتيوب". الفيديو يتيح لي الفرصة للوصول، واستمرارية التواصل، والتواصل مع أشخاص أكثر باختلاف أعمارهم وأماكنهم حول العالم.
تأمّل في رحلة التعلّم
فنّ الحكي عندي هو تواصل إنسانيّ مجتمعيّ استشعرته في بداية الأمر بوصفي معلّمةً تحكي الحكايات في تعابير وجوه أطفالي وردود فعلهم، وأدركت عمق تأثيره حين وقفت على خشبة المسرح حكواتيّةً أشارك الجمهور حكاياتي الشخصيّة لأوّل مرّة. أرسم الآن خطًّا بين كلا المحطّتين، وأفهم نقطة الوصل بينهما أكثر، فنحن البشر –بكل اختلافاتنا– نحتاج أن نستمع بصدق للآخر، أن نتوقّف عن الكلام ونصغي لما سيرويه لنا شخص آخر، نسمح لأنفسنا بالذهاب في رحلة إلى عالمه من خلال الحكاية، وهناك في هذا العالم الموازي نتوحّد مع الشخصيّات؛ نرى ونسمع ونشعر ونعيش ما يعيشون. ومع نهاية الحكاية نرجع لأنفسنا، ومعنا بذرة الحكاية التي تطرح أسئلة بداخلنا قد لا نجد الكلمات الكافية للتعبير عنها، وتستمرّ رحلة البحث والتعلّم اللّانهائية بمرور الزمن، تستمرّ الحكاية.
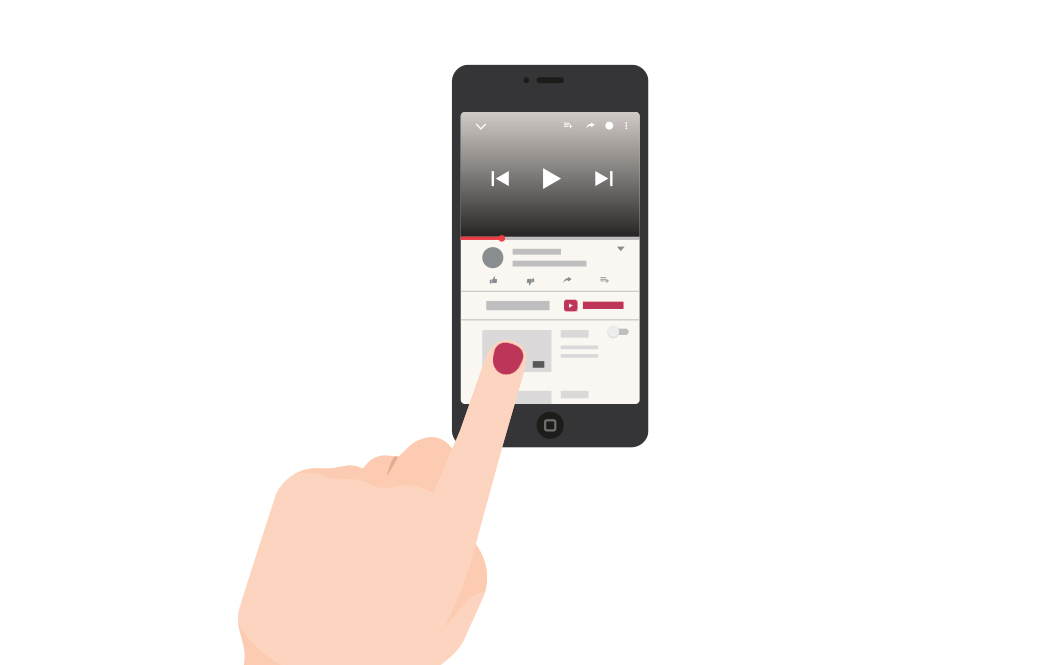













 نشر في عدد (1) خريف 2020
نشر في عدد (1) خريف 2020 

